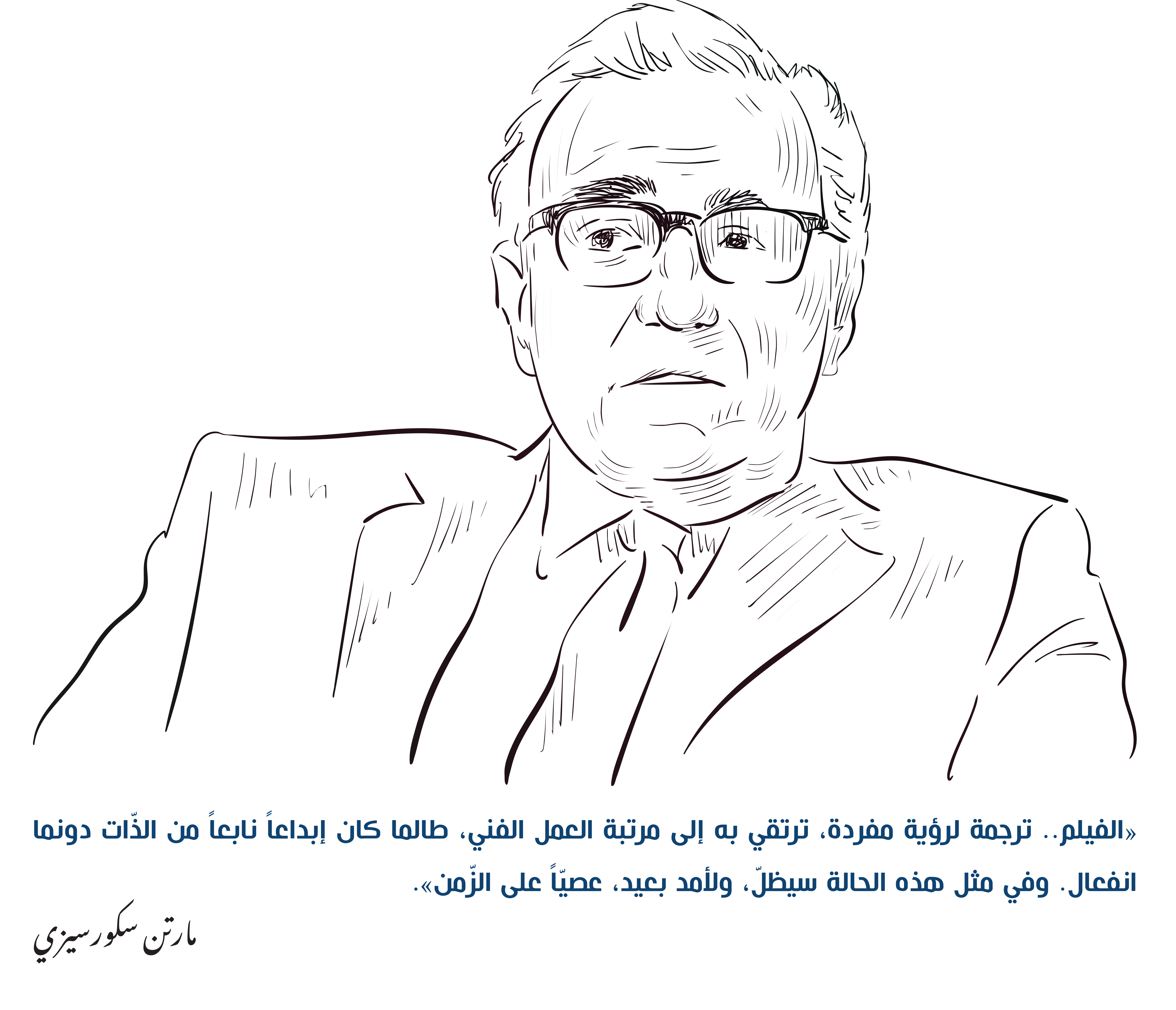

تتوالى أفلام مارتن سكورسيزي Martin Scorsese، فيتكشّف أمام ناظرينا المشهد النيويوركيّ في تفاصيله الأكثر خزياً وفضاضة. مبان شاهقة، ركام من الأموال الوسخة والمشبوهة، وشخصيّات أُلقي بها في قفص الأسود. متى شاهدنا تلك الأفلام، ألفينا أنفسنا منغمرين عنـوة في ذلك الواقع المرعب، وسط عنف رهيب تساهم المدينة العملاقة في تأجيجه، وحيث يغدو الإنسان وحيداً، وليس أمامه من خيار غير العثور على موطئ قدم.. أو الهلاك.
طلق ناريّ يتردّد صداه في شوارع نيويورك.. للحظة سوف يخيّل إليك أنّ العالم من حولك قد غدا على وشك التوقّف والتجمّد أمام الجثّة التي تداعت لتوّها، وتشظّى رأسها على الزّفت الصّلب للرّصيف. ولكن لا أحد توقّـف، بل إنّ الحشود ظلّت ماضيـة بإمعان كما كلّ يوم، بخطى متسارعة، آليّة ولامبالية. لقد خبرت هذه الحشود رائحة الموت والجريمة مراراً وتكراراً، وهي التي نشأت وكبرت هناك، لتتعوّد على مشهد الدّم المراق في الشّوارع وعلى الأرصفة، فلم يعد ليثير فيها ذلك أيّ تفجّع أو استغراب.
ومع ذلك.. كان ثمّة في مكان ما شخص استعر إحساسه أمام فظاعة المشهد؛ إنّه مارتن سكوسيزي، ذلك الذي قرّر ذات يوم استعادة القصّة بأكملها، قصّة توحّش الإنسان وبرودته المفجعة أمام الجريمة وأمام الموت، ليجسّد ذلك المشهد على الشّاشة، على نحو مرعب وصارخ، ويجعل منه أسّ أعمال سينمائيّة مربكة ورائعة في آن واحد.
العزلة المربكة لإنسان العصر الحديث

بينما كان ترافيس بيكل في شريط "سائق التّاكسي" يطوف بلا كلل في شـوارع نيويورك، حبيس عربة تاكسي تبدو وكأنّها تابوت متنقّــل، كان تيدّي دانيالس قد وجد نفسه من جديد محجوزاً في "شاتِّر آيلند"... في مشفى للأمراض العقليّة. فأيّـة فضاءات أفضل من تلك الأماكن المغلقة والموحشة التي تخيّرها سكورسيزي لتجسيد ذلك التّدحرج القاهــر في صقيع العـزلة لإنسان العصر الحديث؟ وفي شريط "زمن البراءة"، كانت الكونتيسّـة أولانْسكا -وهي تكابد دمعها- قد صرّحت لنيُو آيلنْد بصوت متقطّع: "إنّ العزلـة الحقيقيّـة، هي أن يعيش المرء وسط حشد غفير من النّـاس، فلا ينتظرون منه غير التّظاهر بفعل ما يكون هو بصدد فعله". وبالانغمار في مثـل ذلك الحشد من المُغفَلين، نرى شخصيّـات سكورسيزي فريسة للتشرّد والتّيه، كل واحد منها يمضي باحثاً عن ذلك الآخر الذي قد يؤنسه، ولا أحد يظفر بضالّته. ويمضي جميعهم، يحدوهم الوهم وأمــل مبهم في أن يكونوا قد وُفّقوا في إدراك ما كانوا ينشدون، مثل: "جـوردان بلفور في (ذئب وول ستريت)"، هذا الذي كان غنيّاً ذا سلطة وتأثير، ولكنّه كان يبدو منتبهاً للعزلـة والتوحّد، وهو الذي بلغ القمّة، وغدا دماغه متلفاً بالمخدّرات وقلبه متخماً بعشق الدّولارات.

وإذا كان المجد يجعل شخصيّات سكورسيزي فريسة للتوحّد؛ فإنّه كان يفقدهم خاصّة القدرة على الإبصار ويرديهم في حالة غثيان ليس لها من قرار. ففي شريط "الثّور الـهائج" كان جاك لا موتّا في ما سلف من الأيّام ملاكماً شهيراً متزوّجاً من امرأة عطوفة ومحبّة، قبل أن يجد نفسه مغلولا في خمّـارة رثّة بئيسة، لا يتوقّف فيها عن سرد طرائفه لتسلية الزّبائن. فكيف للمرء أن لا يغدو فريسة سائغة لتزدرده الجوارح بلا رحمة في بحر مائج.. محتشد بحيتان القرش؟ لقد كان البحث المضني لأولئك الضّالّين عن مكان آمــن للإرساء والتخفّف من ضراوة الرّعب مجسّداً في تيه سائق التّاكسي.. ترافيس، الذي كان شـــــارداً في الأضـواء اللّيليّــة لمدينة نيويورك بين ظلال عديمة الملامح.. لا سمــات تميّزهـا. إنّه أيضاً تيدِّي دانيلسْ في شريط "شاتّر آيلند" الذي كان يجري تحقيقـاً محموماً لا يرى له آخر، والذي بات موهوباً لعـزلة متفاقمة على وقع موسيقى معاصرة لمؤلّفـين من أمثال جيورجي ليجيتّي. هكذا.. وفي قلب العزلـــة تتناثر في أفلام سكورسيزي استعارات ذلك البحث اليائس عن المعنى، ولا شيء في الأفق غير العدم.
وتشكّل الجماعات بدورها "جزائر" متناثرة، متنافرة ومنعزلة داخل المجتمع. وفي مثل ذلك التّشرذم تحتلّ مسألة الهجرة مكانة مركزيّة في أغلب أعمال سكورسيزي، الذي عاش هو الآخر ظروف الهجرة القاسية بنيويورك، حيث نشأ وترعـرع بحيّ "ليتّل إيتالي"، حيث يحتشد المهاجرون الإيطاليّون، وتنتشر العصابات المتناحرة. ففي شريط "شـوارع وضيعة"، كان إيطاليّو أمريكا يتوزّعـون على شكل جماعـات لا روابط تصل بينها، كما كانت تتشكّل العصابات في شريط "عصابات نيويورك"، حيث كان الأمريكيّـون من الأصول الأنجلو ساكسونيّة يواجهون المهاجرين الإيرلنديّين. هكذا تبدو العزلة حاضرة بقوّة في كلّ مكان، عزلة يُدفع إليها الفرد بصورة قسريّة، حتّى وإن كان يعيش ضمن مجموعة من النّاس تصله بهم وشائج القربى.

وثمّة أمر آخر نلمسه بقدر كبير من الوضوح في أفلام سكورسيزي، وهو حالة التوتّر التي تنتهب الفرد، والقلق الباطني الذي كان يجعل المتوحّدين ينجذب بعضهم إلى البعض الآخر. فحتّى يدنو ترافيس من بِيسْتِي -الفتاة التي افتتن بها- برّر هذا الأخير قلقه قائلاً: "إنّك لتبدين شديدة التوحّد. أحياناً ما.. أمضي وأتأّمّلك وأتأمّل كلّ أولئك الذين يتحـرّكـون من حولك، كلّ تلك الهواتف والأشياء المبعثرة فوق مكتبك، فلا أشعر بغير الفراغ". وفيما كان يمعن في تسكّعه عبر شوارع نيويورك، صاح فجأة من داخل عربته: "لقد أمضيت حياتي ملاحَقاً بالعزلة؛ إنّها لعزلة قاهرة، لا تنفكّ عن مطاردتي في الخمّارات وفي السيّارت.. على الأرصفة وفي المغازات.. أنّى توجّهت وحيثما سعيت، ولا أرى لي أيّ مخرج في الأفق. حقّا.. إنّي لأشعر بأنّ اللّه قد تخلّى عنّي".
فكما تظلّ الصّدفَاتُ البحريّة لصيقة بصخورها رغم الأنواء والرّياح، تظلّ شخصيّات سكورسيزي غير قادرة على أن تجتثّ ذاتها من عزلتها ومن وجودها الانفراديّ. وضعيّة أوضحها بول فاليري حين قال: "إنّ الحركة الهائلة التي تهزّ المدن العظمى لتولّد قلقاً طاغياً وعجيباً؛ إنّه القلق من تكاثر المتوحّدين".
نيويورك.. البؤس تحت السِّلوفانْ

من الشارع الخامس إلى سوهو مروراً ببرُودْوايْ، ظلّ سكورسيزي يطوف عبر نيويورك ليرصد ملامحها في أدقّ تفاصيلها، ملامح كانت لا تني تتلوّن وتتغيّـر على مرّ الأيّام. فما كان يستوقفه ويثير فزعه هو جانب الإفراط والعملقة التي تميّز هندسة المدينة، مدينة تتطاول فيها المباني حدّ مناطحتها السّحاب، ويتضاءل فيها الكائن البشري ويتصاغر حدّ فقدانه لهويّته الإنسانيّة. ففي تلك الغابة الإسمنتيّة لا شيء يتملّك الإنسان غير إحساسه بالضّياع؛ وفي متاهات نسيجها الحضريّ الضّخــم الذي تأسـس على الدّماء، يتولّد لديه شعور بأنّه يقيم على أرضيّة متحرّكة.. تمضي على غير هدًى نحو المبهم المجهول.
ولكن؛ لنعد إلى ترافيس بيكل من جديد. فمن سيّارته كان هذا الأخير يرى عيّنات من حشود بشريّة شتّى هائمة في شوارع المدينة، فيصرخ قائلاً: "حيثما ألقيت ببصري، لا أرى سوى جموع من الكائنات الخرافيّة التي تكتسح المدينة ليلاً: عاهرات، شواذّ، مجانين، لوطيّــون، تجّار مخدّرات، محشّشون.. ولا شيء يستشعره المرء غير انتشار الرّذيلة والمال العفن". إنّها نيويورك التي يراها البعض في الظّاهر رمزاً للحلم الأمريكيّ، وهي في الحقيقة المدينة المدنّسة برذائلها وعيوبها المخفيّة.

كوباء يتعذّر اجتثاثه، أضحت تلك المدينة التي سمّاها ترافيس "البالوعة المنفتحة على الهواء الطّلق" تصيب بعدواها الأفراد حدّ الاختناق، وكان هــؤلاء قبل ذلك بمأمن من مخاط تفسّخها وانحلالها. لذا.. نرى ترافيس يتولّى بشكل لا إراديّ مهمّة تطهيرها من الفساد الذي بات ينخرها، وأعدّ لهذا الغـرض ترسانة من الأسلحة لتصفية شبكة من المجرمين. وفي مدينة الجريمة يغدو المضادّ للجريمة.. مجرِماً بدوره، طالما أنّه يطمح إلى تطبيق قانونه بقوّة السّلاح. فلا غرابة في أن يختتم شريط "عصابات نيويورك" بسـواد متدرّج، تتتابع فيه خمس لقطات ثابتة لنيويـورك من 1846 إلى اليوم، أي من زمنٍ كانت فيه نيويورك مدينة للمذابح، لا شيء فيها غير العنف والفوضى، إلى نيويورك الأبراج العملاقة التي تنتصب بكبريـاء كعلامات على الاستقواء والجبروت. وقد تأسّست المدينة بالفعل على تفشّي الأسلحة وعلى الفواجع، كما أشار إلى ذلك أمستردام، بطل الشّريط، الذي أكّد قائلاً: "كنّا جميعاً نِتاجَ سيلٍ من دماء ودموع. كذلك كانت مدينتنا العظمى".
وفضلاً عن ذلك؛ فإنّ الإنسان غدا داخل هذه المدينة سجين دوائـر جحيميّة تشكّل محرّك ذلك التكوّم العمراني الرّهيب والمتمدّد بلا انتهاء.. ففي شريط "عصابات نيويورك"، كانت جيّنّي تتأهّب لركوب سفينة للهروب من المدينة والالتجاء إلى السّاحل الغـربيّ، حين تلقّت فجأة لكمة أجهضت آمالها، وانتزعت منها حقيبتها بما حوته من مال، وكانت تلك الحقيبة تأشيرتها للرّحيل نحـو عالم أرحم. ففي ما يشبه القدر المحتوم، تبدو شخصيّات مارتن سكورسيزي، فريسة للفضاء الذي تكون قد أضحت عالقة بداخله، وكانت بالتّالي تعود قسراً إلى حيث كانت، أي إلى ذلك العالم الموصد والخانق.
هل من بارقة أمل في نهاية النّفق؟
قد نتساءل عمّا يمكن أن يشكّل ملاذاً لشخصيّات سكورسيزي، يجعلها تغالب الإحساس باليأس. فيتّضح أنّه لا ملاذ؛ إذ لا الدّين ولا الحبّ ولا العلاقات الأسريّـة، أي كلّ ما يتشبّث به الإنسان حين تتفــرّق به السّبل، يمكن أن تكون ملاذاً لتحقيق الخلاص. ولئن كانت سبل الخلاص حاضرة؛ فإنّها كانت تظـلّ دوماً متجاهلة ومجهضة.
ففي شريط "عصابات نيويورك" مثلاً، نلاحظ إقبال الإنسان على العبادة، ولكنّه كان مع ذلك لا يتوقّف أبداً عن السّرقة وعن القتـل. فثمّة حينئذ مفارقة تميّز سلوك مرتكبي الجرائم، الذين لا يحتكمون لأيّة ديانة أو شريعة. فأمستردام مثلاً، كان يتوسّـل إلى القدّيس سان ميشال حتّى يلهمه القدرة على الانتقام، ولكنّه لم يتردّد في تدنيس إنجيله والالقاء بـه في المياه الموحلة للنهر. وصورة الإله المترسّخة في أخلاق المجتمع الغربيّ، يتمّ استدعاؤها هنا أكثر لاعتبارات ثقافيّة.. لا لاعتبارات روحيّة تنمّ عن درجة عمق الإيمان.
ففي شريط "شوارع وضيعة"، كان فراش شارلي ينتصب تحت صليب مقدّس ضخم، وكان يخاطب نُصباً للمسيح داخل الكنيسة قائلاً: "حين أرتكب إثماً فإنّي أوثر محاسبة نفسي بنفسي، وأفضّل اختيار العقوبة التي أراها مناسبة لي".

شخصيّات سكورسيزي هي حينئذ شخصيّـات مسيحيّة بالوراثة، ولا تحفزها أيّة قناعة شخصيّة بتعاليم المسيحيّة. لذلك نراهـا لا تعوّل إلاّ على نفسها لإقرار نظام يؤمّن لها البقاء، وذلك باللّجوء إلى قانون القصاص، قانون العين بالعين والسنّ بالسنّ. ففي شريط "رأس الخوف"، نرى ماكس تيدّي، الخارج لتوّه من السّجن، يسعى إلى الثّـأر من محاميه سام باودن، ومعاقبته بوسائله الخاصّة؛ لأنّ هذا الأخير أخفق في الدّفاع عنه. وبوشمٍ قام بحفره على جلده يحمل هذه الكلمات "الانتقام لي"، تحـوّل جسد ماكسْ كادِي إلى ما يشبه لوحاً قانونيّاً، جعل منه كائناً متألّهاً يمسك بحقّ منح الحياة أو الموت لكلّ من يعترض سبيله. فلا يشكّل الدّين حينئذ العامل الذي قد تتشبّث به شخصيّات سكورسيزي كيما تخرج من زاوية الظلّ.
أمّا الحبّ.. فإنّه سرعان ما كان ينسرب كالرّمل من بين أصابع تلك الشّخصيّات. فلا يكاد أيّ شخص من شخوص سكورسيزي يلامس امرأة حتّى تتوارى وتختفـي. ففي شريط "سائق التّاكسي"، يصاحب ترافيس عشيقته بيتسي لمشاهدة فيلم بورنوغرافيّ؛ فإذا بها ترفض العيش معه وتهجره. وفي شريط "الثّور الهائج"، كان جاك لا موتّا حبيس أنانيّته، فخيّل إليه، وهو المصاب بداء الارتياب، أنّ امرأته فِيكِي تريد مفارقته. وفي "شوارع وضيعة" كان شارلي يصرّ على السّيـر على خطى عمٍّ مجرم، ولا يأبه البتّة بالحبّ الذي كانت تكنّه له تيريزا. وكذا الأمر بالنّسبة لشخصيّات أخرى، التي عادة ما تكون بوازِعٍ من الكِبْر والاستعلاء على المرأة، قد تعامت عن نساء محبّات وقويّات التقينهم، وكان بإمكانهنّ انتشالهم من وضعيّة التوحّد.
أمّا الأسرة، فهي التي تتولّى في غالب الأحيان مآخذة الشّخصيّات وفضح عيوبها. ففي شريط "زمن البراءة"، حين عادت الكونتيسّة أولينسكا إلى نيويورك بعد طلاقها من زوجها الذي كان لا يحترمها، أثار طلاقها منه فضيحة جعلت أهلها يتـبرّأون منها. وكان موضوع الخيانة موضوعاً أساسيّاً، أشبه باللاّزمة في أفلام سكورسيزي. ففي شـريط "شاتّر آيلند" كان تيدّي دانيالس يتوجّس من خيانة الدّكتور تشـاك أولْ لَهُ، فيما لم يتردّد جيمّي كُونوايْ في شريط "المعتوقـون" من خيانة عصابته للظّفر بمزيد من المال.
ويثبّت سكورسيزي شخصيّاتـه في مصير ملتـبس يتجاوزهم، فما من شخصيّة من تلك الشّخصيّات إلاّ وتبدو منذورة للوقوع لا محالة في عزلتها الأوّليّة، ولا ترياق لذلك الشّقاء.
وحين أدرك سكورسيزي ذروة المجد، عرف كيف يترك مسافــة بينه وبين منتقديه، وكيف يحافظ على موقف نقديّ يحفظه من الفساد الذي كان سيدنّس أعماله لو انغمر في المجتمع النّيويوركي. محاطاً بأصدقاء موثوقين من أمثـال روبير دين يرو وليوناردو دي كابريو، ممثّليْه الأثيريْن، ظلّ في مقــــاومته للقبح المستشري في المجتمع الأمريكي، وفيّاً لمبادئـه. وقد حظي في سعيه بدعم الفنّـانين الذين رافقوه لإبداع أعمال سينمائيّة محكمة ومتماسكة. ومع ذلك يظلّ هذا التّساؤل: هل من مخرج متاح لشخصيّاته كي تتعافى من إحساسها الحادّ والفاجع بالعزلة؟ لعلّنا نظفر ببعض الإجابة على هذا التّساؤل لو تأمّلنا ما جاء في رائعته الأخيرة .. شريط "صمت".
شريط "صمت" .. خلاصة مسيرة روحيّة

يقرّ سكورسيزي بأنّ شريطه الأخير "صمت" جاء ليكون خلاصة لمسيرته الرّوحيّة، لرحلته كمؤمن ما انفكّ منذ أيّام الشّباب يختبر إيمــانه. بهذا المعنى.. قد يبدو هذا الشّريط وكأنّه سلسلة اعترافات جاءت على شكل "سرد عام عن الذّات البشريّة وما تتعرّض له من ابتلاء ومن وقوع في الزّلل". لذا.. تعلّق السّرد هنا بالإيمان، الذي عرّفه المخرج في إحدى محادثاته أنّه "الأسلوب الذي وِفقه نحيا، ووفقه نعيش قِيَمنَا". لذا؛ فإنّ الفيلم لا يقتصر فحسب على المسألة الدّينيّـة، طالما أنّ الصّورة في هذا الشّريط تتيح لنا سنداً لغويّاً يجعلنا نفصح عن حاجتنا إلى الإيمان، الإيمان في مُثُلٍ وأفكار ما، في مبادئ وقيم محدّدة. وفي النّهاية فإنّ ما يتناوله هذا الشّريط هو مسألة العقيدة، بل جوهـر العقيدة، ولا شكّ في أنّ العقائد مذ وجدت، كانت قد ساهمت في بناء التّاريخ الإنسـانيّ. جاء شريط "صمت" حينئذ، ناقلاً لهذه الحقيقة الأساسيّة: لئن تعذّر علينا الكشف عن حقيقة كينونتنا، فإنّ شريط "صمت" جاء ليذكّرنا بأنّ الإنسان مؤمن بالسّليقة وأنّه لا يطيق الحياة بغير ذلك الإيمان الذي بدونه يغدو ذلك الإنسان موهوباً للتّيه، بلا علامات تهديه السّبيل.
وتومئ الاعترافات التي تخلّلت الشّريط، إلى أنّ الأمر يتعلّق بهجرة إلى اللّه محفوفة بالابتلاءات. إنّه سفر الأب اليسوعي سيباستياو رودريغيز ورفيقـــــه الأب فرنسيسكو غاروب إلى اليابان، من أجل العثور على مرشدهم كريسطوفاوو فرِّيرا الذي أشيع بأنّه تخلّى عن الكنيسة واندمج في المجتمع الياباني. ولكن؛ هل ترك الكنيسة في هذه الحالة يعني بالضّرورة التوقّـف عن الإيمان باللّه؟ ثمّ أليس لنا أن نتساءل: كيف لرجل كان على مثل تلك الدّرجة من التّقوى أن يفقد إيمانه؟
يحملنا ذلك السّفر إلى اليابان حيث تمّ بأمر من القاضي الأكبر تنظيم مذابح استهدفت التّنكيل بيابانيّين اعتنقوا المسيحيّة، وكانوا تحت أنظار الأب رودرغاز المعجبة والحــزينة، ممعنين في التشبّث بالحياة. ومن ثمّ فإن "الصّمت" يتجاوز في محتواه الفيلم التّاريخي، ولا يعرض فحسب لحرب دينيّة؛ إنّما هو اختبار حقيقيّ للإيمان، وسبر لأغوار الذّات لإدارك حقيقتـه. وكانت "تلك الجزيـرة المجهولة والمحفوفة بالمخاطر بالنّسبة لِبطليْنا بداية مواجهة بين عوالم وحضـارات مختلفة، وصدام بين ثقافات متباينة. وكأنّي بسكورسيزي أراد أن يهمس لنا في هذا الشّريط: "إن كان الآخر مختلفـاً عنِّي، فهو مع ذلك صورة منّي". وكأنّي به يتماهى في ذلك مع قولة لهيوم: "أرواح البشر مرايا، يعكس كلّ منها صورة الآخرين فينا؛ لأنّ كلاً منّا يعكس انفعالات الآخرين من حوله".
هكذا يغدو اليابان مرايا تعكس ذلك الإيمان باللّه، وابتلاء يسوعيّ وهو يواجه ذاته متفحّصاً مسألة الإيمان. استثمر سكورسيزي تلك الحقبة المتشنّجة ليبيّن مدى قـوّة القيم في حيـاة الإنسان، ولكن أيضاً صعوبة أن يضع ذلك هذا الأخير الإيمـان على محكّ السّؤال. فلئن كان الإيمان أمراً متيسّراً؛ فإنّ التّسائل يكون أكثر تعقيداً. ولكن؛ ألسنا بحاجة إلى الإيمان حتّى نفهم؟
هكذا غدا رودريغاز، الذي بلغ في تساؤله حدّ الإلحـاد، ذلك المؤمن الكفيف الذي لن يسترجع قدرته على الإبصار إلاّ حينما سيجرؤ على مغالبة نفسه، ولم يكن ذلك بالأمر اليسير. ويكون في هذه الحالة تجسيداً للإنسـان المكابر، ومؤمناً تعيساً. وخطيئة الكِبر هي في نظر سان أوغيستـان أسوأ الخطايا، وأصل للخطيئة الآدميّة، طالما أنّ الكِبْر يحمل الإنسان على أن يحلّ محلّ اللّه، بينما المؤمن هو ذلك الذي يعيش في اللّه، وليس ذلك الذي يعيش لنفسـه مثلما كان رودريغاز.
فكانت الرّحلة إلى اليابان حينئذ عبـارة عن نزول لرودريغازْ إلى الجحيم، جحيم النّفس، وهو منتهب بتناقضاته وارتياباته، وبانطوائه على ذاته، اتّضح أنّه لم يكن ليؤمــــن حقيقة باللّه؛ لأنّه كان مغروراً مثبّتاً في نفسه ومتقوقعاً على ذاته، كان خطَّاءً ويجهل أنّه كذلك، ولكنّه سيحظى رغم ذلك بالخلاص.
وفي هذا الإطار تكتسي البوذيّة كلّ معناها؛ فكما يشير هيغـل إلى ذلك بوجاهة، فإنّ هذه الدّيانة تنشد "العدم، الذي يجعل منه البوذيّون مبدأ كلّ شيء، الهدف النّهائيّ الأسمى، والنّهاية الخاتمة لكلّ الأشياء". فبالنّظر إلى أنّه ابتعد عن اللّه، ولم يعد ليؤمن بغير ذاته، غدا رودريغاز ضالاّ ومنذوراً لوجع مقيم. ومِثلَ القرويّين الذين من حوله، لم يعد ليؤمن باللّه؛ وإنّمـا بعالم الصّور الذي يحيط به، لتغدو محبّة اللّه عنده هي محبّة الذّات.
بالبوذيّة.. كان بإمكانه التخلّص من أناه وممّا تنطوي عليه من كبر، ليزداد معرفة بنفسه وقدرة على بناء ذاته من جديد والإيمان باللّه. فكريستوفوو فيرّارا عرفَ هو الآخـر ويلات السّجن والتّعذيب الجسدي، ولم يكن حبسه سوى ترجمة عمليّة لابتـلاء روحيّ ووجوديّ. متحرّراً من اسمه، سوف يعمد إلى دراسة علم الفلك، هذا العلم المنفتح على الكـون، والذي يتداعى أمامه العالم المغلق للمسيحيّة، طالما أنّه لم يفارق إيمانه باللّه. فكما رودرغاز تماماً، يكون المروق عن الدّين وبشكل مفارق، بداية لإيمان خالص وأصيل. وإذا كانت كلّ الدّيانات مختلفـة، فنحن جميعاً بالضّرورة مؤمنون. قد تتباين أساليب تفكيرنا وقد تتضارب، ولكنّنا جميعاً بحاجة إلى معتقد ما. وقد نتفكّر في ذلك المعتقد، ولكن دون أن نأخذ بمبادئه بشكل أعمى. فمتى وضعنا كلّ أساسات حياتنا على محكّ السّؤال، فلسوف تخرج المبادئ من تلك المراجعة، إمّا مدمّرة أو معزّزة.
يبيّن سكورسيزي حينئذ أنّ الإيمـان هو أن نكون قادرين على الانفتاح على الآخر، وأن لا نظلّ مثبّتين في المبادئ، سواء كانت تلك المبادئ دينيّة أم لا. فنحن منذورون لا محالة للإيمان، وكما كتب نيتشـه ذلك في "العلم الجذل"، "إنّ الإحساس بالفتور الدّينيّ (باعتباره المبدأ المنظّم للقيم) مجرّد وهم، والتحـرّر المزعوم الذي يقودنا إلى حالة الخواء الوجودي، ينبغي أن يدفعنا إلى إعادة خلق المقدّس. فلا مناص لنا من الإيمان.. وليس ذلك امتداحاً للإيمان الذي نتعلّق به؛ لأنّه لا قِبَلَ لنا بالتملّص منه، وإنّما للمؤمن وأسلوبـه في ممارســـة إيمانه. أن نؤمن.. فتلك فعاليّة روحيّة لا مجـرّد اتّباع مذهبيّ، لذا ينبغي أن يكون ذلك الإيمان تأمّليّاً وإلاّ يصبح ضارّاً. إنّه دعوة إلى الانفتاح الرّوحيّ لمقاومة كلّ مسلّماتنا وأفكارنا القبليّة المحدِّدة لأعمالنا اليوميّة. لقد قدّم لنا هذا المخرج القدير تأمّلاً مثيراً مدعوماً بصورة بليغـة رائعة، ولقطات أيقونيّة دون الوقوع في التّضخيم والمزايدة. وجاءت الموسيقى المصاحبة.. مشرقة ومتّسقة مع ذلك السّفر الباطني، حيث يدفع الصّمت نحو تلك العودة العسيرة إلى الذّات.
بمثل هذا الخطاب الكونيّ، تنبعث من هذا العمل قـوّة مدهشة وآسرة، تجسّد سطوة الإيمان الكامنة في طبيعتنا البشريّة، القادرة على الأخْيَر أو الأسوء، ما لم تكن باعثة على الشكّ.
لا معتقد أفضل من معتقد آخر، والحقيقة الكونيّة هي أنّ قيمة الإيمـان جبلّة مستكنّة فينا. ورغم مرجعيّته الكاثوليكيّة، لم يشر المخرج إلى ما ينبغي أن نؤمن به؛ وإنّما إلى الطّريقة التي ينبغي أن نعتمدها في بحثنا عن مكامن الإيمان فينا. فأن نؤمن.. فإنّ ذلك يعني أن نتوفّـق في ذلك البحث الباطني المضني، وأن نحقّق تلك العودة إلى الذّات ونحن نسائل مبادئنا؛ كي ننفتح على العالم ونعيش بسلام.

خِتاماً؛ من المتعارف أنّ مارتن سكورسيزي Martin Scorsese أراد أيّام المراهقة الانخراط في حياة الرّهبنة، ولكنّه سرعان ما أدرك عدم أهليّتـه للمضيّ في تلك الطريق. ولئن تشبّع بمعيّـة والديه بقيم المذهب الكاثوليكي؛ فإنّنـا نلمس في جميع أعماله علاقته المتشنّجة بالإيمان. ويظلّ شريط "صمت" الذي يحتلّ فيه الدّين قلب اهتماماته، علامة على مسيرة سينمائيّة مترعة بالمشاعر الرّوحانيّة.