قد ينفلت النَّص الروائي، عندما يُكتب، من إسار كاتبه، لينطبع في مخيلة القارئ ووجدانه، وروحه بصور مختلفة وبتصورات مفارقة لما هدف إليه الكاتب، وبذلك يصبح النص حمّال دلالات، وموغلًا في الكثافة الدلالية والتعبيرية، فيغدو النص نصين: نص كُتِب، ونص يُقرأ، ومن ثمّة نجد أنفسنا إزاء إبداعين: إبداع الكتابة وإبداع القراءة، وهذه الثنائية لا تتوفّر إلا إذا كان مجال الإبداع الكتابي طافحًا بالدهشة ومثيرًا لأخيلة الروح، فما الإبداع الروائيّ في نهاية الأمر إلا سعي حثيث إلى تحريك خوامد الفكر وإثارة لمياه الوجدان الراكدة.
ومن هنا، تتأتّى مقولة "لذة النص" - حسب رأيي-، فهي في مفهومها العميق ذاك التفاعل الذهني والشعوري والروحي بين نص روائي مكتوب بحرفيّة وإتقان، وقارئ يُجيد الإنصات إلى الأصوات المنفلتة من تخوم الأسطر والكلمات وتهويماتها.
هذه الأفكار وغيرها راودتني، وأنا أقرأ رواية "قصر الصنوبر" للمبدعة الجزائرية إلهام بورابة، فلماذا؟!
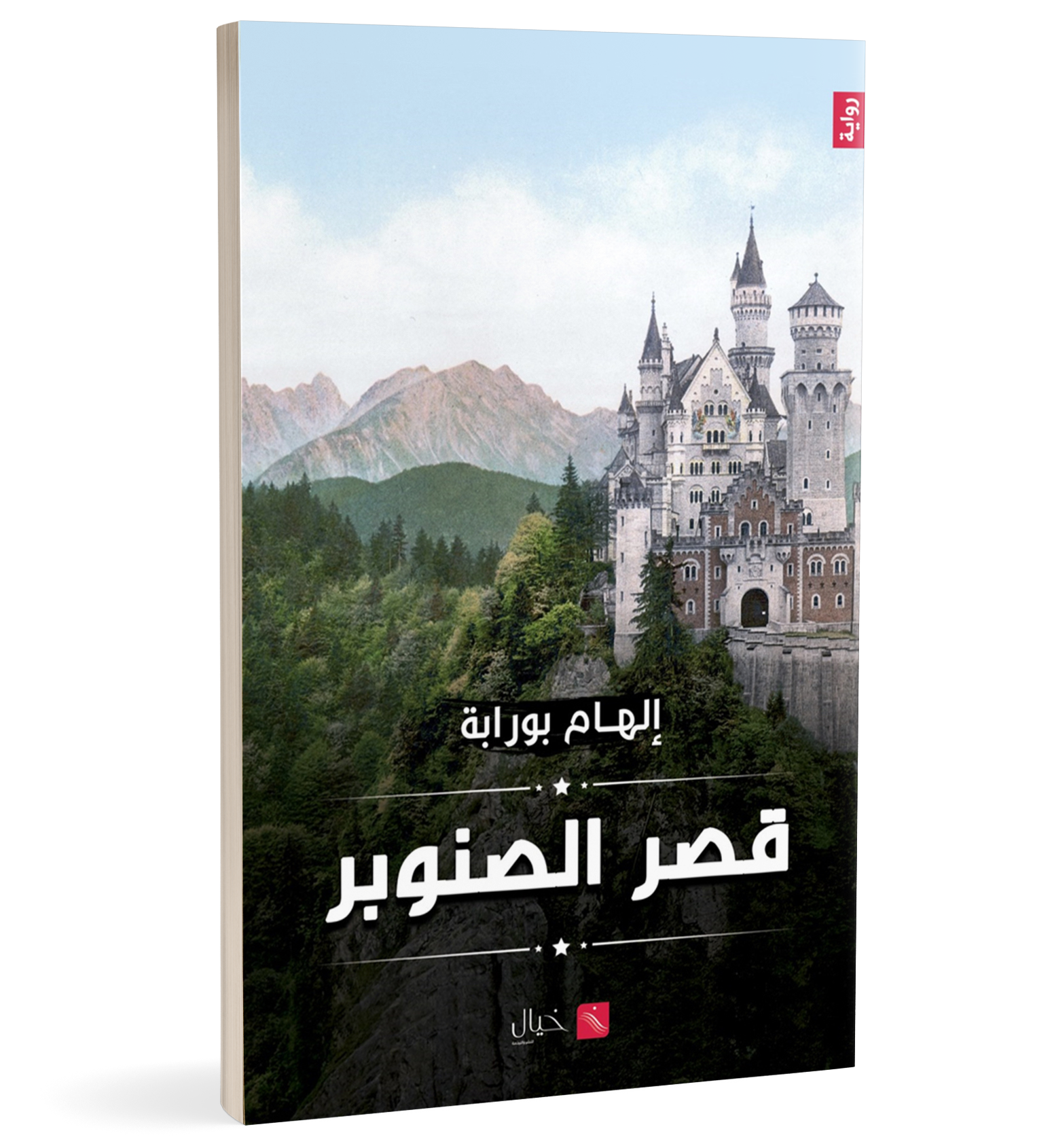
◄ عن الرواية
صدرت رواية "قصر الصنوبر" عن دار خيال للنشر والترجمة سنة 2020، وهي تحتوي على (113) صفحة، وتدور أحداثها في الجزائر، وبؤرة حبكتها السردية "قصر الصنوبر" وهو مأوى للأيتام، أو بالأحرى لليتيمات اللاتي فقدن أسرهن في "عام النار".
وعام النار في التاريخ الحديث للجزائر، هو التسمية الشعبية لمرحلة من مراحل حرب التحرير، وهو عام 1955 "حيث كان رد فعل الاحتلال على اندلاع الثورة التحريرية عنيفًا، وظف فيه سلاح الطيران، فكانت صواريخ نارية أتت بحرائق أبادت قرى ومداشر1، بهدف القضاء على معاقل الثوار"2.
وقد أدت هذه الحرب الضروس إلى إبادة شبه شاملة لقرى عديدة، فتم إيواء مجموعة من البنات في الميتم، وبذلك تم قطعهنّ عن جذورهنّ، ثم بدأت الفتيات يخرجن من الميتم، عند نيل الاستقلال. منهن من هاجرت، ومنهن من كفلتهن عائلات مرموقة ومنهن من تزوجت.
◄ أسئلة الجذور.. وإشكالية التصنيف
وهنا تأتي الباحثة الراوية "نور" لترمّم صدوع الشتات وتقيم جدران الانتماء، وذلك عبر بحث نفسي اجتماعي. فالرواية إذن؛ بحث عن أصول الفتيات وجذورهن أو هو -في وجه من وجوهه- بحث عن الحقيقة. هو ليس، فقط، بحث عن هوية الفتيات وأنسابهن؛ وإنما هو بحث حائر عن هوية مجتمع بأسره. وهذا المجتمع ليس المجتمع الجزائري فقط، بل هو المجتمع العربي بأسره؛ إذ لا يخفى أن المجتمعات العربية اشتركت في العديد من الكوارث والمصائب، وجمع بينها مصير واحد سطّر خطوطه العريضة الاحتلال، بدءًا من الاحتلال التركي إلى الاحتلال الغربي، فـ(عيشة، وفاطمة، وفلّة، وحلّومة، وحدّة، ومينة) لا يمثلن شخصيات الرواية فقط؛ وإنما هنَّ الوجه الآخر لماضٍ مطموس وشخوص تتراقص في ضباب العتمة ووحل التاريخ المشوّه.
هنّ ضحايا لعبث تاريخي لا يرحم، بدأ منذ سقوط الأندلس وانهيار قلاعها بيد القشتاليين ومحاكم التفتيش وتهجير المسلمين، وتخفّي اليهود تحت أسماء إسلامية للفرار من جحيم التفتيش، فاختلط الحابل بالنابل والتاريخ بالجغرافيا، ثم جاء الاحتلال التركي فعبث بالأنساب، ثم جاء الاحتلال الفرنسي فأوغل في هدم المهدّم، واختتم مسيرة قرون من العبودية والإذلال وتشويه الهوية وتضييع الأصول.
ومن هنا، نلاحظ استنادًا كبيرًا على التاريخ في نسج بعض خيوط الرواية. فهل هي رواية تاريخية؟!
يعرّف الدكتور محمد القاضي الرواية التاريخية فيقول: هي "نص تخيّليّ نُسِج حول وقائع وشخصيات تاريخية"3.
أما سعيد يقطين فيقول: "هي عمل سردي يرمي إلى إعادة بناء حقبة من الماضي بطريقة تخيليّة، حيث تتداخل شخصيات تاريخية مع شخصيات متخيّلة"4.
السرد التاريخي يقدم الحقيقة ويسرد الأحداث المطابقة للواقع، بينما الرواية التاريخية أقرب إلى التخيل والإبداع. ويرى (جورج لوكاتش) أنها: "رواية تثير الحاضر، يعيشها المعاصرون بوصفها تاريخهم السابق"5.
الرواية التاريخية إذن؛ عمل أدبي فني مادته التاريخ يوظف فيها الروائي رؤيته وتجاربه لتحقيق غاية يسعى إليها.
ويتجاذب الرواية التاريخية هاجسان: الأمانة التاريخية بمعنى موافقتها للمصادر التاريخية من نهوض وسقوط الدول والحروب والحوادث والوقائع، والهاجس الثاني هو ربطها بمكوّنات الفن الروائي وحاجاته الجمالية، وبذلك تقبع الرواية التاريخية في مكان وسطيّ بين التاريخ والأدب اللذان يشتركان في الخطاب السردي.
ووفق هذه المفاهيم يعسر تصنيف رواية "قصر الصنوبر" ضمن الرواية التاريخية؛ لأنها لم تنطلق من أحداث تاريخية، ولم تعتمد على نسيج سردي يتشابك مع وقائع التاريخ مثلما فعل جورجي زيدان مثلًا في رواياته، إلهام بورابة لم تسعَ إلى حمل الماضي إلى الحاضر؛ لتعرّف بحقبة تاريخية معينة وفق رؤية إيديولوجية أو سياسية؛ وإنما هي وظَّفت حقبًا تاريخية معينة لتعليل الحاضر وتفسيره وتحليله وهذا وجه من وجوه الرواية، فالاحتلال الذي حل بالجزائر طيلة قرون أنشأ تحولات عميقة وهيكلية في المجتمع الجزائري وفي بناه الثقافية، فالرواية تعليل لصورة الواقع الحاضر بمرآة الماضي من ناحية وإدانة واضحة للتاريخ، بل تذهب الكاتبة إلى أبعد من ذلك لتحاكم التاريخ، أو قل لتقرأه قراءة جديدة، أو ربما هي تسعى بطريقة ما إلى تصحيحها.
◄ الكتابة والرؤية
كأني بإلهام بورابة تريد أن تكتب تاريخ الجزائر وفق رؤيتها الذاتية، تريد أن تقول ما لم يقله التاريخ، فالأَخَوَان خير الدين وعرّوج ليسا عظيمين، وإنما هما تاجرا عبيد وسبايا وما جلبوا في سفنهم إلى الجزائر إلا أراذل الأتراك وصعاليكهم، والاحتلال الفرنسي، الذي يدّعي جلب التحضّر والتقدّم، زرع في أرض الجزائر معمِّرين قذرين استقدمهم من مختلف أصقاع أوروبا.
بل إن خير الدين وعرّوج عملا كثيرًا على "تهريب اليهود (من الأندلس) إلى المغرب على أنهم عرب مسلمون أفلتوا من محاكم التفتيش"6.
والاحتلال التركي ليس نعمة، بل هو نقمة لا يختلف كثيرًا عن الاستعمار الفرنسي، وتستغرب الراوية اعتبارهم أصحاب فضل على الجزائر. تتجلى محاكمة التاريخ خاصة في فظاعات الاستعمار الفرنسي الذي أباد قرى بأسرها، وخلف اليتم في كل مكان حل به واستغل الأهالي في حروبه المتواصلة عبر التجنيد الإجباري، وتستشهد الراوية بجدها "الذي أبحر متّجهاً إلى فرنسا ثم إلى مفترق أراضي الحرب. جرّتهم فرنسا إلى كل ميدان تحط فيه، لبنان وسوريا والفيتنام والمغرب، منتهيًا بالعودة مع انتهاء الحرب"، وقد أخبر جدّتها "أنه لمـَّا قُلعت الجزمة من قدميه انسلخ اللحم معها"7.
وتكتب الراوية تاريخًا آخر عبر التصور والتخيل والافتراض بناء على ثوابت تاريخية معينة، مثل التجنيد الإجباري والجيش الإفريقي الذي استغلته فرنسا في حروبها، فتحول وجهة التاريخ ليقول ما لم يقله، وهل يبتعد التاريخ كثيرًا في معظمه عن التصوّر والتخيل؟!
تقول: "أفترض أن طيلة رحلة النفي كانت القوات الفرنسية تتلطف بهم وتهتم بغذائهم وباكتئابهم وأنهم وصلوا بأمان إلى كاليدونيا، وأن بعض الأهالي هناك قد استقبلوهم بكثير من الإخاء، وكل الأراضي التي كانت تتهيّأ لامتصاص نخاعهم"8.
ومن هنا، نستنتج أن الراوية تعتبر تاريخ الجزائر سيرة عبودية لا تنتهي، من العبودية التركية إلى العبودية الفرنسية إلى عبودية الإرهاب.
تتجلى هذه العبودية في أشكال فظيعة ابتدأت باحتلال المكان والزمان، وغرست بذور الاستغلال الجنسي والانتهاك الجسدي والنفسي والطبقية البغيضة، فأثمرت مظاهر سلبية عديدة امتدت في المجتمع الجزائري كالسرطان، ولعل أفظع شجرة شيطانية غرسها الاستعمار الفرنسي هو تشويه الحياة والثقافة والمعتقدات.
ويبدو هذا التشويه واضحًا في ضياع الأنساب وشرود الألقاب. تقول الراوية: "الأتراك كما يقرؤهم التاريخ الشرقي كلاب عاثوا في الأنساب قبل المعمّرين، أيام راجت خدمة بنات العائلات الفلاحية في سرايا العائلات التركية"9، وقد أدت هذه الظاهرة إلى كثرة اليتيمات اللاتي آوتهن كبريات العائلات التركية، وأطلق عليهن اسم "بنات الحسنى"، وتتجلى هنا مفارقة قتل القتيل والذهاب في جنازته! وهنا أيضًا تطفح مآسي الجدود والأصول التي تاهت في أوحال العبث الاستعماري القائم بالأساس على اكتساح الهوية واختراقها، وبذلك تتطرق الراوية إلى قضية الانتماء، فتنقد ما ساد المجتمع الجزائري من تشوّهات فظيعة خلفها تاريخ العبودية. ومن أبرزها: التمييز الطبقي وغرس أخلاق العبيد في النفوس، واستبطان الذل واتخاذه منهج حياة، الخضوع والخنوع اللذان يبرزان خاصة في تفشي الزوايا والتعلق بالخرافات والغيبيات الواهية.
تقول الراوية متحدثة عن جدتها: "وما زلت أذكر حرصها أن تكون الزاوية مربط كل أمر مهم في العائلة تبرّكًا بالولي وبقريبها العالم من بني حبيب"10، وقد سعى الاستعمار من خلال زرع الزوايا إلى تأصيل السذاجة الفكرية والجهل؛ ليتمكّن من امتصاص المكان والزمان. بل قد يبدو الأمر أشد فظاعة وقبحًا، عندما يتصل بالعقائد والشعائر الدينية، فهذا "الدرويش الهادي" القائم على زاوية الولي الصالح سيدي عبد الرحمان كان "ببّاسًا" في دير مسيحي أي راهبًا مسيحيًّا! وهذا إمام مسجد الحي يقوم بتركيب البيض المزركش للاحتفال بالمولد النبوي الشريف وهي عادة مسيحية. وهذا الجار الصائغي المتزوج من يهودية يمارس أبناؤه عادات يهودية فينسبها إلى الديانة الإسلامية. وما هذا التداخل العجيب في نظر الراوية إلا نتيجة واضحة لتداخل الأنساب وضياعها، فغدا الدين مجرد قشور ومظاهر جوفاء تزيد المجتمع غربة عن هويته الأصيلة، ومن هنا ترتبط الرواية بالبعد الاجتماعي والديني والثقافي، وتجعل التاريخ بوابة كبيرة دخل منها ما لا يحصى من الشرور الاجتماعية، إنه بوابة للفقر والخوف واليتم. بل إن اليتم هو التاريخ الحقيقي للجزائر وربما لكل الإنسانية التائهة في خنادق العبث والتوحش، فـ"كلنا أيتام في الواقع"11؛ لأننا منزوعون عن إنسانيتنا، ومقذوفون دون هوادة في منافي الفساد و(الديستوبيا). نحن إذن نعيش قشور الحضارة وظاهرها المغشوش والمزيف. ألسنا أيتامًا إذن؟! تاريخنا هو تاريخ اليتم والزيف والوباء.
◄ الغاية.. واللغة
ولكل ذلك، تعتبر رواية "قصر الصنوبر" عملًا فنيًّا يسعى إلى تبصير الإنسان العربي بحقيقته، إنها مرآة كبيرة نرى فيها وجوهنا الماضية لنعرف ملامح وجوهنا الحاضرة. وهي في وجه من وجوهها تصحيح لوجودنا يُطرح في شكل روائي متعدد الطبقات السردية، وهي بذلك تدفع القارئ إلى إعادة كتابتها فتفرض ما يسمى "القراءة التفاعلية"، وهي من أبرز تيمات لذة النص. يقول (رولان بارت): "يجب أن يثبت النص الذي تكتبه لي أنه يريدني"، ويقول أيضًا: "القراءة تجعل المكتوب بدايات لا تنتهي، إنها تكوّر المكتوب على نفسه، فهو لا يزال بها يدور حتى لكأنّ كل نهاية فيه تظل بداية"12.
وما يثير الانتباه في رواية "قصر الصنوبر" حقًّا اللغة السردية المعتمدة؛ إذ تبدو شديدة التلبّس باللغة الشعرية، ويبدو ذلك واضحًا من خلال الكثير من الشذرات التي تجعل اللغة مجنحة تحلق في عوالم المجاز والرمز. فالكاتبة تطعّم السرد المستقيم بدوران الشعر، فإذا بها تنقل القارئ من عالم إلى آخر ومن مجال إلى مجال، وهي بذلك تؤكد مقولة التصنيف الأجناسي، وتطلق العنان للغتها دون تحكيم كهنة اللغة ومحنطيها، فتجعل من شذراتها الشعرية لمعًا تتلألأ في فضاء السردي، وكأنها نجوم تخطف الأبصار والقلوب في آن. وهذه الشذرات عديدة، منها: "تفاجئني غربة الألوان فأزرع بدل عيني عتمة"13، "لا تبعد إلا مسافة ساعة وبعض القلق"14. "مفتوحًا على هلع وهي منتوفة الهدوء تعوي". "فأمسكي يا عيون السماء، فعينا فاطمة طوفان يغرق الروايات التي لم أرها بعد"15.
◄ نهاية المطاف
نستنتج أن رواية "قصر الصنوبر" رواية مكثفة، تُروى فيها الأحداث على ألسنة راويات متعددات، وهن اليتيمات عبر السرد والحوار، فهي رواية الألسن المتعددة والقلب الواحد، ذاك القلب الذي يتألم وهو مسكون بهاجس الهوية المفقودة في خفايا التاريخ. ذلك القلب المفكر الذي كشف تاريخ الوهم المليء بالقتل والاغتصاب والاستغلال المتوحش. وضمير الغائب "هن" في الرواية يكشف تاريخ المرأة الغائب وضياع النسب وتيه الانتماء، وتسعى الرواية جاهدة إلى ترميم الغياب والشتات، وذلك بإقامة جدران لتاريخ حقيقي ولبيت متين وصلب يصفّي الذاكرة من شوائبها لإرساء ذاكرة مستقبلية جديدة.
الرواية أيضًا إدانة للتاريخ اللقيط الذي لا اسم له ولا لقب له مثل يتيمات "قصر الصنوبر". هو التاريخ الذي أضاع الهويات وجعل الواقع الحاضر مسخًا وزيفًا ووهمًا.
وربما بحكم اختصاص الكاتبة العلمي وهو علم النفس، قامت الرواية في جزء كبير منها على تحليل الفصام الاجتماعي الذي لا تعيشه الجزائر فقط، بل كامل الوطن العربي، ففككت الحاضر على ضوء الماضي. لكن هذه القتامة التي سرت في كامل الرواية يتم كسرها في نهايتها فيشرق الأمل في المستقبل عبر رقصة البجعة الروسية التي تغلق أبواب الأسئلة الحائرة التي تتعلق بما صمت عنه التاريخ وتفتح بابًا للرقص يمحو الشوائب ويرمِّم بعضًا من تشوّهات الذات الجماعية. فتعود النضارة لـ"الروفاك" وتعود للسنابل صفرتها اللامعة. ولا شك أن الأراضي المشوهة والمحترقة سيكون إنتاجها من السنابل في المستقبل عميمًا.
هوامش: (1) دشرة (والجمع: مداشر): لفظ جزائري يعني قرية أو قبيلة، هي في المقام الأول مجموعة المساكن الثابتة أو المتنقلة أو المؤقتة أو الدائمة، تجمع بين الأفراد المرتبطين بصلات قرابة معينة.┇(2) قصر الصنوبر، ص: 113.┇(3) محمد القاضي: الرواية والتاريخ، دراسات في تخييل المرجعي. تونس، دار المعرفة للنشر والطباعة والتوزيع. ط1، سنة 2008، ص: 145.┇(4) سعيد يقطين: الرواية التاريخية وقضايا النوع الأدبي. مجلة نزوى، العدد الرابع والأربعون.┇(5) جورج لوكاتش: الرواية التاريخية، ترجمة جواد كاظم، بغداد، دار المعرفة للنشر والطباعة، ط1، 2008، ص: 50.┇(6) قصر الصنوبر، ص: 34.┇(7) المصدر السابق، ص: 36.┇(8) المصدر السابق، ص: 36.┇(9) المصدر السابق، ص: 27، 28.┇(10) المصدر السابق، ص: 32.┇(11) المصدر السابق، ص: 15.┇(12) رولان بارت، لذة النص، ترجمة منذر العياشي، 2015.┇(13) قصر الصنوبر، ص: 17.┇(14) المصدر السابق، ص: 42.┇(15) المصدر السابق، ص: 60.