تمهيد في الفلسفة والقلق
ما الذي يتبدّل حين تنطفئ السبورة القديمة، ويُستبدل صرير الطباشير بضوء الشاشة؟ هل نكون أمام تطوّرٍ طبيعي في مسار التعليم، أم أمام منعطف أنطولوجي يبدّل معنى التعلم ذاته؟ الجامعة ليست مؤسسة تعليمية فحسب، بل هي في جوهرها ضمير المجتمع وفكرته عن نفسه. وحين تدخل الجامعة المغربية اليوم زمن الرقمنة، عبر مشروع طموح لإنتاج الدروس الرقمية وتعميمها؛ فإنها لا تُدخل مجرد تقنية إلى حرمها، بل تُدخل رؤية للعالم، ونسقًا جديدًا للعلاقة بين الإنسان والمعرفة.

إن التحول الرقمي ليس "برنامجًا إداريًا"، ولا "تجهيزًا تقنيًا"، بل هو سؤال وجودي:
هل يمكن للمعرفة أن تظلّ تجربةً إنسانية حيّة حين تتحوّل إلى بيانات مضغوطة، وأيقونات تفاعلية، وشاشات زجاجية باردة؟ وهل يستطيع الأستاذ أن يحافظ على دفء الفكرة حين يتوسّط الضوء بينه وبين تلميذه؟
إن هذا المشروع، بكل ما فيه من وعود وإغراءات، يضع الجامعة أمام مسؤولية كبرى: استعادة المعنى في زمن التقنية. ذلك أن الرقمنة، إذا لم تكن مؤطرة بفلسفة تربوية وإنسانية، تتحول إلى قفص ذهبي: يلمع، لكنه يخنق الروح.
من الورق إلى الضوء – التحول بوصفه امتحانًا للوعي
لقد مرّ التعليم الجامعي عبر التاريخ بثلاث ثورات كبرى:
الأولى كانت مع الكتابة حين وُلد النصّ؛ والثانية مع الطباعة حين صار العلم سلعة قابلة للتداول؛ والثالثة اليوم مع الرقمنة، حيث لم تعد المعرفة تُستنسخ فحسب، بل تُنتج وتُستهلك في آنٍ واحد. إن مشروع رقمنة الدروس الجامعية، كما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي المغربية، ليس انتقالًا من الوسيط الورقي إلى الرقمي فقط، بل هو انتقال من زمن إلى زمن، ومن طريقة إدراك إلى أخرى. فالجامعة، كما تُبنى اليوم، مطالبة بأن تُعيد النظر في مفاهيمها الأساسية: الأستاذ لم يعد مصدر المعلومة، والطالب لم يعد مجرد متلقٍّ، والمعلومة لم تعد نهائية، بل أصبحت كائنًا متحوّلًا يعيش ويتكاثر في الفضاء الرقمي.
لكن ما يخشاه المفكرون التربويون هو أن تتحول الرقمنة من وسيلةٍ للتحرّر إلى آليةٍ للضبط. إذ حين تتحكم المنصات في آليات التعلم والتقييم، وحين يصبح كل نشاط معرفي قابلًا للقياس والتحليل والخوارزميات، يُخشى أن يُختزل الفكر في "بيانات"، وأن تفقد العملية التعليمية بعدها الإنساني والوجداني.
إن السؤال الحقيقي إذن ليس: كيف نرقمن؟ بل: كيف نُبقي الإنسان في قلب الرقمنة؟
الرقمنة كرهان أنطولوجي – بين التقنية والفكر
كل تحوّل تقني يحمل في جوهره مأزقاً فلسفياً. فالتقنية كما يرى مارتن هايدغر، ليست مجرد أداة، بل هي "طريقة في الكشف"؛ أي أسلوب في رؤية العالم. وحين تُصبح الرقمنة هي الوسيط الأوحد بين الإنسان والمعرفة؛ فإنها تُعيد تعريف كل ما نعرفه عن الزمن، والحضور، والمعنى. فالمحاضرة، التي كانت لقاءً وجوديًا بين عقلين، صارت حدثاً افتراضياً. والسؤال، الذي كان يولد من لحظة التفاعل، صار تعليقاً مكتوبًا في نافذة دردشة.
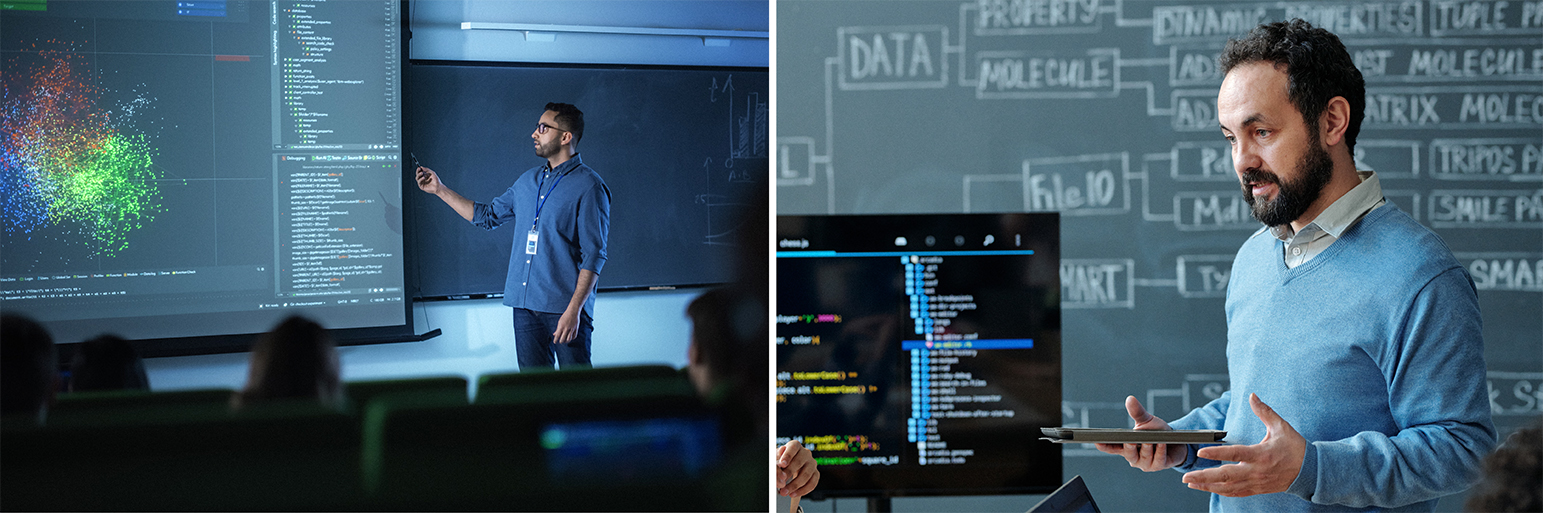
لكن في المقابل، فتحت الرقمنة آفاقًا لم يكن لخيال الجامعة أن يتصورها: جعلت المعرفة متاحة لكلّ أحد، في كل وقت؛ كسرت احتكار المكان، ودمقرطت التعلم. وهنا يتبدّى وجهها الآخر: الرقمنة ليست خصمًا للفكر، بل اختبارًا له. إذْ يمكنها أن توسّع الحقول المعرفية، وأن تجعل الجامعة فضاءً عالميًا مفتوحًا، حيث يلتقي طالب من فاس بزميل من طوكيو في درسٍ واحد.
ولكن لكي يحدث ذلك، يجب أن نُعيد ترتيب العلاقة بين الفكر والتقنية. فليست الرقمنة هي التي تُنير العقل، بل العقل هو الذي يُعطيها المعنى. إنها أشبه بالمجهر: تكبّر ما تراه، لكنها لا تخلق الرؤية.
الجامعة المغربية.. بين البنية الرقمية والرؤية الغائبة
لا شك أن المبادرة الأخيرة لوزارة التعليم العالي، بإطلاق النسخة الثانية من مشروع رقمنة الدروس الجامعية، تمثل خطوة واعدة نحو تحديث الفعل البيداغوجي. إذْ تهدف إلى رقمنة وحدات معرفية مشتركة، وتعميم الموارد الرقمية، وتيسير الولوج إلى التعلم الذاتي، عبر منصة وطنية موحدة.
لكن السؤال الأعمق يظل قائماً: هل نملك فلسفة تربوية تُؤطّر هذا التحول؟ وهل الجامعة المغربية مستعدة لأن تُغيّر تصورها لذاتها، لا أدواتها فقط؟ فالتحول الرقمي الحقيقي لا يبدأ من تجهيز الأستوديوهات، بل من إعادة صياغة الوعي الأكاديمي. إنه يحتاج إلى تكوين الأستاذ في البيداغوجيا الرقمية، وتحرير الطالب من ذهنية التلقين، وبناء محتوى يعكس الهوية الثقافية المغربية في زمن المعرفة الكونية. وبدون هذه الرؤية، ستظل الرقمنة تجميلًا فوق البنية القديمة، أشبه بطلاءٍ جديد على جدران قديمة متشققة.
التعليم كفعل تحرّر لا كوظيفة
من أخطر ما يواجه الجامعة في زمن الرقمنة هو تحوّل التعليم إلى خدمة، والمعرفة إلى "منتوج". إذْ حين يُختزل الأستاذ في صانع محتوى، والطالب في مستهلك، تنفصل العملية التعليمية عن معناها الأخلاقي والفلسفي. فالجامعة، في جوهرها، ليست سوقاً، بل فضاء للحرية. والتعليم ليس تزويداً بالمعرفة، بل تأسيسًا للوعي النقدي.
إن التكنولوجيا يمكن أن تكون حليفًا لهذا المشروع التحرّري، إن هي استُخدمت في تحرير الطالب من الحدود الزمنية والمكانية، ومنحت الأستاذ أدوات جديدة لتوسيع الخيال. لكنها يمكن أيضاً أن تكون أداة للضبط والمراقبة، إذا صارت مقاييس النجاح فيها رقمية صرفة.
الرهان إذن ليس على الرقمنة ذاتها، بل على الوعي الذي يُحسن توجيهها.
نحو فلسفة مغربية للرقمنة الجامعية
تحتاج الجامعة المغربية إلى أن تؤسس فلسفة وطنية للرقمنة التعليمية، لا مجرد خطة تقنية. فلسفة تعترف أن الرقمنة ليست بديلاً عن الإنسان، بل استمرار له. وأن التعليم الرقمي لا يُلغي الوجدان، بل يعيد صياغة حضوره.
هذه الفلسفة يجب أن ترتكز على ثلاثة مبادئ كبرى، الإنسان في المركز: كل سياسة رقمية يجب أن تنطلق من سؤال: ماذا ستضيف للطالب والأستاذ؟ كيف ستُحسّن جودة الفهم؟
المعرفة كحقّ عمومي، يجب أن تكون الموارد الرقمية مفتوحة ومجانية، لأنها تمثل ثروة رمزية للأمة. والهوية والانفتاح يؤشران على أن الرقمنة لا يجب أن تُذيب الخصوصية الثقافية، بل أن تُمكّنها من الحضور في الفضاء العالمي بلغتها وأفكارها.
من النظرية إلى المثال – تجارب جامعية ملهمة
ليست الجامعات الكبرى في العالم قد وصلت إلى ما هي عليه صدفة. بل لأنها جعلت من الرقمنة مشروعًا فكريًا وإنسانيًا قبل أن يكون تقنيًا.
1. جامعة هلسنكي (فنلندا):
تبنّت نموذجًا يقوم على "التعلم عبر البحث"؛ حيث تُنتج الدروس الرقمية من طرف الأساتذة والطلبة معًا، في بيئة تعاونية. وأطلقت الجامعة منصة “MOOC Helsinki”، التي أتاحت للطلاب من كل أنحاء العالم متابعة مقررات مفتوحة في الذكاء الاصطناعي واللغات. لكن الأهم من ذلك أنها لم تفصل بين الإنسان والتقنية؛ بل اعتبرت أن الرقمنة وسيلة لترسيخ قيم المشاركة والتفكير النقدي.
2. جامعة سنغافورة الوطنية:
طورت نموذج "التعلم المدمج الذكي"، حيث يُدمج التعليم الحضوري بالرقمي في نظام متكامل، تُقيَّم فيه الكفايات بالاعتماد على مشاريع واقعية. كما أنشأت الجامعة بيئة رقمية تفاعلية تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي والمحاكاة لتطوير مهارات الطلبة، مع الحفاظ على مركزية العلاقة بين الأستاذ والمجتمع.
3. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT):
حين أطلق مشروع “MIT OpenCourseWare” في مطلع الألفية، لم يكن هدفه سوى واحد: دمقرطة المعرفة. فتح المعهد أبوابه الرقمية أمام الجميع، واضعًا كل مقرراته ومحاضراته مجانًا على الإنترنت، مؤمنًا أن العلم لا يُزهر إلا حين يُتقاسَم. وكانت تلك الخطوة ثورة أخلاقية بقدر ما كانت تكنولوجية؛ لأنها جعلت الجامعة منارةً عالمية لا بجدرانها، بل بانفتاحها.
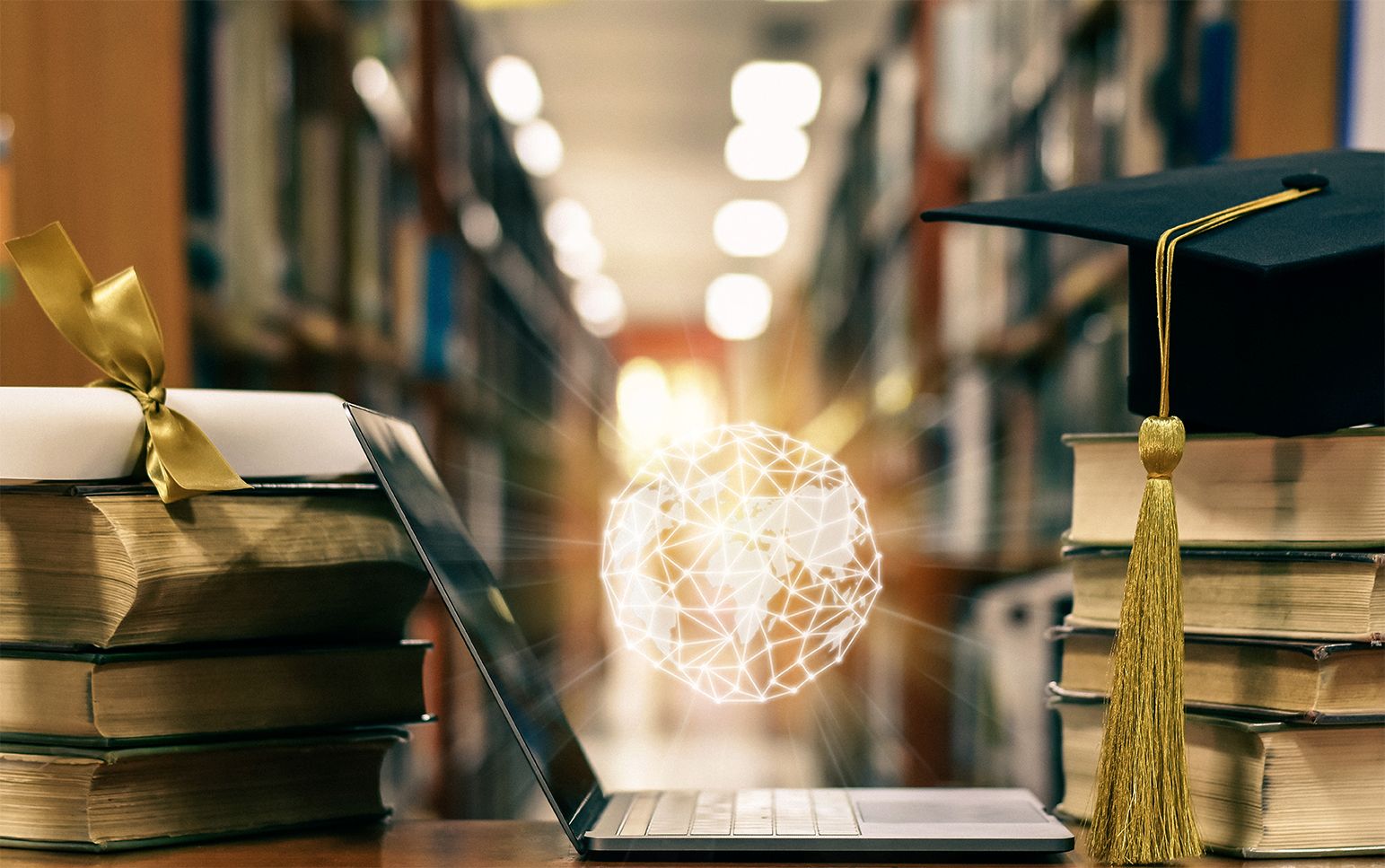
خاتمة: الجامعة كضمير المستقبل
إن مشروع رقمنة التعليم الجامعي في المغرب لا يجب أن يُفهم كسياسة آنية، بل كرهان حضاري طويل المدى. فحين تُقرّر أمة أن تُدخل التكنولوجيا إلى عمق مؤسساتها التربوية، فهي لا تُصلح وسيلة، بل تُعيد تعريف علاقتها بالمعرفة وبالإنسان.
الرقمنة، في جوهرها، مرآة لعقل الأمة، فإن كان عقلها منفتحًا، حرًا، ناقدًا، تحوّلت الرقمنة إلى طاقة نورٍ ومعنى. وإن كان منغلقًا، بيروقراطيًا، تقليديًا، تحوّلت الرقمنة إلى ديكورٍ يُلمّع القديم ولا يُغيّره. لهذا، على الجامعة المغربية أن تُدرك أن مستقبلها لا يُقاس بعدد الأستوديوهات الرقمية، بل بقدرتها على صناعة فكرٍ حرٍّ ومسؤول، يربط التقنية بالقيمة، والابتكار بالوعي، والمعرفة بالعدالة.
وحين يحدث ذلك، حين تكتشف الجامعة أن الرقمنة ليست شاشةً مضيئة، بل نافذة على الإنسان. وحين تكتشف أن النور الحقيقي ليس في المصابيح، بل في العقول، عندها فقط يمكننا القول: لقد خلعت الجامعة طباشيرها، ودخلت حقًا زمن الضوء الذي يفكر.