لقد شكلت الحرية إحدى أهم القضايا الفلسفية التي استأثرت باهتمام الفلاسفة منذ سقراط إلى اليوم، ويعود ذلك إلى كونها محدداً رئيساً للكائن الإنساني الذي لا يمكن أن يحقق مختلف غاياته من دون يقينه التام بكونه حراً.
الحرية إذن حسب محمد بهاوي، هي المدخل الرئيس لبناء مجتمع حداثي وديمقراطي؛ مجتمع يتجه فيه الأفراد نحو تحقيق وجودهم على نحو يتخلص فيه كل واحد منهم من مكبوتات الماضي، التي يعد تجاهلها أو محاولة نسيانها أصل الداء الذي ينخر كل مجتمع.
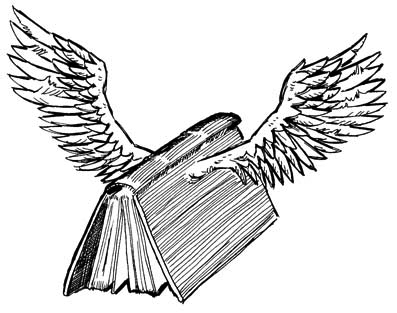
معاني الحرية: أندري لالاند André Lalande
يرى لالاند أن الحرية تفيد في معناها الأولي: حالة إنسان ليس عبداً أو مقيداً؛ وهي كذلك أن يقوم شخص بما يشاء، وليس بما يريده شخص آخر؛ إنها غياب الإكراه الخارجي. انطلاقاً من هذا التصور تفرع معنى الكلمة إلى ثلاثة مناحي مختلفة:
- بالمماثلة والتعميم، إذ تقال الحرية على موجودات أخرى غير الإنسان، إلى درجة أنها تقال على موجودات جامدة.
- من الناحية السياسية والاجتماعية، حيث تميز وضعاً محدداً للمواطن في علاقته مع المجتمع والدولة.
- تطلق للدلالة على الاستقلال الداخلي للإنسان، عندما يقال بأن الإنسان تسيِّره قوى ومبادئ غريبة عنه، تجبره على منوال سيد مستبد، أو تغريه على شاكلة مخادع أناني؛ كما تقال أيضاً على اللاحتمية، في الوقت الذي تكون فيه الأداة الوحيدة لاستبعاد كل ما لا يندرج ضمن فعل الفرد.
أما في معناها العام: فهي حالة الكائن الذي لا يخضع لأي إكراه، والذي يتصرف طبقاً لإرادته وطبيعته. ومن الناحية السياسية والاجتماعية، تدل كلمتا "حر" و"حرية" على غياب إكراه اجتماعي ملزم للفرد. وتبعاً لذلك فإن الفرد يكون حراً في فعل كل ما لا يمنعه القانون، وحراً في رفض القيام بكل ما لا يدعوه إلى فعله. إن تبادل الأفكار والقناعات يمثلان أهم الحقوق المخولة للإنسان؛ إذ من حق كل مواطن أن يتكلم ويكتب وينشر بحرية، شريطة عدم تجاوز هذه الحرية في الحالات التي يحددها القانون.
وأما من الناحية النفسية والأخلاقية فهي: حالة الإنسان الذي يتصرف عن وعي وتعقل وهو يعرف ذلك جيداً؛ والفرد الذي يعرف ماذا يريد، ولماذا، والذي لا يتصرف بطيش أو رعونة. وتقال أيضاً في مقابل الانفعال والغرائز الحيوانية والجهل والدوافع العابرة؛ فالحرية، هنا، هي: حالة الكائن الإنساني الذي يظهر طبيعته الخاصة في أفعاله وسلوكاته، من حيث كونها طبيعة متسمة بالعقل الأخلاقي. وبذلك تصبح كلمة الحرية لفظاً معيارياً، على ضوئها يمكن للطبيعة الإنسانية أن تتحكم.

الحرية والاستعباد: جان جاك روسو
إن القول بأن فرداً ما يهب نفسه دون مقابل، هو ضرب من الهذيان واللامعقول، فمثل هذا الفعل غير مشروع ومرفوض، بحجة أن من يقوم به يفتقد إلى الحس السليم. وإذا قيل الأمر نفسه عن شعب بكامله، فإن هذا يفترض أنه شعب مجنون؛ والحال أن الجنون لم يكن يوماً أساساً للحق.
وإذا كان كل واحد قادراً على التنازل عن نفسه، فإنه لا يستطيع التنازل عن أبنائه، ما داموا يولدون أناساً أحراراً، وحريتهم ملك لهم، وليس لأحد سواهم حق التصرف فيها. فقبل أن يصلوا إلى سن الرشد، فبإمكان الأمن أن يعين شروطاً باسمهم من شأنها أن تحفظهم وتضمن سعادتهم، ولكن دون أن يهبهم نهائياً ودون شرط؛ لأن هبة من هذا النوع تتعارض مع غايات الطبيعة وتتجاوز حقوق الأبوة. من الواجب إذن، كي يكون حكماً شرعياً أن يكون للشعب في كل جيل كامل السيادة في قبوله أو رفضه؛ وحينئذ لن يكون هذا الحكم اعتباطياً.
وهكذا، فإن تخلي الفرد عن حريته هو تخل عن صفته كإنسان، وعن حقوقه الإنسانية، وأيضاً عن واجباتها. وليس هناك تعويض ممكن للتخلي عن كل شيء؛ ذلك أن تخلياً مثل هذا يتناقض مع طبيعة الإنسان، فسحب الأخلاقية من كل أفعاله، إنما هو سحب للحرية من إرادته.

الحرية والحتمية: عبد الله العروي
يرى العروي أن البحث في مشكلة الحرية يتجدد عبر العقود ليس فقط لأسباب اجتماعية (الحريات الليبرالية)، أو فلسفية (نظرية الحرية)؛ بل لسبب آخر مهم يهم الإنسانية ككل في آن واحد، وهو أن العلم الحديث في تقدم مستمر يغزو ميادين جديدة. ويرتكز العلم الحديث على مبدأ الحتمية، أي على نقيض الحرية كما يتصورها الرجل العادي. كلما تقدم العلم في ميدان يتعلق بالعمل البشري وبالمبادرة الفردية، تخوف الإنسان من أن تعطي الاكتشافات الجديدة للبعض وسائل التحكم في إرادة البعض الآخر.
لقد اعتبر المفكرون في بداية العصر الحديث أن العالم وسيلة لتحرير الإنسان من قيود الطبيعة؛ لكن التجربة أظهرت في هذا القرن أن العلم قد يخدم الحرية، كما قد يحاصرها ويقضي عليها، والملاحظ حسب العروي أن أغلب علماء الطبيعة أصبحوا يشكون في مبدأ الحرية الإنسانية ويعتبرون أن الشعور الذاتي بها يخفي جهلاً مؤقتاً بالدوافع لاختيارات البشر، لذا نشهد أن المجتمع المعاصر يتخوف أكثر فأكثر من أن يتحول العالم من عضد للحرية إلى عدو لها، والعالم من وسيلة لتحقيقها إلى خطر عليها. وبمثل ما أن الباعث على النقاش حول الحرية في القرون الوسطى كان هو إرادة التوفيق بين اختيار الإنسان والقدر الإلهي، فإن من أهم أسباب تجديد النقاش في الموضوع اليوم هو محاولة التصالح بين حرية الوجدان وحتمية العلم الطبيعي.
إن تجربة الحرية الأولى التي يتعرف عليها أي فرد من أفراد المجتمع الإنساني هي تجربة الإمكان: بالمعنى المادي، أي القدرة على القيام بعمل يرغب فيه؛ وبالمعنى القانوني أي السماح له بذلك بحيث لا يتعرض لأي عقاب إذا فعل ما يريد. تعني الحرية في هذه التجربة الأولية: مجموع الحقوق المعترف بها للفرد ومجموع القدرات التي يتمتع بها. تحدد الأولى القوانين والأعراف والأوامر التي تؤلف الأفق الاجتماعي للفرد؛ وتحدد الثانية الوسائل التي يملكها داخل مجتمعه وعصره.
ويختم العروي بالقول إن المرء كلما تحرك تواجهه حواجز عائلية وطائفية وقانونية وشرعية، إذا أراد أن يتخطاها دخل في صراع عنيف مع ممثل إحدى تلك الهيئات: الأب، النقيب، الشيخ، الوالي، القاضي. وحسب ما يسفر عنه الصراع تتسع دائرة المرء أو تنحصر، فيشعر بأن حريته تتضاعف أو تتقلص. وفيما يتعلق بالحقوق المادية التي هي وسائل الحرية، نلاحظ أنها تقبل الزيادة والنقصان نتيجة صراع متواصل بين الأفراد والجماعات على مستويات مختلفة، ولا تتحسن حصة الفرد من الخيرات والثقافة والعلم والصحة إلا إذا تحسنت منزلة عائلته بالنسبة للعائلات الأخرى، وطبقته بالنسبة للطبقات الأخرى، ومجتمعه بالنسبة للمجتمعات الأخرى. إن حرية الفرد مرتبطة بتقدم طبقته ومجتمعه والنوع البشري عامة.

الحرية والعبودية: فريدريك دوجلاس
تعني العبودية في نظر دوجلاس وحشية جسدية تشمل التأديب والجلد بالسياط والكي بالنار والتقييد بالسلاسل، كما تنطوي أيضاً على قسوة نفسية كازدراء عقلية العبد وإنكار شخصيته المعنوية، هذا بالرغم من أن هناك حالات استثنائية لأسياد يعاملون عبيدهم بالرحمة والشفقة. ومن المؤكد أن تحول إنسان إلى شيء من ممتلكات إنسان آخر لهو أمر يُشعل حرباً متعمدة ضد الطبيعة البشرية ذاتها، كما أنه إجراء تعسفي يجرد العبد من شخصيته ويباعد بينه وبين المجموع البشري، ويدفع به إلى مستوى أقل من مستويات الحيوانات، وبذلك لا تترك العبودية شيئاً قائماً يمكن أن نقول من خلاله للعالم إنه كان هناك إنسان يعيش مع أخيه الإنسان.
وعلى النقيض من ذلك فإن الحرية تعني العزة والاعتماد على النفس والمسؤولية المعنوية؛ إنها قدرة يستطيع من خلالها أن يختار الشخص (مثلا) المهنة التي يريد والعمل فيها بكبرياء ولذة، كما تعني كذلك استطراد المعرفة والفضائل والاهتمامات الاجتماعية. على أن الحرية ليست تمرداً أو خروجاً عن طاعة القانون؛ فهي مرتبطة ارتباطاً شديداً بالأخلاق، كما أن تحقيقها ليس بالأمر السهل؛ لأن ذلك يتطلب العمل الشاق، كما أن صيانتها تستوجب جهوداً كبيرة ودائمة. إن الحرية والفضية والصناعة والذكاء شيء واحد، لهذا السبب تم اعتبار إنكار العبودية حقاً إنسانياً في تطوره المعنوي والفكري، وهو الذي جعل من الاستعباد في المقام الأول أمراً كريهاً وممقوتاً.

حدود الحرية: هنري بيرجسون
يقال عادة إن للفرد الحق في الحرية التي لا تؤذي حرية الغير، ولكن السماح بالحرية الجديدة التي يكون من نتائجها أن تطغى الحريات على بعضها البعض، في المجتمع الحديث، قد يكون شأنه غير هذا في مجتمع آخر يكون فيه هذا الإصلاح قد بدل العواطف وغير العادات. فمن المستحيل إذن، في معظم الحالات أن نحكم بصورة قبلية ما كمية الحرية التي يمكن أن نسمح بها للفرد من غير أن تؤذي حريته أقرانه. فعندما تتغير الكمية، فإن الكيفية لا تبقى هي ذاتها. أضف إلى ذلك أن المساواة لا تحصل إلا على حساب الحرية؛ حيث يجب أن نبدأ بالتساؤل أيهما أفضل؟ وهذا السؤال لا يحتمل أي جواب عام؛ لأن التضحية بحرية من الحريات -إذا ارتضى ذلك مجموع المواطنين بحرية- يعد من صميم الحرية أيضاً، لا سيما وأن الحريات التي تبقى بعد التضحية قد تكون أسمى إذا كان الإصلاح الذي تحقق في اتجاه المساواة قد أنتج مجتمعاً نتنفس في جوه تنفساً أحسن، ونشعر في كنفه بالعمل أكثر.
ويرى بيرجسون أنه لا بد من العودة إلى مبدعي الأخلاق، الذين يتصرفون بالفكر فضاء اجتماعياً جديداً، ووسطاً تكون فيه الحياة أفضل؛ أعني به مجتمعاً إذا جربه الناس رفضوا أن يعودوا إلى حالتهم الأولى. بهذا وحده يعرف التقدم الأخلاقي، ولكننا لا نستطيع أن نعرفه إلا بعد مدة، حيث يظهر شعور أخلاقي جديد، وعاطفة جديدة شبيهة بموسيقى جديدة، ثم تنقله إلى الناس، وقد طبعته بطابعها الخاص.

الحرية غاية الدولة: باروخ سبينوزا
يؤكد سبينوزا أن الغاية القصوى من تأسيس الدولة ليست السيادة، أو إرهاب الناس، أو جعلهم يقعون تحت نار الآخرين؛ بل هي تحرير الفرد من الخوف بحيث يعيش كل فرد في أمان بقدر الإمكان، أي يحتفظ بالقدر المستطاع بحقه الطبيعي في الحياة وفي العمل دون إلحاق الضرر بالغير.
ويضيف أيضاً إن الغاية من تأسيس الدولة ليست تحويل الموجودات العاقلة إلى حيوانات وآلات صماء؛ بل إن المقصود منها هو إتاحة الفرصة لأبدانهم وأذهانهم كي تقوم بوظائفها كاملة في أمان تام، بحيث يتسنى لهم استخدام عقولهم استخداماً حراً دون إشهار لأسلحة الحقد والغضب أو الخداع، وبحيث يتعاملون معاً دون ظلم أو إجحاف؛ فالحرية إذن هي الغاية الحقيقية من قيام الدولة.
بعد هذه الوقفة مع موضوع الحرية، لا بد من التأكيد على أن الحرية سيف ذو حدين، فإذا لم تكن هناك ضوابط محددة معلومة فمن الممكن أن تؤدي إلى هدم المجتمع ووحدته وتماسكه، خاصة وأن المجتمع اليوم تعترضه تحديات جمّة، وهذا ما يجعل الحاجة إلى سلطة الدولة أمراً ضرورياً، فهي الكفيلة بضمان نوع من التوازن في ممارسة الحرية.