بادئ ذي بدء؛ فإنّ هذه القراءة المُحايِدة، غير المُعمّقة، عن هاتِهِ "الشّموع" الإبداعيّة المُضيئة، وهذه الأسماء العالية، تتطلّب منّي كثيراً من التأنّي والحرص، كما فعل المؤلّف "الحربي" نفسه بقلمه السيّال، وفكره المشرق، في حياكته ونَسْجِه ضفائرَ هذا الكتاب المَائِز المُقنِع، سواء بسواء..
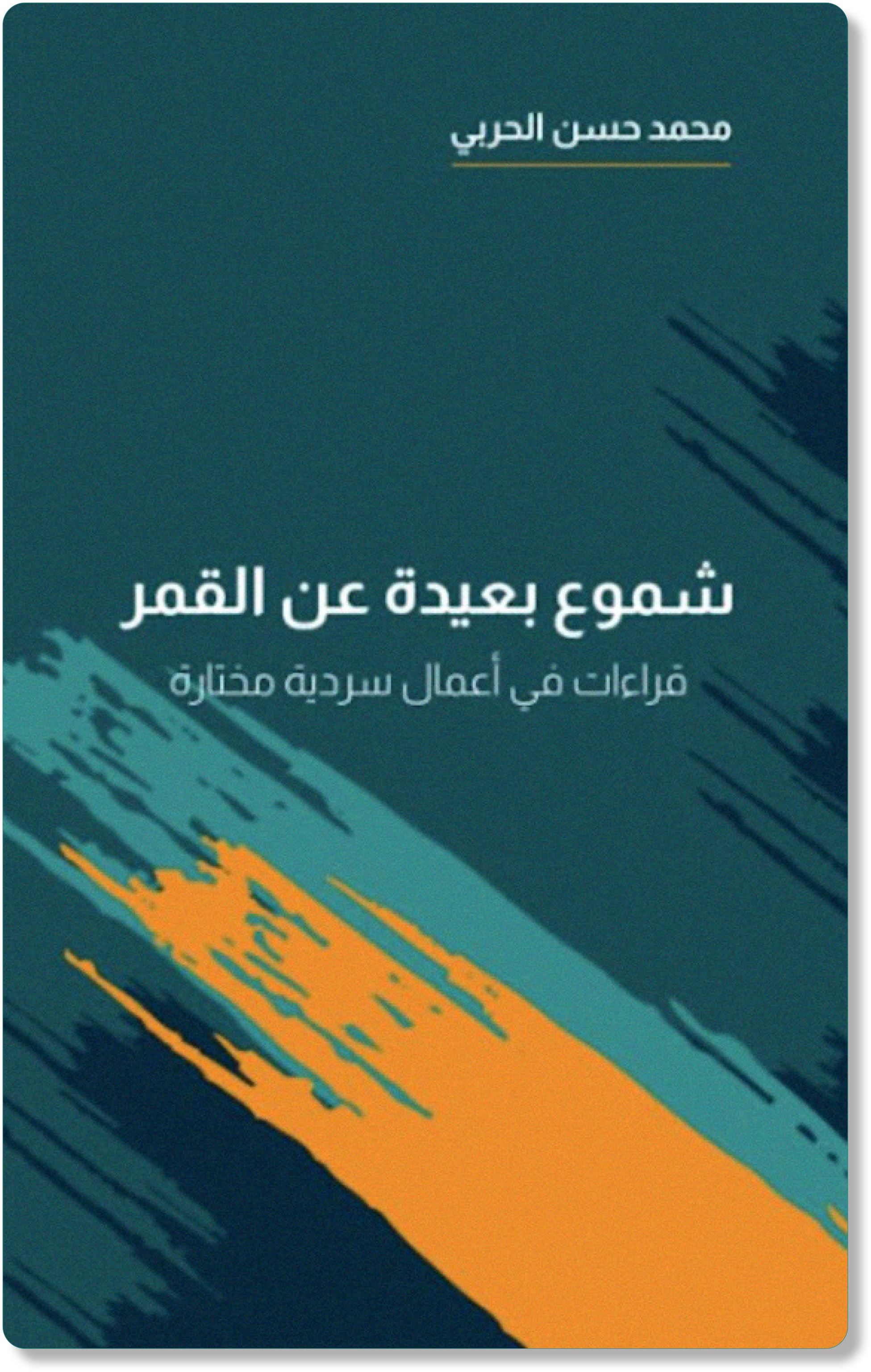
تمّ الكتاب بطبعته الأولى في العام 2022، وبموافقة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات..
وقد قُسِّم هذا الكتاب إلى ما يلي:
1.تعريف موجز بالكاتب والإعلامي والصحافي "محمد حسن الحربي".
2.الطبعة الأولى، العام 2022.
3.الكتاب صادر عن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات.
4. المحتويات: "شكر وتقدير، المقدمة، مدخل، قراءات في أعمال سرديّة، حضور الغائب.. مقامات ومقالات".
يقول الكاتب الحربي في "المقدّمة":
(..وما هو مؤكّد، أنّ هذه القراءات الأدبية والثقافية، ما هي إلّا محاولات جادّة، ليس لإعادة كتابة تلك النصوص السرديّة فقط، التي فكّرت فيها بصوت مرتفع.. بل هي محاولة لتلبُّس الذات الكاتبة للآخر قدر الإمكان)، ويقول: (إنّ هذه القراءات الأدبية الثقافية، أيّاً كان التصنيف الذي سوف تأخذه، تُعدّ بالنسبة إليّ قراءات جوّال، وكتابات رحّال، عنده الحياة فضاءاتٌ مختلفة، يذرعُها طولاً وعرضاً، بحثاً عن ضالّة معرفيّة منشودة، لطالما كان وصفها عسيراً...)!
ويقول المؤلّف: (أمّا المقالات التي انضوت تحت عنوان "حضور الغائب.. مقامات ومقالات"، فقد حاولت فيها، ما اقتضاه الوفاء النّضير في القلب من حديثٍ تستحقّه تلك القامات الكبيرة، التي زادها غيابها المباغت حضوراً متميّزاً، وألقاً مستمرّاً)، ويتابع قائلاً: (إنّ أسماء الأدباء والكتّاب ممّن اخترتُ بعض أعمالهم السرديّة لقراءتي الخاصّة، بسبب من إعجاب، قد خضعت لتراتبيّة ألفبائيّة، وليس لأيّ معيارٍ آخر.. فجميعهم لهم مكانتهم وأهميّتهم).
وفي "المدخل"، يتحدّث الكاتب الحربي عن فنّ الرواية، وأنها – حسب رؤيته ومفهومه – (تشكّل مقطعاً طوليّاً في الزّمن، بما تشتمل عليه من تنويعات في أساليب السّرد، والتجارب الشخصيّة، والخبرات الحياتيّة، مضافاً إليها الأخيلة، على ما فيها من تفاوُت في نسبة الخصوبة).
وحين يُعرّج على فنّ القصة يقول: (أمّا القصة القصيرة، فأرى إلى أنّها تشكّل مقطعاً عرضانيّاً في الزّمن، ليبدوَ العمل فيها أشبهَ ما يكون بشبكةٍ لاصطياد الوقت، أو أشبهَ ما يكون بعملية قنْص اللحظة أو البرهة في الزّمن بغية تخليدها).
وفي هذا السّياق يعقد الحربي مقارنة مقنعة بين فن الرواية، وفن القصة، ويبيّن في ذلك وجوهَ المقاربة والاختلاف بين هذين الجنسين الأدبيين الجمِيلَين.
وممّا قاله في هذا الصّدد: (إنّ مقولة: "الرواية ابنة المدينة"، للناقد الأدبي، والمفكر المجري "الهنغاري"، (جورج لوكاش)، تعني حسب رأي لوكاش، أنها ابنة البرجوازية، التي دائماً ما يكون وجودها في المدن).. ويضيف المؤلف: (وعلى الرّغم من صوابيّة هذا القول، فمن المشروع أنْ يتساءل المرء: ألا يمكن أنْ تكون الرواية ابنة الصحراء مثلاً، مثلما هي ابنة المدينة)؟
ويقول الحربي مُعقّباً: (هناك أمثلة مُتكثّرة، تدلّ على أنّه مثلما للمدينة رواياتها؛ فإنّ للصحراء رواياتها أيضاً.. فهناك رواية "التّبر" للكاتب "إبراهيم الكوني" من ليبيا، ورواية "مدن الملح" من خمسة أجزاء، للكاتب السعودي "د. عبد الرحمن منيف"، وهما قد كتبَا ما يمكن تسميته بـ"النصّ الرّملي، أو النصّ الصّحراوي"، ما قد يشكّل مقابلاً موضوعيّاً لما أُطلق عليه "النصّ المائي، أو النصّ البحري").
ويتابع المؤلّف كلامه: (وإنّ أبرز مَنْ كتبَ في "سرديّات الماء"، هو الأديب المعروف "حنّا مينة" من سورية، في روايته المُونِقة "حكاية بحّار"، وفي سواها.. وأبرز مَنْ كتبَ عالمياً في السرديّات ذاتها الأديب العالمي: "غابرييل غارثيا ماركيز"، من كولومبيا/ أمريكا الجنوبية، في روايته الماتِعة "أجمل غريق في العالم").
ومن "المدخل"، ينتقل المؤلّف إلى فقرة "قراءات في أعمال سرديّة مُختارَة".
ففي البدء، يتحدّث الحربي عن الأديب "د. حمد جابر الحمادي"، مؤلّف روايتَي: "ريتاج"، و"لأجل غيث"، الأولى نُشرت في العام 2014، الثانية في العام 2015، وقد تحدّث الحمادي فيهما عن أمور عدّة، وعمّا أراد قوله بكلّ صدقيّة ومُفاسَحة، "لكنّه ترك لنا الكثير ممّا يقتضي منّا – نحن القرّاء – استنباطه، وإظهاره وتدبّره، ومعرفة الأسباب التي جعلتْه يُمارس صمته المشروع، في روايتيه الاثنتين"، (ص: 27).
ويقول الحربي: "إنّ روايتَي الحمادي، قد ارتقتَا إلى مستوى من الإتقان الفنّي، ومن الانضباطيّة، وقد توافرت الروايتان على عنصري التّشويق والإمتاع، وعلى الإتقان أيضاً، وهذا كلّه يُحسَب لصالح الكاتب بكلّ توكيد"(28).
أمّا عن المضمون الذي أراد الحمادي إيصاله لمتابعيه وقرّائه، فهو أنّ الروايتين، كما يقول الحربي: "قد تضمّنتا جملة رسائل موجّهة إلى جهات وأطراف عدّة.. وتكاد الفكرة في العَمَلَين أنْ تكون واحدة، فهي تتمحور حول التطرّف الذي يُفضي إلى المرض الفكري والنفسي للإنسان، الأمر الذي يدفعه في نهاية المطاف إلى الإرهاب.. ويغدو أقرب ما يكون إلى شخص فيه سُعار.. طاقتُه الفعليّة مشلولة، وبصيرتُه معطّلة"، (ص: 32).
ويقول الحربي مُعقّباً: (إنّ روايتَي: "ريتاج"، و"لأجل غيث"، للدكتور الحمادي، قد قطعتَا بوقت مبكّر تذكرة ذهبيّة في "قطار" المؤلفات المرشّحة إلى الدراما التلفزيونية، وربّما السينمائيّة)، (ص: (40. ويقول الحربي بدافع الإعجاب النّقدي أيضاً: "إنّ الروايتين، تحملان درجة عالية من القيمة الفنيّة"، (ص: 41).
ثمّ ينتقل المؤلف للحديث عن رواية الأديب "سلطان بخيت العميمي"، الموْسومة بـ"ص. ب 1003"، ليعرّفنا على (فتاة إماراتية تُدعَى "عليا"، تدرس في "لندن"، تتعرّف إلى شاب اسمه "عيسى"، فتقرّر التواصل معه عبر الرسائل، و"عيسى" يسكن مع والديه في منطقة "الذيد"، في الشارقة، وبعد فترة من العلاقة مع "عليا" عبر الرسائل، يتعرّض الشاب لحادث مروري، يُتوفَّى بعده).. ويتابع المؤلف: ("يوسف" صديق "عيسى" في مؤسسة البريد بالزيد، يلفت نظره كثرة الرسائل التي ترد من لندن إلى صندوق بريد "عيسى"، وقد كذب "يوسف" على والد "عيسى"، بأنه لا رسائل في الصندوق باسم ابنه، لكنّه في الخفاء، طلب "عيسى" من إدارة المؤسسة تحويل رقم صندوق البريد باسمه شخصياً)، (وقرّر "يوسف" بعدها استئناف المراسلة مع "عليا"، من دون أن يساوِر الفتاة أيّة شكوك، في أنّ مَنْ يراسلها هو "يوسف"، وليس "عيسى" صديق الأمس)، (ص:46 ).
باختصار.. وبلغةٍ مُبْتَسَرَة، فقد لجأ الكاتب "العميمي"، كما يقول الحربي: "إلى طريقة ابتكاريّة، وهي طريقة جَعْل أحداث الرواية غير مرئيّة على الأرض، لكنّها مسموعة بين الناس، وفي الوقت ذاته، يجري بخطٍّ متوازٍ توثيقُها بشهادات متعدّدة عبر استنطاق الجمادات وعقْلنتِها"، (ص: 52).
وفي نظرة أخرى للمؤلف، فإنه يبيّن للقارئ بحياديةٍ وتبصّر، أنّ الرواية المذكورة "تُعدّ عملاً يرقى إلى مستوى من الجودة بين الأعمال السرديّة على مستوى المنطقة الخليجية"، (ص: 60).
وحول رواية "الحمودي.. مهاجر على درب الأنين والحنين"، الصادرة عن "دائرة الثقافة والإعلام" في العام 2013 لمؤلفها وكاتبها د. عمر عبد العزيز، يقول الحربي: "أزعم أنّ هذه الرواية لم تنلْ ما تستحقّه من النقد الأدبي في الصحافة الثقافية الخليجية والعربية، منذ صدورها"، (ص: (67.
ويضيف: (رواية "الحمودي" للدكتور عمر عبد العزيز عملٌ يتمتّع بصفاء لغوي دافئ مملوء بالإيحاءات والإحالات، ممّا يضعه في هذا المنحى بين الألمع من الأعمال السرديّة، التي صدرت للكاتب نفسه، وهي عديدة، بل هي من الأعمال التي حقّقت المعايير كلّها في صناعة السّرد، والرواية تشمل إلى جانب الأدبي، السياسي والفكري والدّيني، وذلك كلّه في رؤى متعدّدة، تتبلور أثناء الإبحار في عوالم النص)، (ص: (68.
ويعقّب الحربي حول مضمون الرواية ذاتها قائلاً: "ما الذي أراده المؤلف من روايته المثقلة باللغة الصّوفيّة، ومحمولات الفكر والفلسفة"؟! "هل أراد الكاتب أنْ يقدّم لنا ما يجعلنا نصل حاضره بماضيه عبر كتابةٍ هي أقرب هنا إلى السّيرة الذاتية والعائلية، المفعمة بالرّموز والمغاصات، والخارجة على جاهزيّة اللغة السرديّة المعتادة، من دون أنْ تتبرّأ من غموضٍ نحسبُه إيجابيّاً، وهو غموضٌ نلمس شيئاً منه في شخصية المؤلف عبد العزيز نفسه"؟ (ص: 70-71).
وعن الأديب "ناصر جبران السويدي"، وعن روايته المعنونة بـ"سِيح المهبّ"، يقول الحربي في كتابه المذكور آنفاً:
"وأنت تقرأ عملاً روائياً لناصر جبران السويدي، فإنّ ثمّة زفرة قويّة تتسيّد المشهد، الذي اختاره ناصر للتّعبير مرتفع النّبرة"، (ص: 75).
ويضيف الحربي قائلاً: (اليوم، وبعد مرور 14 عاماً على صدور رواية "سِيح المهبّ" للمؤلف السويدي، نحن أمام قضية الحنين إلى الماضي مجدّداً، إذ بعد مرور تلك العقود على تأسيس دولة الاتحاد الحديثة، يأتي مَنْ يقول، وبجملة واحدة جريئة: "إنّ الخوف من واقعنا المَعِيش، الذي تحوّل إلى ما يشبه الكابوس، هو الجزء الذي نتجاهله، ونريده أنْ يظلّ خبيئاً، بعيداً عن الأعين")، (ص: 80).
(تنويه لا بدّ منه): "الجملة الأخيرة مُقتبسَة من سِياق رواية السويدي نفسها"!!
ويضيف الحربي في كتابه قائلاً: (إنّ الرسالة التي أرادها لنا السويدي، قد وصلت إلينا بوضوحٍ كافٍ.. فنحن في كثير من حالاتنا وأمورنا كالآخرين في المنطقة الخليجية والعربية، نعيش في "مهبّ" لأرياحٍ لا نعرف لها جهة، ولا نعرف وقتاً لهبوبها، لذا تنتاب قلوبَنا بعضُ الخشية)، (ص: 81).
وحول أدب السويدي وكتاباته، يقول المؤلف بحياديّة وإعجاب: "يُعدّ الأديب السويدي أحد كتّاب عقد الثمانينيات البارزين، ممّن عملوا – إلى جانب الكتابة الأدبية، شعراً ونثراً – على مأْسَسِةِ الثقافة في دولة الإمارات.."، (ص: 81).
وفي عنوان "حضور الغائب.. مقامات ومقالات"، نرى أنّ الكاتب الحربي، يفتتح مقاماته ومقالاته بالحديث عن الشاعر الكبير "حبيب الصايغ"، فهو "مبدعٌ شغل الناس طويلاً"، على حدّ قول المؤلّف نفسه.
ويستفيض الحربي قائلاً: (إنّ الكتابة اللائقة عن قامة شعرية كبيرة في منطقة الجزيرة والخليج العربي، كالإعلامي والأديب الشاعر "حبيب الصايغ" كتابة صعبة.. وقد اتّكأ الشاعر الصايغ في نِتاجِه الشعري على الحداثة، بدءاً من قصيدة التّفعيلة، وليس انتهاءً بقصيدة النّثر، التي ارتاح بعضنا وهو يطلق عليها تسمية "الشِّعر المنثور"، كأنما النّثر لا يمتّ بصلةٍ إلى الشِّعر كَمُكَوّن لموادّه الخام)، (ص: 87 وحتى ص: 89).
ويقول المؤلف الحربي في الصفحة (89) ذاتها: "لقد كان حبيب الصايغ وقلّة معه، هم أوّل مَنْ كتبَ قصيدة النّثر في الإمارات".
وقد أورد المؤلف في ثنايا كتابه أموراً خاصة، وحوارات شائقة، كانت تدور بينه وبين صديقه الشاعر الصايغ، بل إنّ بعضها كان يلامس ملامسة شفيفة بعضاً من السيرة الذاتية لكلا الكاتِبَين، يراها القارئ الحريص مبثوثة بكلّ جَلاء خلال حديث الحربي عن المرحوم الشاعر الصايغ.
ويختم الحربي حديثه عن المبدع الصايغ بالقول: "سيبقى الشاعر الصايغ – رحمه الله – مبدعاً مهمّاً ومتميّزاً، ورقماً صعباً في المشهد الثقافي الخليجي، والمشهد العربي كذلك، ولسوف يشغل الناس طويلاً بشعره وكتاباته النقديّة، ومواقفه الإعلاميّة" ((107.
وعلى ضفّة أخرى، فإنّ مؤلّف الكتاب يعرّجُ في سردياته على موضوعة الشلليّة البغيضة بين بعض الأدباء والكتّاب، فيقول بقهر بيّن، وانزعاج داخليّ: ".. إنّ تلك الشلليّات، التي اعتقدنا للحظة أنّها انتهت وانقضت.. لا تنتجُ سوى الحساسيات المَرَضيّة، وعدم الإنصاف في النظر إلى نِتاجات الكتّاب والأدباء.. وإنّ الشلليّة تُجذّر عزلتين: ذاتيّة وموضوعيّة، وتُغيّبُ النّقد، وتدفع إلى المكتبات بِنتاجاتٍ ضعيفة ومُهلهلة، هي في الحقيقة مرض، لطالما أسهم في تهوّر بعض الكتّاب والأدباء الجُدُد".
أمّا الحديث عن الإعلامي والأديب الكويتي "عبد الله المحيلان"، عن "عاشق الكتابة والمايكروفون والسينما"، كما أطلق عليه المؤلّف، إذ يتناوله على هذا النحو: (ليس مبالغة إذا ما وصفه بعض عشّاقه بأنه "زياد رحباني الكويت"، لكنْ بنكهة محلية خليجية متميّزة.. وقد كان "المحيلان" يرى أنّ الفكر النّقدي هو الذي ينبغي أنْ يتسيّد المشهد الثقافي والسياسي والاجتماعي، إذا ما أراد المجتمع أنْ يحقّق تنمية فعلية) (ص: 115).
ويضيف الحربي في تناوله للمحيلان قائلاً: "كانت مواهب المحيلان متعدّدة، شملت مجالات الفوتوغرافيا والرّسم والسينما والإخراج المسرحي والسينمائي، وإعداد وتقديم البرامج التلفزيونية والإذاعية.. إلخ"، (117). و"كان المحيلان شاعراً شفّافاً، لِشعره جاذبيّة، تستشفّ منه المعاناة، ومن فكره البساطة والعمق في آنٍ معاً"، (ص: (122.
وحول الأديب "ناصر جبران السويدي"، يقول المؤلف الحربي: (رحلَ مُلتفّاً بكبرياء الأسلاف).
ويضيف قائلاً عنه: "الأديب الشاعر والقاص، فقد كان المقهى في حياته تقليداً بارزاً ومهمّاً، فهو يمثّل المكان الأنسب بالنسبة إليه لِممارسة المطالعة والكتابة، والتّخطيط لِمشروعاتٍ أدبيّة"، (ص: 134).
ويقول الحربي عن الأديب ناصر أيضاً: (إنّ تقاعده المبكر من عمله في القطاع العام كمفتش عام في "هيئة البريد"، قد زاد في سعة الهامش، وفي تعميق الشّعور بالوحدة، ممّا اضطرّه إلى مواجهتها..، كلّ ذلك من أجل أنْ ينأى بروحه التوّاقة إلى فضاء الحرية، والكتابة الإبداعيّة: شعراً وقصّاً، أنْ ينأى بها عن الصّخب والضّجيج، والأمراض الفكرية والثقافية.. وهو الذي حفر بأظافره مع مَنْ حفروا أساساتِ الجمعيات الأهلية والمهنية كلّها تقريباً في الإمارات، لكنْ فجأة وجد نفسه على تماسّ مزعج مع الإهمال والتّهميش..)، (ص: 139 - 140).
ويتابع المؤلف كلامه: "لقد ترك لنا ناصر ثمانية مؤلفات: ثلاث مجموعات قصصية، ورواية واحدة، ومجموعتان من النصوص – المقالات، وفي الشعر ترك لنا ديوانين"، (ص: 141).
وفي نهاية الكتاب، فقد أودعَ المؤلف والكاتب "محمد حسن الحربي"، شهادة معمّقة، بقلم الدكتور "عمر عبدالعزيز"، عن شخصية الأديب "الحربي"، وعن كتابه هذا، ومجمل نِتاجاته وأعماله الإبداعيّة والكتابيّة، يقول "د. عمر" ما ملخّصُه:
(عطفاً على تجربة الحربي المديدة بوصفه إعلاميّاً صحافيّاً، وناقداً أدبيّاً، وقاصّاً روائيّاً، فإنّه يقدّم للقرّاء قراءة نقديّة، جمع فيها ما بين الانطباع، والاستبسار المعرفي الإدراكي، الموصول بمنهج يُماهِي فيه بين الوصفي والتّحليلي.. ومن خلال الرّصد "الكرونولوجي"/ التسلسل الزّمني، للاختيارات، يلاحظ المتابع أنّ المؤلف "الحربي" كان – وكعادته – دقيقاً في اختياراته، وفي الوقت نفسه كان بانوراميّاً من خلال المروحة الأفقية للأسماء، التي قدّمت نصوصها في أزمنة متعدّدة، وأجيال مختلفة)، (ص: 143).
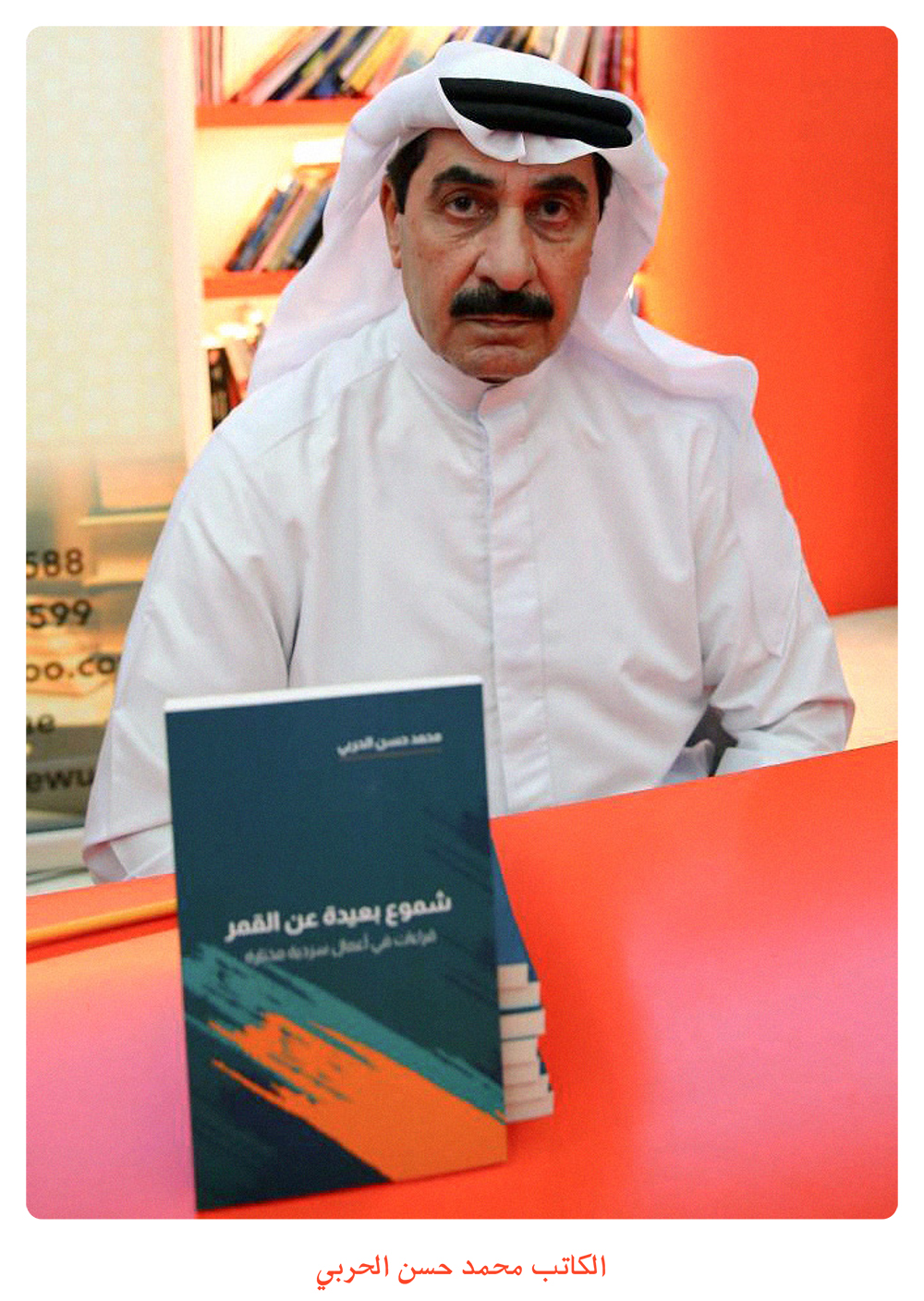
ويضيف "د. عمر عبد العزيز" قائلاً في شهادته عن الأديب "الحربي":
(لقد قدّم المؤلّف محمد حسن الحربي تنويعاً مدارياً، وتطوافاً لغوياً رشيقاً، منح القارئ فرصة الاقتراب من روحيّة النصوص السرديّة التي تناولها، فيما يمكن اعتباره "قولاً على قول"، وتلك لعمري واحدة من محاسن هذه المقاربة النقديّة الشيّقة والجميلة)، (ص: 145).
وفي الصفحات المتبقيات من الكتاب، فقد وضع المؤلف فيها ببليوغرافيا إضافية لإصدارات اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، تناول فيها الحربي الشعر، والمنشورات القصصية والروائية، والتراجم، والتراث والفنون، والمسرح، وكتب الأطفال.