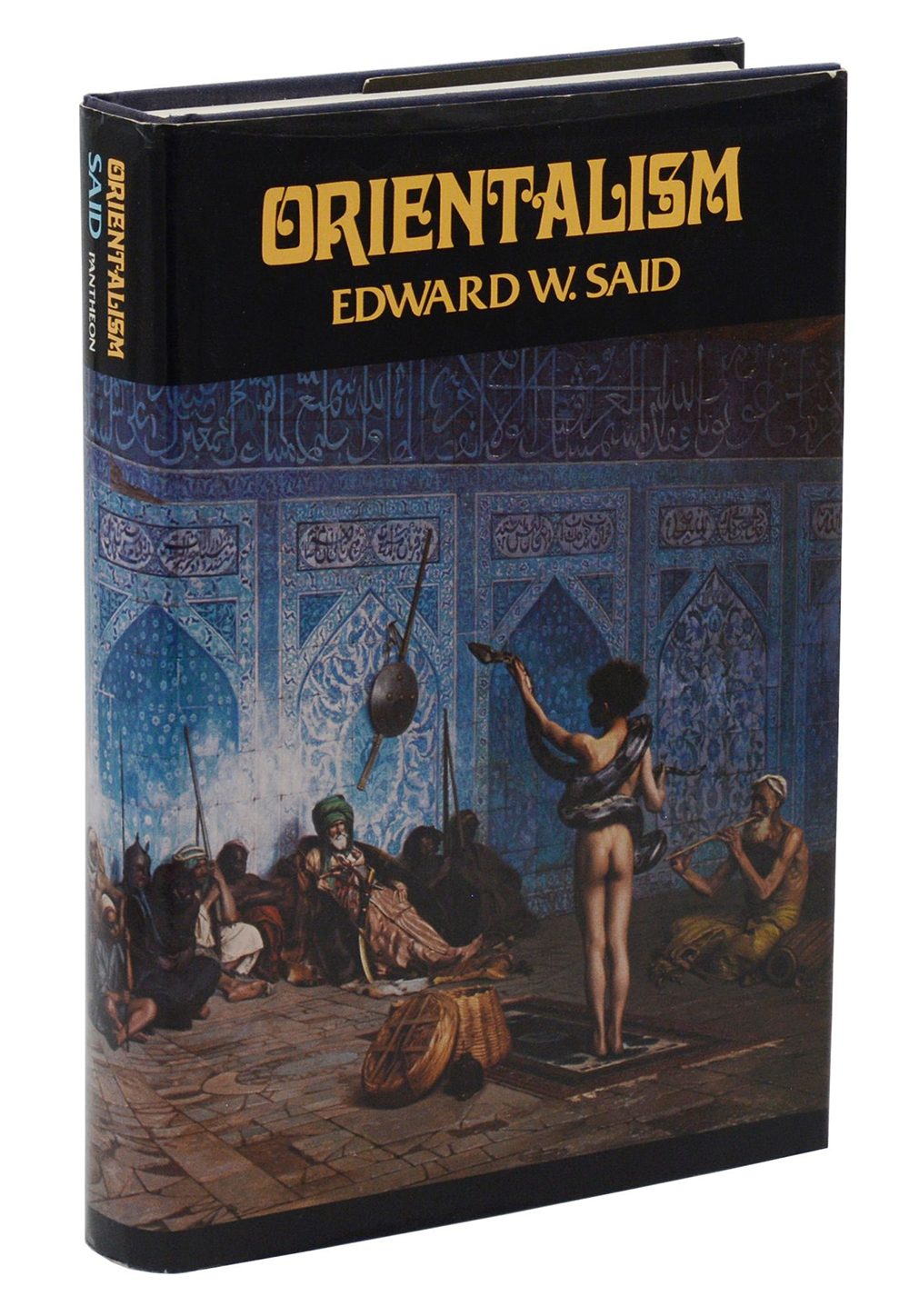
حين صدر كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد سنة 1978، لم يكن مجرد محاولة أكاديمية لتأريخ علاقة الغرب بالشرق، بل كان إعلانًا جريئًا عن ضرورة مساءلة الخطابات الكبرى التي شكّلت تصور العالم الغربي عن الآخر، عن "الشرق". لقد جاء هذا العمل في لحظة تاريخية حرجة، تزامنت مع تصدّع مشاريع النهضة في العالم العربي، وبعد نكسة 1967 التي فجّرت في الوعي العربي تساؤلات عميقة حول الذات والغير، وحول دور المعرفة الغربية في تثبيت تبعية الشرق للغرب، لا عسكريًا فقط، بل ثقافيًا ورمزيًا أيضًا. في هذا السياق، شرع إدوارد سعيد في تفكيك مصطلح "الاستشراق" ذاته، لا كحقل معرفي محايد، بل كخطاب مهيمن ينتج صورة عن الشرق ليست نابعة من واقعه، بل من حاجة الغرب إلى تشييئه وتخييبه، من أجل تكريس تفوقه وشرعنة استعماره.
هنا يبرز سؤال جوهري: هل كان الاستشراق مجرد دراسة ثقافية بريئة للشرق، أم خطابًا وظّف أدوات المعرفة في خدمة مشاريع السيطرة والهيمنة؟ ينقلنا سعيد من قراءة المتن الاستشراقي إلى تفكيك بنيته العميقة، متأثرًا بقراءات ميشيل فوكو، معتبرًا أن الاستشراق ليس وصفًا لما هو كائن، بل إنتاج لما يجب أن يكون، شرقًا خرافيًا، غير عقلاني، ساكن، يحتاج دائمًا إلى أن يُفهم ويُؤطّر من قبل الغرب. ومن هنا ينبثق تساؤل آخر: ما هي طبيعة هذا الخطاب الاستشراقي؟ وما الذي يخفيه تحت لغته الأكاديمية المنمقة؟ لا يكتفي سعيد في هذا الكتاب بالكشف عن اختلالات المعرفة الغربية بالشرق، بل يدعونا إلى إعادة تعريف العلاقة بين القوة والمعرفة، بين من يكتب ومن يُكتب عنه، بين مركز يضع نفسه في موقع الحكم، وهوامش تُساق كما تشاء الأهواء السياسية. إن الاستشراق، بهذا المعنى، ليس مجرد حقل أكاديمي، بل هو ساحة صراع بين من يمتلك سلطة التعريف، ومن يُمنع من الحديث عن ذاته.
◄ تحليل سعيد لمفهوم الاستشراق
كلمة "الاستشراق" ليست محايدة كما قد توحي به بعض الاستخدامات الأكاديمية، بل هي محملة بشحنة تاريخية وثقافية عميقة، كثيرًا ما حضرت في الخطاب العربي الحديث ضمن سياقات الإدانة، والتنبيه إلى ما سُمّي بـ"الغزو الثقافي". وقد تراوحت المواقف منها بين مَن اعتبرها مشروعًا علميًا خالصًا لدراسة الشرق، ومن رأى فيها، خاصة من خلال أطروحة إدوارد سعيد، شكلاً من أشكال الهيمنة الرمزية والمعرفية على العالم العربي والإسلامي.
يُقدّم إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق تحليلًا تأويليًا نقديًا لهذا المفهوم، ويرى أنه لا يقتصر على كونه مجالًا معرفيًا لدراسة الشرق، بل يتجاوزه ليكون أسلوبًا فكريًا ومؤسساتيًا لإنتاج الشرق بوصفه "آخرًا" أدنى، في مقابل "ذات" غربية متفوقة [ص: 43]. فالاستشراق، بحسب سعيد، ليس مجرد خطاب فردي بل "أسلوب للخطاب قائم على تفاهم خاص مع الشرق، مدعوم بمؤسسات ومفردات وصور وأجهزة بحثية وبيروقراطية استعمارية"، وقد تشكل في سياق علاقات القوة، لا خارجها [ص: 44].
ومن أجل تفكيك هذا البناء المعرفي، يقترح سعيد ثلاث دلالات رئيسية للاستشراق:
أولا: دلالة أكاديمية: حيث يُقصد بالاستشراق مجمل الدراسات التي تنتج في الغرب حول الشرق، سواء تعلقت بلغاته أو ثقافاته أو تاريخه أو مجتمعاته، ويُدرج فيها كل من اشتغل بهذه المواضيع من داخل المؤسسات العلمية الغربية.
ثانيا: دلالة معرفية وجودية: وهي البنية التي تجعل من "الشرق" و"الغرب" ليس مجرد تصنيفين جغرافيين، بل نمطين متميزين في الوجود والتفكير، يتم من خلالهما بناء صورة "الشرق الساكن، الغريب، العاطفي، المتخلف"، في مقابل "الغرب العقلاني، المتحرك، المتفوق".
ثالثاً: دلالة سياسية مؤسساتية: وفيها يُقدَّم الاستشراق كجهاز جماعي أنتجته أوروبا في سياق توسعها الإمبريالي منذ أواخر القرن الثامن عشر؛ إذ تقاطعت فيه الجامعات، والمراكز البحثية، والسلطات الاستعمارية من أجل بناء معرفة تؤدي وظيفة السيطرة والتحكم.
وبهذا، لا يعود الاستشراق خطابًا معرفيًا محايدًا، بل يصبح فعلاً سياسياً وثقافياً يخدم مشروع الهيمنة الغربية؛ إذْ إنّ المعرفة فيه ليست خارج السلطة، بل متشابكة معها. وكما يقول سعيد: "إن ذلك الخطاب يأتي إلى الوجود ويحيا في إطار التبادل المتقلب مع شتى أنواع السلطة، فيتشكل إلى حدّ كبير من خلال مبادلاته مع السلطة السياسية، والسلطة الفكرية، والسلطة الثقافية، والسلطة الأخلاقية..." [ص: 58].
◄ نشأة الاستشراق
لا يمكن فهم نشأة الاستشراق بمعزل عن السياقات الدينية والسياسية التي شكلت العلاقة بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي. فقد رأى إدوارد سعيد أن البدايات الأولى للاستشراق تعود إلى العصور الوسطى، حينما انشغل رجال الكنيسة في أوروبا بالرد على الإسلام، لا باعتباره مجرد دين منافس، بل كقوة رمزية قادرة على زعزعة الإيمان المسيحي. كان الخوف من الإسلام، آنذاك، خوفًا من قدرته على الإقناع، لا فقط من عنفه أو انتشاره. وهكذا بدأ "الشرق الإسلامي" يُصاغ في الوعي الأوروبي ككيان غريب، يجب تحصين الجمهور المسيحي ضده عبر خلق فجوة رمزية بينه وبينهم.
غير أن لحظة الانعطاف الحاسمة للاستشراق، كما يرى سعيد، لم تتحقق إلا في أواخر القرن الثامن عشر، مع التزايد الملحوظ في أعداد الأساتذة الأوروبيين المختصين في "الدراسات الشرقية"، وبلغت ذروتها مع الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798، التي مثّلت أول حضور استعماري مباشر للغرب في قلب الشرق. ومنذ تلك اللحظة، لم يعد الشرق يُدرس فقط عن بعد، بل أضحى ميدانًا ملموسًا تُنتج حوله المعرفة تحت حماية البنادق والمدافع. وكما يقول سعيد، فإن الغرب بات "يستطيع الحضور إلى الشرق، أو التفكير فيه، دون مقاومة تُذكر من جانبه" [ص: 51]؛ وهكذا بدأ ما يسميه بـ"العصر الذهبي للاستشراق".
في هذا السياق، لم يعد الاستشراق مجرد جهد علمي لفهم حضارة أخرى، بل صار نظامًا معرفيًا أيديولوجيًا محكمًا، ينتج الشرق بوصفه موضوعًا للمعرفة والهيمنة معًا. لم يُسمح للشرق بأن يعرف نفسه بنفسه، بل أُعيد تشكيله داخل خطاب غربي يُعرّفه، ويؤطره، ويمنحه ملامحه. يضرب سعيد مثالًا دالًا على ذلك من خلال الروائي الفرنسي جوستاف فلوبير، الذي التقى بغانية مصرية في رحلته إلى الشرق، لكنه لم يرو قصتها كما روتها هي، بل تحدث باسمها، صوّرها من خلال خياله، وفرض عليها تمثُّلًا لم يكن صوتها حاضرًا فيه، بل كانت فقط صورة تُنطق بما أراد هو أن يقوله عنها [ص: 49].
وهكذا؛ فإن الاستشراق لم يكن إلا عملية مستمرة لتكريس الفروقات، لا على أساس المعرفة الموضوعية، بل على أساس تعارض ثنائي: الغرب المتقدم، العاقل، الفاعل؛ مقابل الشرق المتخلف، العاطفي، المفعول به. لقد شُيّد الشرق في الخطاب الاستشراقي ليكون "آخرًا" بالضرورة: امرأة صامتة، أو رجل خاضع، أو ثقافة غريزية، في مقابل رجل غربي عقلاني، نشيط، ومتفوق. ولم يكن هذا الخطاب ناتجًا عن سوء فهم عفوي أو جهل بريء، بل هو نتاج عملية ممنهجة كما يوضح سعيد تأسست على شروط معرفية وثقافية وتاريخية، تعكس تمركز الذات الأوروبية في مقابل الآخر الشرقي. ولعل أبرز ما يلفت الانتباه هو أن هذه الصورة لم تكن مجرّد خيال متوهّم عن الشرق، بل بنية متكاملة، تم إنتاجها وتداولها وتعزيزها عبر الأجيال، حتى أصبحت مكونًا من مكونات المخيال الغربي [ص: 50].
يصل سعيد إلى جوهر أطروحته حين يُبرز أن خطر الاستشراق لا يكمن في بُعده الأكاديمي فحسب، بل في تسلله إلى الثقافة العامة الغربية، حيث لم يعد من الضروري قراءة كتابات المستشرقين لفهم الشرق، بل باتت صورة "الشرقي" حاضرة مسبقًا في الأفلام، والمناهج، والسياسات، كصورة نمطية تبرر التدخل والهيمنة، وتُسهم في إنتاج شرقٍ لا يعبّر عن ذاته، بل يُمثَّل دائمًا من قِبَل الآخر الغربي. وكما يقول سعيد، في استعادة ذكية لمقولة ماركس: "إنهم لا يستطيعون تمثيل أنفسهم، ولا بد أن يُمثَّلوا" [ص: 70].
◄ الأدوار التي يلعبها الخطاب الاستشراقي
بالنظر إلى الخطاب الاستشراقي كما حلّله إدوارد سعيد؛ فإنه لا يمكن اعتباره مجرد اجتهاد أكاديمي معزول لدراسة حضارات الشرق، أو مقاربة ثقافية بريئة تنفتح على الآخر من موقع الحياد. بل هو، في جوهره، خطاب مزدوج الوظيفة، استُخدم لخدمة غايتين أساسيتين: أولاهما تكريس التفوق الحضاري والثقافي للغرب، عبر إعادة إنتاج هويته الذاتية في مقابل شرق مفترض؛ وثانيتهما، وهي النتيجة العملية، تسويغ مشاريع الهيمنة الإمبريالية والاستعمار.
فإذا ما تناولنا الغاية الأولى بتفصيل، نجد أن سعيد يبين كيف أن الغرب احتاج إلى "آخر" يُبنى كنقيض مفهومي له ليؤكد ذاته ويفسر وجوده بوصفه المركز والمعيار. فالهويّة الغربية، بما تحمله من قيم العقلانية، الحداثة، التقدم، والعلم، لا تُفهم إلا عبر نفي كل ما يناقضها، ولا تُثبت إلا عبر إنتاج ضدّها: الشرق. وبهذا يصبح الغرب عقلانياً لأنه يقف أمام شرق مشبع بالخرافة، ويغدو متقدماً لأنه يقارن نفسه بشرق متأخر، ويُعرّف كحداثي لأنه يواجه شرقاً يُوصَف بالجمود والارتداد إلى الماضي. وهذا ما يعبر عنه سعيد ضمنيًا حين يقول إن الهوية لا تُفهم إلا عبر علاقتها بالاختلاف، وأن الغرب لا يملك تصوراً لذاته إلا بإسقاط صورة كاريكاتورية عن الآخر تخدم تمركزه وتفوقه [ص: 94]. لقد عمل الخطاب الاستشراقي، إذن، على بناء شرق مُفصّل على مقاس حاجات الغرب النفسية والسياسية، شرقٌ يُقدّم كفضاء للركود والانحطاط والتقليد، وكمنطقة لا تاريخ لها إلا بمقدار ما دخلته أوروبا في زمن الاستعمار. وهذا الشرق الذي صاغه المستشرقون لم يكن مجرد نتاج تأمل نظري، بل بناء رمزي مكثف يجسّد رغبة الغرب في أن يرى نفسه دائماً في موضع النقيض المتفوق، حيث يوضع الإنسان الشرقي في تمثلات هذا الخطاب ككائن غرائزي، بدائي، خاضع لقوى الطبيعة، سجين للأساطير، ومتخلف معرفياً وسلوكياً، يعيش على هامش التاريخ والحضارة [ص: 95]. وفي هذا السياق، لا يعود الشرق سوى وهمٍ وظيفي يُستخدم لترسيخ صورة الغرب عن نفسه؛ إذْ إنّ ما فعله الاستشراق لم يكن وصفاً لواقع بقدر ما كان ممارسة رمزية لخلق واقع يناسب الحاجة الغربية إلى تأكيد تفوقها الذاتي [ص: 102]. هكذا، أعاد الغرب عبر هذا الخطاب إنتاج هويته الحضارية لا في فراغ محايد، بل على أنقاض هوية نقيضه المصنوعة سلفاً، في عملية مزدوجة تتداخل فيها المعرفة بالسلطة، والوصف بالإخضاع، والانبهار بالاحتقار.
ضمن هذا السياق الذي تتداخل فيه المعرفة بالسلطة، ويُبنى فيه الشرق بوصفه نقيضاً وظيفياً للغرب، تتجلّى غاية أعمق في الخطاب الاستشراقي كما حلّله إدوارد سعيد، وهي غاية تسويغ الاستعمار وإضفاء طابع الضرورة عليه. فليس الاستعمار، وفق هذا المنظور، فعلاً عنيفاً أو انحرافاً عن القيم الإنسانية، بل يُقدَّم في إطار هذا الخطاب كخيار "طبيعي" و"أخلاقي" و"حضاري". إنه الحلّ المنطقي لما يُصوَّر كأزمة حضارية يعيشها الشرق. وهنا، تتحول الهيمنة الثقافية إلى دعامة للهيمنة السياسية، حيث يُراد للغرب أن يظهر بوصفه وصياً تاريخياً على شعوب لا تقوى على حكم ذاتها، ولا تمتلك من أدوات التنظيم والتسيير سوى ما يُبقيها غارقة في التقليد والتبعية [ص: 104].
إن سعيد يلفت الانتباه إلى أن هذا التبرير للاستعمار لم يكن مجرد نتيجة عرضية للاستشراق، بل كان مكوّناً بنيوياً فيه؛ فحين يُصوَّر الشرق على أنه فضاء للخرافة والبدائية، يصبح تدخل الغرب أمراً مرغوباً ومبرَّراً، بل ومطلوباً كـ"واجب حضاري". لقد أُعيد تعريف العلاقة الاستعمارية كعلاقة "مساعدة"، حيث يظهر المستعمِر لا كمعتدٍ، بل كمخلّص، وكفاعل عقلاني يتحمّل عبء الحضارة تجاه شعوب تعيش في مرحلة طفولية من التاريخ. ومن هنا تنبع الفكرة الخطيرة التي تتسلل في ثنايا الخطاب الاستشراقي: أن الشعوب الشرقية قاصرة بطبيعتها، وأنها غير قادرة على تحقيق ذاتها دون تدخل "العقل الغربي"، مما يجعل السياسات الاستعمارية مجرد امتداد "طبيعي" لمهمة الغرب التاريخية [ص: 580 220- 222].
في هذا التصور، يغدو الشرق أرضاً بكماء تنتظر مَن يُنطقها، وشعوباً ساكنة تنتظر من يُحييها. وهكذا تتكرّس النظرة الاستعلائية الغربية في أبشع تجلياتها، حيث لا يُكتفى بإخضاع الشرق واقعياً، بل يُجَرَّد من أهليته الوجودية والسياسية والمعرفية، في عملية "استلاب مزدوج" تُنتج شرقاً محتلاً لا فقط بالأدوات العسكرية، بل باللغة، بالصور، وبالتمثلات. وهذا ما يسميه سعيد بـ"إعادة بناء الشرق"؛ أي إخضاعه ضمن شبكة رمزية ومعرفية تجعل من احتلاله ضرورة عقلانية، وتمدّد الغرب نحوه تكليفاً تاريخياً [ص: 235- 245].
من خلال هذا التحديد ينتهي الرجل إلى أن المدارس الاستشراقية وخاصة الإنجليزية والفرنسية، استعملت كحصان طروادة للهيمنة على الشرق وأبنائه ومقدراته من جهة، ولتضخيم الأنا الغربية وعادة إنتاج الغرب لهويته من جديد من جهة أخرى. فالهيمنة الغربية ما كانت لتكون بهذه القوة لولا الخطاب الاستشراقي. وأيضاً فإن ما يحسب للغرب في هذه القضية أنه أحسن التعامل مع مقولة أن المعرفة قوة، والاستشراق مثل المعرفة الكاملة بكل ما في هذا الشرق، مما سهل مهمة السيطرة على الشرق، بعدما تغلغل في داخله واكتسب المعرفة الكاملة بكل خصائصه وخباياه وأموره الظاهرة والباطنة. وهكذا فإن الاستشراق في جزئه الكبير كان وسيلة شوهت ومسخت الشرق وساعدت بالتالي على الهيمنة وعلى التسلط والاستعمار الذي مورس بحق هذا الشرق سواءً كان ثقافياً أو سياسياً.
خلاصة:
إن إدوارد سعيد لا يدين المستشرقين جميعهم، بل يُدين تراث الاستشراق باعتباره إطارًا فكريًا وثقافيًا واسعًا، يكاد أي مفكر أو أديب شرقي أو غربي أن يخرج عنه؛ ففي خضم هذا التراث، غالبًا ما نجد الكاتب أو الباحث، مهما كانت نزوعاته الأصيلة، محاطًا بصور ملونة مسبقًا عن "الشرق"، لا من نفسه، بل مما ورثه عبر السرديات الاستشراقية. فعلى سبيل المثال، قد يهيم شاعر أو أديب منحرف عن الرؤية السائدة في الشرق، معتقدًا أنه يخلق مشهداً فنيًا جديدًا، لكنه في الواقع يستدعي "تلوينًا خياليًا"، كما عبّر عنه كولريدج، يُضفي شرعية جديدة للصور التقليدية، خصوصاً عندما تتكرر هذه الكتابات في بيئة لا ينتقدها فيها النقاد والنظراء. وهنا، تنشأ حالة مخاتلة: يبدو النص جمالياً وأصيلاً، لكنه في الجوهر يعزز أفكاراً متجذّرة مسبقًا في الخطاب الاستشراقي، فتصبح قوة هذا التأثير تمتدّ إلى الباحث الأكاديمي، فيُفهم أن هذه الكتابات "أمينة" أو "صادقة"، بينما هي في الحقيقة نقل لصورة مهيمنة مسبقاً.
كما، يُحذّر سعيد من خطر الاستشراق الداخلي، الذي لا يقتصر على الغرب، بل يتغلغل داخل نصوصنا العربية والإسلامية. فالشرقي، عن غير وعي، يبدأ في تفسير ذاته ومنطقه ضمن إطار الغرب الاستشراقي، فيُعيد إنتاج النظرة الاستعلائية، وتغدو قدراته الفكرية والسياسية "مشكوكًا فيها". إن ما يسميه سعيد بـ"الاستغراب" هو امتداد لهذا الخطاب، حيث يُفترض أن الشرق عاجز وإلى الأبد، وأن خلاصه لا يكون إلا بتقليد النموذج الغربي، مما يرسّخ تبعية جديدة تحت غلاف "العقلانية" و"الحداثة". ولذلك، لا يناهض سعيد الغرب أو التقدّم الغربي كمبدأ، بل ينتقد الاستشراق كمفهوم وعقبة أمام حوار حضاري محترم ومتكافئ. إن التحدي الحقيقي، بحسبه، ليس في رفض الغرب، بل في نقد المناهج الاستشراقية داخل كل من الغرب والشرق، واستبدالها بمنهجية علمية ونقدية قادرة على فتح قنوات تفاعل حضاري مبني على الاحترام واعتراف متبادل بالخصوصيات المشتركة.
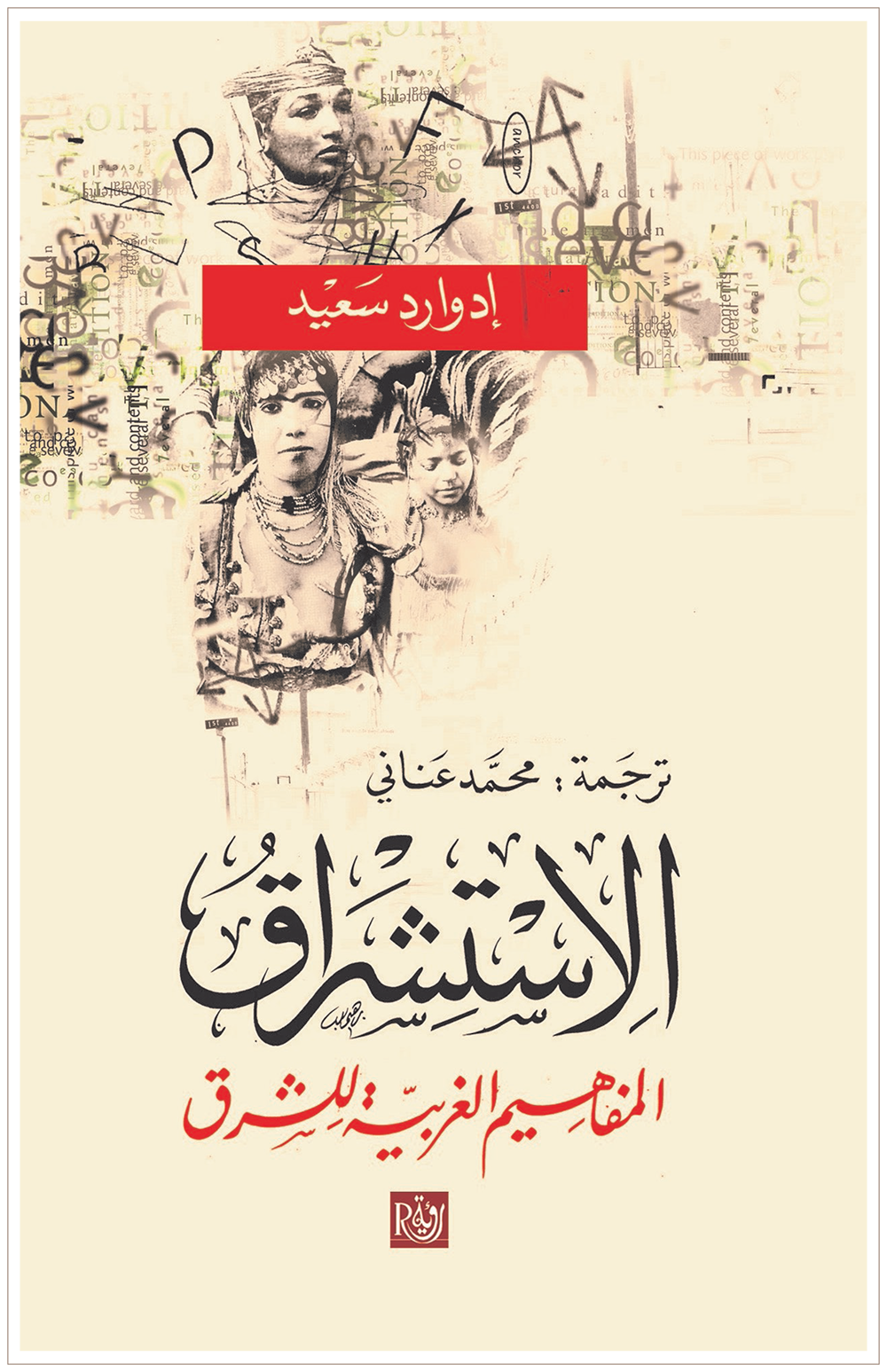
المرجع ◂ إدوارد سعيد، الاستشراق "المفاهيم الغربية للشرق"، ترجمة محمد عناني، القاهرة: دار رؤية، 2006.