تمثل رواية (فتنة الربض) للكاتب الروائي محمد ولد محمد سالم التي صدرت مؤخراً "لحظة" فارقة في الحصيلة الروائية الموريتانية عموماً، والمسار الروائي لكاتبها خصوصاً، حيث سبقتها مجموعة من الروايات الهامة التي أصدرها المؤلف خلال العقدين الأخيرين مثل: "ذاكرة الرمل"، و"دروب عبد البركة"، و"أشياء من عالم قديم"، و"دحان".
ويعد محمد ولد محمد سالم أحد أبرز الروائيين من جيل ما بعد تأسيس الكتابة الروائية في موريتانيا، وهو الجيل الذي ترسخت معه تقاليد الرواية، التي يعتبرها مخائيل باختين النوع الأدبي الأحدث والوحيد الذي لم يبلغ طور الاكتمال، ويعني هذا أن التراكمات الروائية في مختلف أنحاء العالم وعبر السنين معنية بالمساهمة في تشكيل الصورة المستقرة "النهائية" لهذا النوع الأدبي الأبرز خلال المائة سنة الأخيرة.
رواية تاريخية عجائبية:
تنتمي الرواية الجديدة لمحمد ولد محمد سالم إلى نمط من الإبداع الروائي يقفز داخل المراحل التاريخية ملتقطاً لحظة درامية فاصلة، يقدمها في ثوب تراثي غرائبي محكم النسج والحبك سرداً، ووصفاً، ولغةً، عبر حوار فكري وثقافي متعدد الأصوات والدلالات.
تقدم الرواية في مستوى البنية السطحية (فتنة الربض) في عهد أمير الأندلس الحكم الأول بن هشام الشهير بالحكم الربضي، نسبةً إلى المجزرة التي أوقعها بثوار أرباض قرطبة، واشترك فيها كثير من فقهاء الأندلس، وتجارها، وعمالها، ومسحوقوها. والرواية رغم تصويرها لهذه الفترة المضطربة؛ فإنها تنصف الأمير الحكم أيضاً في بعض العناصر الإيجابية كتقدير العلماء، واحترام القضاء، والحرص على الدفاع عن الدولة، وإن كانت تكشف بجلاء ما تميز به عماله من إرهاق الناس بالجباية تحت عناوين مختلفة على نحو أثقل كاهل الرعية، وأثر على معاشهم وسير حياتهم.
المؤلف الورقي والكاتب الحقيقي:
يُوهمنا الكاتب بذكاء أن مؤلف الرواية مجهول، ويحاول إقناعنا أن المؤلف البشري المدون اسمه على غلاف الرواية ليس سوى مكتشف النص وناشره، أما صاحبها (الحقيقي) فقد طوته الأيام والسنون خلف سجوف الضياع والنسيان، وتلك تقنية سردية ترمي لإقناع القارئ بحيادية المؤلف بل غيابه عن الأحداث.
إن الرواية لا تنتمي للسرود التاريخية التوثيقية، ولا تلك التي تتقمص التاريخ لقراءة الواقع عن نحو سطحي فج، وقد خصص الكاتب الفصلين الأول والثاني لشرح (إشكالية) مؤلف الرواية أو السارد الخفي، وقد اختار ضمير المتكلم الذي يوفر مزية "الإقناع"، ولكنه يضمر "مخاطر" الإيهام بالانطباق بين البطل والسارد، وهما شخصيتان من نسج خيال.
تقنيات الزمن في الرواية:
سيطرت على سرد الرواية تقنيات التصرف في الزمن التي تعمقت دراستها مع السرديات البنيوية، خصوصاً مع جيرار جينت وأمندولا، وكما استقرت في الدراسات العربية الحديثة مع دارسين أمثال سعيد يقطين، وسعيد بنكراد، ولحميد حمداني، مثل: الاسترجاع والاستباق، والثغرات الزمنية والوقفات... إلخ، كما اعتمد السارد على الوصف والحوار، من خلال "وقفات" زمنية تكاد الأحداث فيها تصل مرحلة الصفر، أو تنمو خلالها ببطء، وكلها آليات تمكن السارد من إعادة التحكم في زمن الأحداث ليقدمها لنا على نحو مقنع للقارئ، وقد لخص الفصل الثالث معظم أحداث الرواية عن طريق تقنيات الاسترجاع والاستباق التي أشرنا إليها سابقاً، حيث يعود زمن الحكي إلى ما بعد أحداث فتنة الربض بحوالي 40 سنة، حين بلغ بطل الرواية الستين من عمره، ولكن السارد شرع في سرد الأحداث منذ كان هذا البطل في التاسعة عشرة من عمره، وبين العشرين والستين أحداث كثيرة صمتت عنها الرواية، باستثناء إحالات ضامرة.
ولعل من أبرز الاسترجاعات الزمنية في الرواية الاستشهاد التالي: "التحقت بالعمل مع أبي أيوب الحداد في زقاق الحدادين الذي خلف سوق القيسارية في الناحية الجنوبية الشرقية من قرطبة، بشهور بعد حادثة صلب عشرة من رجال ربض شنقندة، قتلهم الأمير الحكم بن هشام بسبب معارضتهم الظاهرة لغرامة الحشد للجهاد، التي فرضها على أهل الأرباض إعفاء لهم من الجهاد، وحتى يجد ما ينفق به على جيوشه التي تخرج في حملات الصوائف للجهاد في الثغور [ص: 6].
أما الاستباق فمن أمثلته: "وقد تعجبنا لذلك الشرود، وأقلقنا عليه، وخشينا أن يكون متألماً من شيء، وكان صبوراً كتوماً، كثيراً ما تنتابه الحمى الشديدة، فلا يبرح مكانه يصوب ويشرح حتى ينتهي آخر الطلاب من دروسهم، لكنّ أذهاننا لم تذهب البتة إلى ما كان سيحصل في تلك الليلة، ولم نظن أن ذلك المجلس الموقر الكريم الذي نرفل في أفيائه سوف لن ينعقد بعد ذلك اليوم" [ص: 6-7].
وقد يصرح السارد بطول القصة وامتدادها مما نتوقع معه عرض الأحداث وفق نوع من الترتيب الذي يشعر بالتفصيل، وتراخي عملية السرد، ولكنه يحبك صياغة الحكي على نحو ذكي وسريع من غير أن ينتبه القارئ كثيراً لذلك: "ها أنا أعود إلى حكاية حاييم الإشبيلي مع طالوت كما رواها لي.. وهي حكاية عجيبة وطويلة.. فعندما سمع حاييم اسم طالوت أول مرة ظن أنه حاخام يهودي، وذلك حين طلب إليه أحد عرفاء البنائين اسمه أحمد بن مردنيش أن يعمل له بعض أعمال التجارة في دار طالوت بن عبد الجبار، وأنه فقيه مسلم أصيب بنوع من الخيبة، بيد أن حاييم كان يزن الأمور بعقل راجح، ويعرف أنه صاحب حرفة، عليه أن يرضي زبناءه بصنعة متقنة ليجني عليها أجراً جزيلًا، وحين قابل طالوت أول مرة وجد أن شيئاً في الروح يجذبه إليه، فقد كانت عليه هيبة ووقار، لم يرهما من قبل" [ص: 74].
ويبدو من اللافت في هذه الرواية توظيف الحوار على نحو كبير في تحريك الأحداث وتطوير العملية السردية، وهو منحى نراه طريفاً في السرود العربية الجديدة، ويكشف نوعاً من التعالق الإيجابي بين الدراما المسرحية الحديثة مع الرواية الفانتازية بطريقة لا تبتعد كثيراً عن تلك الوشائج العميقة بين الأعمال التجديدية الروائية والقصيدة الدرامية الحداثية.
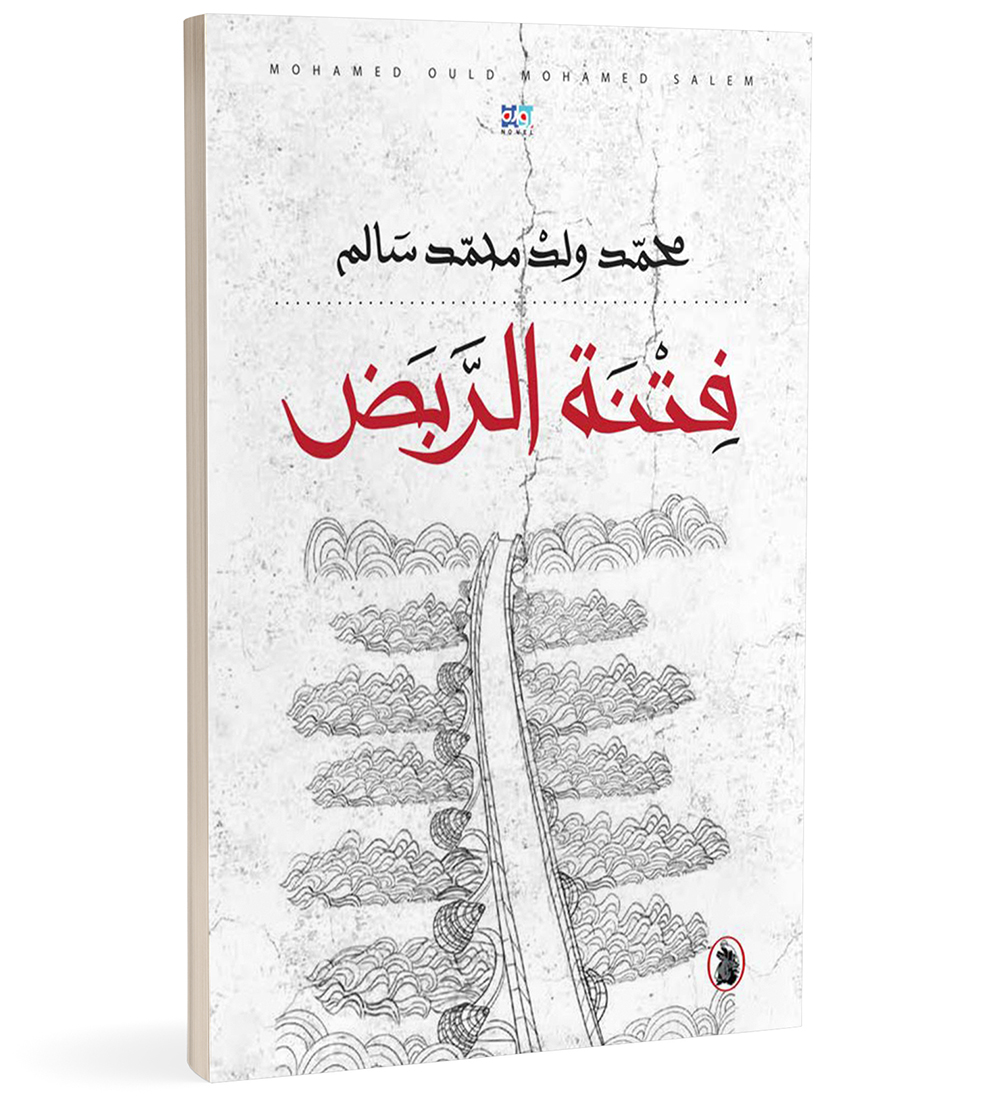
ويمكن القول؛ إن هذه الرواية تستكنه في مستوى البناء السردي لحظة تراثية فارقة، وتتلبس أقنعة سردية حديثة بالغة التكثيف، ودون مبالغة في الإغراب والتجريب، وهذا المستوى من ملامسة التراث نادر في التجربة الروائية العربية الطويلة، وإن كانت درة جمال الغيطاني (الزيني بركات) تمثل أبرز نموذج في الرواية التاريخية ذات البعد العجائبي الفني المكثف، ولا شك أن هذه الرواية تمثل انعطافة جوهرية في هذا المنحى السردي المتميز.