لا ريب في أن أكثر الألفاظ استخداماً في معاجم اللغات البشرية منذ مطلع سنة 2020 إلى هذه اللحظة (آخر مايو/نيسان)، هي كورونا أو كوفيد-19 لدى المختصين وعامة الناس على حد سواء، فحيثما توجهنا إلى المذياع أو في الميديا أو النت فإن لفظة كورونا تطالعنا صباحاً ومساءً، ليس حباً فيها وإنما لثقل وطأتها على مجريات الحياة العامة والخاصة على حد سواء.
تواتر هذه اللفظة على الألسنة يشبه تواتر لفظة "سيدا/ إيدز" في التسعينيات من القرن المنصرم أو "اسبيرين" في الأربعينيات من القرن ذاته. وأيا كان المقام التاريخي الذي تتنزل فيه هذه المفردات فإن ما نلاحظه هو أنها وثيقة الصلة بصحة الإنسان، الذي أوجد الأدوية المناسبة لبعض الأمراض ولكنه –لأمد قد يطول أو يقصر– ظل عاجزاً عن إيجاد التلاقيح المناسبة لأمراض أخرى مستعصية.
هناك بعض الأمراض التي تتصل بالتنظيم الطبقي والاجتماعي للمجتمعات والأمم، فالكوليرا وباء ينتشر حيث الفقر وانعدام قيم النظافة وغياب الدولة في تحمل واجباتها في بناء المرافق الضرورية لتحصين شعبها من هكذا أوبئة، وكذلك بالنسبة للمالاريا... أما مرض الاكتئاب – على سبيل المثال– فهو يؤشر على نمط تلك الأمراض النفسية التي تصيب الطبقات الرفيعة والنخب العليا من المجتمع. ولكن مع تقدم الطب وتحسن الظروف الاجتماعية لأغلب المجتمعات برز معطى جديداً كان فيما مضى منسياً أو ربما غير مفكر فيه وهو: "كيفية التعاطي مع الشيخوخة والهرم خاصة وأن هذه الحقبة من الحياة تتصل بقرب نهاية الإنسان وبالاستعداد إلى توديع الحياة. ولكن هل أن في أخلاقيات الطب ما يسمح بأن نهيئ الإنسان إلى تقبل نهايته، سيما وأن الدرس الأول الذي يتلقاه كل طلبة الطب هو في: "تعليمنا كيف ننقذ الناس وليس كيف نعتني بنهايتهم" [ص: 11].

في هذا الكتاب الذي دونه الطبيب الأمريكي ذو الأصل الهندي أتول غَوَاندي Atul Gawande (الصادر عن عالم المعرفة الكويتية سنة 2019 بترجمة رائعة من الباحث عبد اللطيف الخياط)، سرديات مختلفة وحكايات وقصص عن أناس شارفوا على التسعين أو المائة، ولم تعد أجسادهم تتحمل الأدوية والعقاقير والحقن، ومع ذلك فإن هذا الطبيب قد ظل وعيه منشطراً بين حقيقتين: هل إن دوره يتمثل في علاجهم العلاج الكلاسيكي مع اليقين بمحدودية أثر هذا العلاج، أم إن دوره يكمن في مرافقتهم إلى نهايتهم المحتومة بأقل ما يمكن من الأوجاع والأضرار.
هذا الطبيب اختار تخصصاً لا يميل إليه الأطباء عادة ولا يستطيعون أن يبنوا فيه مجدهم العلمي ولا صيتاً أكاديمياً أو معرفياً، وهو تخصص طب الشيخوخة الذي يشمل أيضاً أولئك المصابون بالسرطان في آخر مراحله (المرحلة الرابعة بالاصطلاح الطبي)، فمهما بلغت حرفية الطبيب وعبقريته فإن آثار هذه العبقرية والحرفية لا تكاد ترى، ولا يخضع عمله إلى تقييم كون النتائج معلومة ومقدرة سلفاً... ومع ذلك اختار هذا التخصص لسببين، الأول لأنه ظل وثيق الصلة بأصوله الهندية وبحضارة أجداده وثقافتهم التي تعلي من شأن الكبار في السن وتعدهم مناجم للمعرفة وللحكمة والتجربة، والسبب الثاني هو في سعيه إلى نقل هذه التجربة في العناية بالكبار في السن من المجتمع الهندي إلى المجتمع الأمريكي، على الرغم من الفوارق الكبرى التي تسم نظرة كلا المجتمعين إلى الشيخوخة.
ومنذ مباشرته لهذا التخصص غير المريح وعديم الأفق أدرك هذا الطبيب أنّ عليه "أن يقابل مرضى مضطرين إلى أن يواجهوا حقائق الانحدار الأخير وحقائق الموت" [ص: 13]. لم يعد الطب ترياقاً للحياة وإنما أضحى في موقع من يدير أمراضاً متراكمة لا سبيل إلى علاجها ولا أمل في شفائها. وفي صفحة من كتابه يعدد لنا هذه الأمراض التي استقرت في جسد رجل تسعيني "السرطان، أورام الرئة، انكماش في العمود الفقري، شلل في بعض الأطراف، وأمام هذا الوضع كان خيار الطبيب خياراً محدوداً، إما أن يجري عملية لاستئصال السرطان، وهي عملية معقدة وخطيرة ويمكن أن تودي بحياته، وإما أن يعالج أعراض السرطان مع أن لهذا العلاج مضاعفات خطيرة وهي: "الشلل الكامل والجلطة الدماغية" [ص: 15] فليس أمام الطبيب بدائل أخرى وقد اختار الخيار الأول لأنه سمع الرجل التسعيني يهمس له "لا تيأسوا من حياتي امنحوني كل فرصة متاحة من الحياة" [ص: 15].

إن الطبيب أتول غواندي قد استخدم كل معارفه من أجل إنقاذ حياة هذا الرجل، ولكن الحقيقة اليقينية التي لم تنفك تلازمه هي في أن للطب حدوداً لا يمكن أن يتخطاها، وأن هذه الحدود تتزامن مع إيمان الناس بأن للطب معجزات، وقد وقفوا عند البعض منها ويتداولون بعضاً منها فيما بينهم. ولكن في طب الشيخوخة وطب نهاية العمر يبدو واقع الطب مختلفاً لأن "سحب أنبوب التنفس وسمع دقات قلب المريض تخفت حتى التلاشي" [ص: 16]. تغدو من بين الوقائع المتكررة التي يتوجب على الطبيب التعاطي معها فلا مراء من أنّ الطب قد خلق لإنقاذ حياة البشر، ولكن السؤال "كيف نموت" [ص: 18]. هو سؤال قد غدا في قلب الطب وطب الشيخوخة بوجه خاص، وهذا السؤال طبي ولا يخلو من أبعاد فلسفية لأن "للحياة وجهاً مأساوياً لا فكاك منه" [ص: 19]؛ ولأن الطب يتعاطى مع مرضى لا أمل في شفائهم، وهم يسيرون بطريقة محتومة إلى نهايتهم دون أن يقدر الطب على أن يهب لهم بصيصاً من الحياة.
يرصد الطبيب أتول غواندي تغير نظرة المجتمعات إلى الشيخوخة فقد كان شاهداً على وضعيتين ورؤيتين إلى الهرم والشيخوخة: الأولى في الهند لما كان صبياً، والثانية في أمريكا لما استقر بها للعمل، في الأولى يحظى كبار السن بمنزلة اعتبارية كبرى وتتضاعف منزلتهم في المجتمع، أما الثانية في أمريكا حيث ينبذ الشيوخ في معازل ومشاف يمضون فيها آخر أعمارهم لأن "الشيخوخة في أمريكا مسألة شخصية بشكل ما يعانيها العجوز وحده إلى حد كبير في مراكز العناية بالمسنين" [ص: 28].
هل الشيخوخة مرض؟ يجيب الطبيب الأمريكي: "كلاّ، لأن الشيخوخة ليست تشخيصاً طبياً" [ص:40]، ومع ذلك فإن الطب يجتهد ويبدع ما من شأنه أن يحسن الظروف الصحية لكبار السن من دون انتظار "معجزة طبية"؛ إذ إنّ الانحدار البطيء للجسم انحدار محتوم ويلاحظ الطبيب بحسب المعطيات الاكلينيكية المتوفرة لديه بيسر أنّ وظائف الجسم الرئيسية تبدأ في الضمور: السمع، البصر، المشي، انحناء الظهر، بل إن الطب استطاع أن يخمن ما تبقى للإنسان من عمره فقط من خلال دراسة التغييرات الطارئة على الأسنان سواء في تغير ألوانها، وفي التهاب اللثة "وانحسارها عن الأسنان بما يجعلها أقل ثباتاً ويعطي شكلاً أطول من شكلها الماضي" [ص: 42].
ويعمد الطبيب الأمريكي ذو الأصل الهندي إلى توصيف كامل لمفهوم الشيخوخة وتجلياتها الطبية، ويشير إلى أن مقاومة الأمراض تبدو أمراً صعباً أمام هذا الجسد الذي استهلك طاقاته، ويذكر في هذا المقام جزئية مهمة "ففي نحو سن الأربعين يبدأ الفرد يخسر من كتلة العضل وقوته وبحلول الثمانين يكون الفرد قد خسر ما بين ربع ونصف وزن العضل لديه" [ص: 43]، وأمام اكتساح الأمراض لهذا الجسد بنوع من الحتمية البيولوجية لم يستنكف الطبيب عن مسائلة المجتمع ومسائلة نفسه في ذات الحين "لماذا نشيخ"؟ وهل يمكن تمديد حقبة الكهولة لتكون بديلاً عن الشيخوخة، سيما وأن هناك تجارب جرت على الفئران وبعض الحشرات تم بموجبها تمديد حياتها الفعلية إلى الضعف.
إن الإجابة عن هذه الهواجس لا تخلو من إيطوبيا –على الأقل في اللحظة الراهنة–؛ لأن هذا الجسد قد تداعت عليه كل العطوب من كل جهة وبصورة متزامنة مما جعل شفاءه منها مهمة مستحيلة، ولكن ما هو مؤكد من جهة ثانية "أنّ الطب قد ساعد على إطالة أعمارنا" [ص: 49]، وهذا ما نلاحظه بالعين المجردة وإن أدى ذلك إلى قلب البنية الهرمية لبعض المجتمعات الغربية التي أصبحت بنية لا هرمية، بحيث أمسى عدد الشيوخ فيها مماثلا أو حتى أكبر من عدد الأطفال. وهذه التغيرات في الديموغرافيا قد خلقت ضغطاً جديداً على طب الشيخوخة في ظل عزوف الأطباء عن مباشرة هذا التخصص "لكونهم لا يحبون العناية بالمسنين" [ص: 50].
ولكن لماذا يعزف الأطباء عن مباشرة هذا التخصص؟ لننصت إلى أحد منهم يقول: "إنّ عموم الأطباء يتجنبون طب الشيخوخة والسبب في هذا أنهم لا يملكون القدرات اللازمة للتعامل مع الكبير العاجز فهذا المسن أصم، وهذا المسن ضعيف الرؤية وذاكرته قد تكون واهنة إلى حد ما، وحينما تكون مع الكبير المسن تشعر بأنه يعرقل عملك لأنه يعيد السؤال عما قلته وكبير السن لا يواجهك بمشكلته الرئيسية فقط بل يفاجئك بخمس عشرة شكوى كلها رئيسية. فبالله عليك كيف ستتعامل مع كل شكواه" [ص: 50]. وقد تولد يقين لدى جموع الأطباء في "أن دور الطبيب في أن يحافظ على جودة الحياة" [ص: 55] هذه الجودة الآخذة في التآكل لدى المسنين، بل إنّ هذا الطبيب يظل مشدوداً إلى الموت الذي سيقرع باب حرفائه قريباً وبالتأكيد سيكون هو في طليعة المؤبنين والمعزين؛ لأنه أضحى جزءاً من المشهد الأخير لحياة مرضاه.
ابتكر المجتمع الأهلي الأمريكي ما يسمى بــ"مدينة المتقاعدين"، وكان ذلك أوائل سنة 1960 بعد أن لوحظ أن أغلب المسنين في أمريكا يعيشون منفردين وينهي بعضهم حياته على نحو مأساوي كان لا يتفطن إلى موتهم إلا بعد أيام تكون فيها الجثة قد تحللت، ويكون الجيران قد تسربت إلى خياشيمهم الرائحة النتنة للجثة المتعفنة، ويكتمل المشهد عادة باستدعاء رجال المطافئ وتحطيمهم للباب الخارجي لإخراج الجثة ثم مواراتها التراب كما لو كان مجهول الهوية. وقد بوشر في أعمار مدينة المتقاعدين ولكن العقل الرأسمالي لم يتسامح كثيراً مع الدور الاجتماعي الذي تنهض به مدينة المتقاعدين (وسميت مدينة الشمس، صن سيتي)، وذلك عبر إثارة التمويلات الثقيلة التي تتطلبها مدن هكذا، فلم نعد نرى دراسات في الجدوى الاجتماعية لهذه المدن وإنما في تكاليف آلة منظم ضربات القلب، أو تكاليف تركيب شبكة للشريان التاجي وثمن مقاوم الوهن الآلي" [ص: 59]، وغير ذلك من الأجهزة التي تتطلب تمويلات ضخمة استكثرتها شركات التأمين مما جعل هذه المدن الخاصة بالمسنين تقفل الواحدة تلو الأخرى "لأن العمل في هذا المجال أصبح صعباً بشكل لا يحتمل من الناحية الاقتصادية" [ص: 60].
ويرى الطبيب غواندي بشيء من المرارة أن موضوع الشيخوخة أضحى موضوعاً لبيزنيس كبير، لا يخضع إلا إلى لغة الأرقام والربح والخسارة بغض النظر عما يجب أن يسدى لهذا الشيخ المسن، الذي قدم فيما مضى خدمات جليلة للمجتمع. وهذا البيزنيس يصنف المسنين ما بين مقتدرين وعاجزين فالمقتدر منهم باستطاعته أن يدفع ما قيمته 23 ألف دولار سنوياً قيمة الإيجار إضافة إلى رسوم الدخول وتقدر ب 60 ألف دولار. أما السواد الأعظم من المسنين في المجتمع الأمريكي فإنهم يعيشون منفردين ومحرومين من الرعاية الطبية الملائمة في ظل شبه عزلة عن المجتمع والحياة، وإذا ما قدر لهم أن يعيشوا في مآو معدة للغرض فبطريقة لا تليق بآدمية الإنسان.
نظرة المجتمع الأمريكي إلى الشيخوخة
في هذا الكتاب لا تقتصر المادة المقروءة على إيراد قصص المسنين وسردياتهم على لسان الطبيب الذي يباشر علاجهم في اللحظات الأخيرة من عمرهم؛ وإنما نكتشف من خلال مواده المختلفة نظرة المجتمع الغربي والأمريكي بوجه خاص إلى حقبة الشيخوخة، وهي حقبة ينبذها هذا المجتمع كما لو أنها لا تليق به؛ لأنها تنزع عن الإنسان قدراته وسلطاته في مجتمع لا يعلو فيه إلا صوت المال والأعمال. ويضمن الطبيب قولة لأحد أبرز كتاب أمريكا وهو فيليب روث وهي: "الشيخوخة ليست معركة بل هي مذبحة" [ص: 71] تخلف مصابين لا أمل في برئهم، وعجزة لا رجاء في نهوضهم مجدداً إلى عالم المال والأعمال، فيبدون في هذا المجتمع كما لو كانوا عالة أو عبئاً على اقتصادياته وعلى شركات التامين لديه. وهذا المجتمع قد حدد ملامح الشيخوخة ضمن أعراف تلقى الإجماع لديه من النخب أو من عامة الناس أهمها العجز عن أداء الوظائف الثمانية التي بها تستقيم الأمور ويمكن أن نذكرها: "عدم القدرة على الذهاب لاشتراء الحاجيات من دون مساعدة، إعداد الطعام، الاعتناء بالبيت، غسل الثياب، ضبط الأدوية وتناولها، الاتصال بالهاتف، السفر، ضبط التعامل بالنقود" [ص: 24].
إضافة إلى العجز عن قيادة السيارة بكل ما تعنيه "السيارة من حرية" [ص: 71] في المجتمع الأمريكي، وإذا ما اجتمعت هذه النقائص في شخص ما فإن ذلك يكون إيذاناً بقرب دخوله المأوى الخيري، وهو مأوى تشرف عليه الكنيسة منذ قرون، وهو مؤسسة دينية قديمة قدم الكنيسة ذاتها، ومع ذلك لم تدخل أنشطتها ضمن الاستراتيجيات الاجتماعية للدولة الأمريكية بل بقيت محكومة بالعمل الخيري وبإحسان المحسنين، الذين مهما كانت هباتهم فإنهم لا يستطيعون مجاراة تفاقم حاجات المسنين إلى الرعاية والتطبيب.
إنّ هذا المأوى أضحى مع الزمن مكاناً لاحتجاز المسنين والمرضى والعجزة أكثر منه للتداوي وللأمل، وأضحي في ذاكرة الأمريكيين مكاناً لامتهان آدمية الإنسان والحط من كرامته إلى درجة أن إحدى التقارير الصادرة سنة 1912 قد ورد فيها: "أنه لا يصلح حتى لأن تحيا فيه الحيوانات حياة مقبولة" [ص:80]، وهذا ما خلق نفوراً لدى المسنين الأمريكيين الذين لم يعد أمامهم خيار مناسب في حقيقة الأمر، إما اللجوء إلى مثل هذه المآوي والفضاءات، أو المكوث في منازلهم في وحدة قاتلة وبانتظار لحظة الموت المباغتة.
في مآوي العجز تغيب شروط العيش الكريم في دولة مثل أمريكا إذ يتعاطى مع المسنين كأنهم جثث هامدة، ليس لأن جهاز التمريض والتطبيب لا يملك الحد الأدنى من المشاعر الإنسانية في الرحمة، بل لأن في هذه المعازل ذاكرة سيئة ففيها يستشعر المواطن الأمريكي الغربة والاغتراب، ويسرد لنا الطبيب أتول غواندي حالة الأمريكية إليس في اليوم الأول لدخولها إلى هذا الفضاء "لا شك أن إليس شعرت كأنها دخلت في عالم الغرباء، حيث لن يسمح لها بالخروج منه أبداً" [ص:85]، كما أن كبار السن يعاملون معاملة الأطفال القاصرين فضلاً عن غياب الخصوصية والحميمية، ما يوحي أن هذه الفضاءات قريبة في طريقة عملها وفي مناخها العام بالسجون والمعتقلات إذ إنّ كل التفاصيل: الأكل، النظافة، التوقيت خاضع لنظام صارم ونهائي.
إن الطبيب "أتول غواندي" يسمي الأشياء بأسمائها ويصف مثل هذه الفضاءات "بالمكان المرعب" [ص: 95]، الذي يكشف لنا مآسي المسنين في مجتمع يبدو وكأنه يستحث الخطى لرحيلهم والتخلص منهم بقدر ضئيل أو معدوم من الإحساس بالكرامة البشرية، وهو يلقي باللائمة على نمط تطور المجتمع الأمريكي "فهذه إذن نتيجة تطور المجتمع إلى حالة صار الفرد فيها يواجه آخر مرحلة من مراحل الحياة البشرية" [ص: 95] بل ويتهم هذه المؤسسات التي "لا تهتم أبداً بالهدف الذي له قيمة لدى الناس الذين يعيشون فيها كيف تكون حياتهم "في فترة يكون فيها المرء ضعيفاً واهناً ولم يعد يملك شيئاً يدفع به عن نفسه" [ص:95].
باتت الحقيقة الوحيدة لمآوي العجزة في أمريكا وفي الغرب هي حقيقة انتظار الموت على إيقاع الإحساس المر بالغربة فالنزلاء "جاهزون للموت" [ص: 96]، و"لم يعد بعضهم مهتماً بأن يضغط على زر النداء" [ص: 96] طلباً للإسعاف أو ما شابه. وفي تلك اللحظة الدرامية يسدل الستار على المسنين غير مأسوف عليهم في المجتمع الأمريكي.
أمكنة التثاقف الطبي
هل يمكن أن يكون مصدر المقاربات الطبية للشيخوخة في أمريكا من خارج أمريكا؟ ومن ثقافات أخرى وهبت للكبار في السن المنزلة اللائقة، وأن هذه المنزلة لم تتزحزح بفعل رياح الحداثة والتحديث؟
إن الطبيب أتول غواندي يدعو المجتمع الأمريكي إلى مراجعة نظره في الأسرة، التي يعتبرها البديل الحقيقي والأمن والمشرف لبيوت التمريض المخصصة للكبار في المشافي والمعازل، وفي دور الشيخوخة... وقد تبدو هذه الدعوة غير براغماتية لأنه يفترض أن تكون الأسرة وفيرة العدد، ومع ذلك يمضي هذا الطبيب في فكرته ويخلص إلى نتيجة وهي أنه بقدر ما يكون عدد الأبناء كبيراً تكون العناية بالكبار أشمل وأيسر وأقل كلفة ووطأة. إن هذه المقاربة المستمدة من الهند مسقط رأس الطبيب قد لا تلائم المجتمع الأمريكي المأخوذ دوماً بقيم عالم المال والأعمال؛ لأن "مختلف مختلف الأجيال صاروا يفضلون العيش مستقلين بعضهم عن بعض" [ص: 101]، وفي المرات النادرة التي ظل فيها المسن في منزله فإن المحيطين به يرونه عبئاً ثقيلاً عليهم وعلى أوقاتهم التي لا تتحمل وجود رجل عاجز فيما بينهم.
وفي ظل استحالة التثاقف مع مثل هذا التمشي الصادر عن الثقافة الهندية، فإن أفكاراً جديدة بدأت ترى النور من أجل الأخذ بالمسنين في آخر حياتهم أهمها ما أطلق عليه "مركز المعيشة المدعومة بالمساعدة" سنة 1983 ببورتلاند، وينهض هذا المشروع على اعتبار النزلاء مستأجرين لشقق معدة للغرض تتوفر فيها كل الأساسيات، بل ويستطيع المسن اختيار السجاد والمفروشات وهو "أيضاً يتحكم في الحرارة وفي الطعام ومن يدخل المنزل ومن يخرج..." [ص: 109]، وقد تأكد أن لهذا المشروع فضائل كبرى على المسنين الذين "لم يخسروا في الحقيقة من صحتهم مقابل حريتهم" [ص: 111].
إن هذه التجربة وعلى الرغم من إنسانيتها ونجاعتها لم تلق النجاح المطلوب، وذلك للتكلفة الغالية التي تتطلبها ولأنها في الأصل أنشئت لذوي الدخل المنخفض مما عجل من اندثارها واندثار منظومة "بيوت المعيشة المدعومة"، وهذا ما حتم على المسننين في أمريكا العودة إلى خدمات بيوت التمريض والمعازل الكلاسيكية التي لا أفق لها سوى الموت، والأغرب من ذلك كله أن المرأة التي أسهمت في تأسيس هذه المنظومة وهي "كيري ويلسون" قد أرغمت على الاستقالة بضغط من الدوائر المالية التابعة لبورصة وول ستريت، فقد "انتهى بها المطاف في العام 2000 إلى أنها استقالت من وظيفتها رئاسة المجلس التنفيذي، وباعت كل أسهمها في الشركة التي كانت هي من أنشأها" [ص: 123].
إن مصير المسنين في المجتمع الأمريكي هو دور العجزة وليس في بيوتهم، إذ لا أحد يستطيع أن ينهض بأعبائهم أو أن يقوم بأمرهم، وعلى امتداد صفحات هذا الكتاب لا يكف الطبيب أتول غواندي عن عقد المقارنات بين وضعية المسن في الهند –بلده الأصلي– وبين الوضعية في أمريكا –البلد الذي استقر فيه منذ أكثر من خمسين سنة– ففي الهند تكون رعاية المسن واجباً يناط بالأسرة كلها؛ لأنه هو محورها ونواتها، أما في أمريكا "فالأبناء والبنات هم الذين يتخذون في العادة القرار بشأن المكان الذي سيعيش فيه المسن" [ص: 126]، وهذا المكان لن يكون أبداً أحد منازلهم.
والواقع أن المبادرات الكفيلة بإخراج المسنين من أوضاعهم المزرية لا يمكن أن تنشأ إلا من الأطباء، وهذه المبادرات فردية لا تدعمها الحكومات الأمريكية، ومع ذلك فإنها توفر أمكنة حقيقية للتخلص من الوجود البائس في دور العجزة أو في وحدات التمريض. وفي هذا المقام يذكر لنا الطبيب أتول غواندي مبادرة طبيب أمريكي هو بيل توماس الذي "كان شغوفاً بالطب شغفه بالزراعة، وقد توقدت في ذهنه فكرة لامعة سعى إلى تطبيقها على أرض الواقع وهي: "ماذا لو أدخل إلى حياة هؤلاء النزلاء بعض النباتات والحيوانات والأطفال"؟ [ص: 136].
الطبيب –في مثل هذه المواقف– هو الذي يفكر ويأخذ المبادرة وينجز على أرض الواقع، ولأجل ذلك سعى الطبيب بيل توماس إلى القضاء على المصائب الثلاثة للمسنين وهي: "الملل والشعور بالعزلة، والعجز عن عمل أي شيء" [ص: 137]، فهذا الطبيب المجدد المبدع لم يقتصر دوره على العلاج الجسدي/ النفسي للمسنين؛ وإنما اشتغل بطريقة إبداعية على تجويد نظام حياة هذه الفئة التي تزداد –في النظام الهرمي للسكان– اتساعاً وأول ما فعله هو في أن يأتي بمائة طائر وبكلبين وقطط، وكان يقول دوماً: "... ولكن ألا تستحق الفكرة التجريب"؟ [ص: 135]، كما كان يقول عن نفسه قولة مأثورة في العقلية الأمريكية، وهي: "أحب أن أفكر خارج الصندوق... أوت أوف ذي بوكس" [ص: 139]، وهي عبارة تشي بروح المبادرة والمغامرة والاكتشاف خارج القواعد المتعارف عليها والدروب المسطورة.
كانت لهذه التجربة الفريدة الأثر الجميل على حياة النزلاء "فقد عاد البريق إلى عيونهم" [ص: 143]، وهناك من المسنين من تبدلت سلوكياتهم ودبت الحياة في وجودهم من جديد "فالأفراد الذين كنا نعتقد أنهم غير قادرين على الكلام بدأوا يتكلمون... وكل طيور البركيت (نوع من الطيور) تبناها النزلاء وأطلقوا عليها أسماء" [ص: 143]، أما عن أهم نتيجة طبية تولدت عن هذا المشروع الذي نهض به الطبيب ويل توماس فهي: "إن حاجة كل نزيل إلى الأدوية قد هبطت إلى النصف وبشكل خاص الأدوية النفسية الخاصة بالتهيج، وهبطت التكلفة العامة للأدوية إلى 38 بالمائة عن المراكز الأخرى، كما هبطت نسبة الوفيات إلى 15 بالمائة" [ص: 144].
نستطيع القول إن الطبيب هو حكيم المدينة حقاً، وهو يستعيد دوره القديم كما كان ينظر إليه في الحضارات اليونانية والإسلامية، فهو وسيط مهم لإعطاء الحياة معنى خاصة لدى أولئك الذين انسدت أمامهم أمكنة العيش الكريم، فقد أيقن أنه "بالإمكان تزويد هؤلاء المرضى المسنين بسبب يعيشون من أجله" [ص: 146]، فلم تعد بقية الحياة عبثية ولا فصلاً اكتئابياً ختامياً ولا انتظاراً متعجلا للحظة الموت والفراق وإنما "غنية بالمعاني والسعادة والرضا" [ص: 146]، وهذا هو روح هذه التجربة الفريدة التي نهض بها الطبيب الأمريكي ويل توماس.
إن الطبيب الأمريكي ذا الأصل الهندي أتول غواندي يرى أن الشيخوخة لا تبتعد كثيراً عن الجائحة التي تصيب الأمم، ولذلك وجب وضع المخططات والاستراتيجيات والتمويلات لحسن إدارتها والتعاطي معها، كما أنه يجد شغفاً ومتعة في رواية السرديات الجميلة لبعض الأطباء ممن فكروا "خارج الصندوق" من أجل أن يهبوا للشيوخ معنى في أواخر حياتهم، وذلك ليس لأجل مجد شخصي أو لكي يكونوا يوماً ما في صميم الميديا أو وجوهاً إعلامية معروفة، وإنما لأن الإنسان هو هاجسهم الأول في مجتمع مثل المجتمع الأمريكي، الذي تغلغلت فيه القيم الرأسمالية على نحو أشاع القسوة وانعدام الرحمة على أكثر الفئات ضعفاً وهشاشة.

الطب وسؤال الأوتانازيا (القتل الرحيم)
نأتي الآن إلى السؤال المركزي الذي ينهض عليه كتاب "لأن الإنسان فان"، وهو هل يحق للطبيب والطب أن يتعنتا من أجل إطالة عمر المريض الذي يئس من برئه؟ فالطبيب يسرد لنا في النصف الثاني من الكتاب نماذج وقصصاً لمرضى لم يعد الشفاء من عللهم أمراً منتظراً أو مأمولاً. وفي هذا المقام يستوي المريض ذو الثلاثين عاماً بالسرطان مع المريض في التسعين المصاب بالخرف "الزهايمر"، وبكل الأمراض الأخرى. وفي هذه السرديات يؤكد الطبيب أن العلاج ذاته أصبح نوعاً من العذاب، ولكنه عذاب يمارس باسم الطب وباسم علاج وهمي. ولكي يكون لكلامه بعداً تجريبياً عمد إلى رسم "صورة المريض النمطي" [ص: 176] وهي الصورة التي أضحى معها جسده موصولا "بأنابيب طول بعضها عشرة أمتار" [ص: 180] وتكاثرت فيه الفتحات والشقوق بما يجعله عاجزاً عن الاستجابة إلى كل فرص العلاج، ويتولد عن هذا الوضع الذي يبدو فيه الطبيب ملامساً للموت ومجاوراً للجسد والفكر للحظة النهاية، يتولد سؤال هو: "في إمكانية أن يفتح موضوع نهاية المرضى معهم قبل فوات الأوان" [ص: 177]، وما يقصده بـ"فوات الأوان " هو أن يكون للمريض قدرة باقية في التفكير وأخذ القرار في الطريقة التي يحب أن ينهي بها حياته. فمن واقع خبرة هذا الطبيب فإن هناك مسارين لمن لا يرجى برؤه أبداً: إما أن يكون مجيء الوفاة أبطأ ولكنه أرهب" [ص: 179] أي مقترناً بأوجاع نفض الطب يده منها، أو أن "يكون مجيء الوفاة أسرع ولكنه أخف" [ص: 179]، وفي هذه الحالة لا يدعو الطبيب إلى التخلص منه بطريقة الأوتانازيا Euthanasia كما هو في سويسره أو بلجيكا؛ وإنما "يترك الطبيعة تقوم بعملها" [ص: 179]، ومعنى هذه العبارة الملغزة والحاملة لأكثر من معنى ألا يقع الجسد قسراً تحت رحمة الأنابيب والأدوية والمضادات ففي بعض الحالات، من بينها السرطان في المرحلة الرابعة وحالة الشيخوخة الشديدة يكون الموت مؤكداً "ولكن توقيته لا يكون كذلك" [ص: 179].
المسألة ليست قانونية أي أن يمضي المريض –أو من ينوبه– في وثيقة تفيد تقبله لكل النتائج، بل هي مسألة تتصل بالضمير، بضمير الطبيب الذي كان أول درس يتلقاه في الجامعة هو في أن يهب العلاج والحياة لا أن يدفع باتجاه الموت أو أن يفكر فيه ولكن مع اليأس من الشفاء، يبدو الطبيب أتول غواندي منفتحاً على تفكير لا يراه منافياً لأخلاقيات الطب "الديونتولوجيا Deontology" ويتمثل في عبارة موجزة ولكنها تختزل المعنى وهي: "أن نترك الطبيعة تعمل عملها" [ص: 198]، وفي ظل هذه العبارة يكون التفكير في الموت خياراً من الخيارات الماثلة أمام الطبيب ولكن الكاتب يميز بوضوح وبدقة بين "ترك الطبيعة تعمل عملها" وبين ما يسمى بالموت الرحيم.
وإذا ما أصبح الموت مفكراً فيه فهل يمكن أن يكون هذا التفكير متنزلا في مؤسسات تحميها القوانين وتباشر مهامها في رفقة المرضى إلى نهاياتهم بالقوانين ذاتها؟
في أمريكا نشأت خدمة "الهوسبيس" وهي خدمة يديرها نظام المستشفى مخصصة لغرض واحد وهو "توفير الراحة للمرضى الذين تبين أنه لا شفاء لهم" [ص: 180] وعبارة "توفير الراحة" تشي بأن الموت قد أضحى فعلاً من بين الخيارات الممكنة التي يجب أن يكون مفكراً فيها من قبل الأطراف الثلاثة وهي: المريض أو من ينوبه في حالة العجز الكلي عن اتخاذ القرار، والأسرة التي ينتسب إليها، والطبيب الذي هو همزة الوصل، والقناة التي ستسمح بالخطاب الضمني "لتوفير الراحة "أن يجد صداه بين الطرفين.
إن في نظرية الطبيب أتول غواندي ما يشير إلى أن نداء الموت هو في بعض الأحيان نداء الرحمة وليس إعلاناً لفشل عمليات التداوي أو لنقص في كفاءة الطبيب، فما يطمح إليه هو ألا يرى "الموت والعلاج الكيمياوي يضخ في أوردتنا" [ص: 197]، أو "الموت وأنبوبه قد أدخل في حلوقنا" [ص: 197]، أو "الموت وآثار غرز الجراحة طرية في لحم المريض" [ص: 197]، وما إلى ذلك من المشاهد التي تثير القشعريرة.
ولكن هل إن نداء الموت الرحيم بالمعنى الذي يقترحه لنا أتول غواندي هو نداء تقني فحسب؟ أم إنّه وثيق الصلة بالأبعاد الروحانية والإيمانية للأفراد وللمجتمعات؟
إن تجربة الطبيب أتول غواندي قد أفادت بأن تجربة "هوسبيس Hospice" هي تجربة كونية "لأن برامج الهوسبيس بدأت تنتشر في كل مكان، من كامبالا إلى كينشاسا، ومن لاغوس إلى ليسوتو، ومن بومباي إلى مانيلا" [ص: 216]، فنظام الهوسبيس بحكم أنه لا ينهك كاهل المريض بالعلاج قد جعل من وفاة الناس في منازلهم ومحاطين بذويهم أمراً أكثر إمكانية، فهم لا يموتون كالغرباء في المستشفيات ولا توضع على جثامينهم أرقام ومعطيات جافة وإنما حوفظ على حميميتهم وخصوصياتهم، واستعاد هذا النظام روح العلاقات الأسرية الراسخة منذ القدم، والتي قضت عليها الحداثة قضاء مبرماً في أمريكا وغيرها من الدول الغربية.
إن المقاربة التي يقترحها الطبيب أتول غواندي قد ثبتت نجاعتها وتجريبيتها في كل أصقاع العالم، ولم يعد مطروحاً أمام الطبيب أن ينتهك جسد المريض أيا كانت التعلات والمسميات، فالمطلوب هو أن يساير الطبيب المريض الذي أعلن عن استحالة برئه وأن تكون هذه المسايرة في الأغلب في بيت المريض.
صورة جديدة للطبيب
يميز الطبيب الأمريكي الهندي الأصل أتول غواندي بين أنواع ثلاثة من الأطباء: الأول أن يكون الطبيب نموذجاً "الطبيب أدرى بالأمر" [ص: 224] وهو النموذج الذي كان سائداً لقرون ويصفه الكاتب بأنه "نموذج الأب الكنسي"، الذي هو وحده دون غيره الذي يعرف حقيقة المرض والشفاء.
النموذج الثاني: هو "الطبيب المعلوماتي" [ص: 225]، وهو الذي يشرك المريض بنسب معلومة في أخذ القرار أمام البدائل الصعبة.
النموذج الثالث: "الطبيب التفسيري" [ص: 226]، وتقوم فلسفته على سؤال الطبيب للمريض "ما الذي ترى أنه الأهم عندك" [ص: 226]، ويعمد إلى وضع البدائل أمام المريض الذي إليه سيؤول الاختيار خاصة إن كان الأمر متصلاً بواقع تكون فيه نسب الحياة والموت متساوية.
ويبدو أنّ "الطبيب التفسيري" هو النموذج الأمثل؛ لأنه يتضمن كل شيء بما في ذلك "إعلام المرضى أخباراً سيئة" [ص: 232] وبما في ذلك التهيؤ لإيقاف كل الأجهزة التقنية والعلاجات الكيمياوية، بل وبرمجة "كل الشعائر المتصلة بالموت والدفن" [ص: 234] مع ما يترافق مع ذلك من أجواء روحانية تستمد من إيمان المريض بما يؤمن به.
إنّ الطبيب التفسيري لا يبيع أوهام العلاج والشفاء بل يضع الحقائق أمام الأنظار، ويفسر للمرضى حيثياتها وتفاصيلها ليساعده على أخذ القرار الصائب فأمام وضعيات الشلل الرباعي لا يعود العلاج الكيمياوي ذا جدوى، بل التعايش مع العجز انتظاراً للحظة الصفر التي لا مهرب منها من دون إنهاك الجسد.
إنّ الطبيب أتول غواندي لا ينكر أن مثل هذه القرارات تتطلب شجاعة فائقة وتحلياً بخصال الصدق والصراحة، التي هي خصال مطلوبة في المجال الطبي بدون أدنى شك.
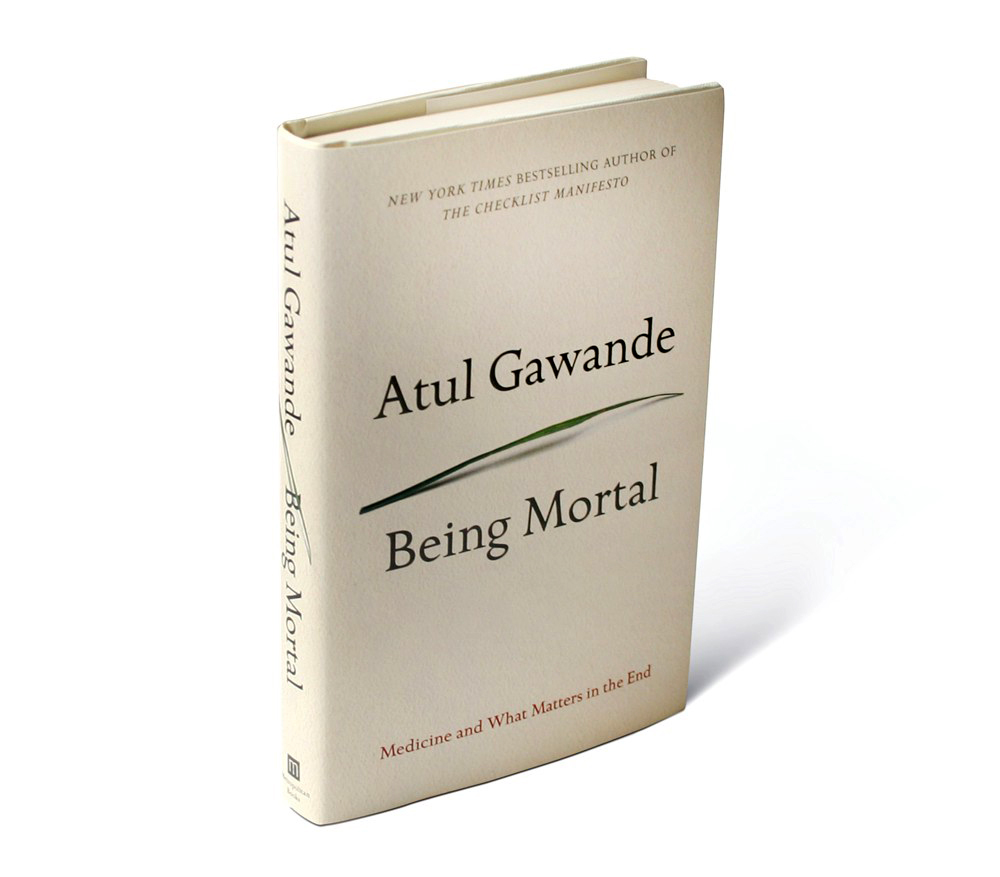
إنّ هذا الكتاب تفكير عميق في منزلة الطب والطبيب في حياتنا المعاصرة، فهو لا ينظر إلى المريض نظرة فنية فحسب، خاصة لمن هم على وشك الرحيل؛ وإنما نظرة مشبعة بالقيم الإنسانية، نظرة ترى في الطب باباً مهماً للحياة ولتجويد أساليب العيش مثلما ترى أنّ الموت جزء لا يتجزأ من المتخيل الطبي وليس أمراً غريباً عنه أو في نشاز معه.