حاوره: أمير علي مالكي

بيتر أدامسون Peter Adamson أستاذ الفلسفة القديمة والعربية المتأخرة في لودفيج ماكسيميليان جامعة ميونيخ LMU، وكاتب عمود مجلة الفلسفة الآن. يتحدث معه أمير علي مالكي Amirali Maleki عن الفلسفة الإسلامية.
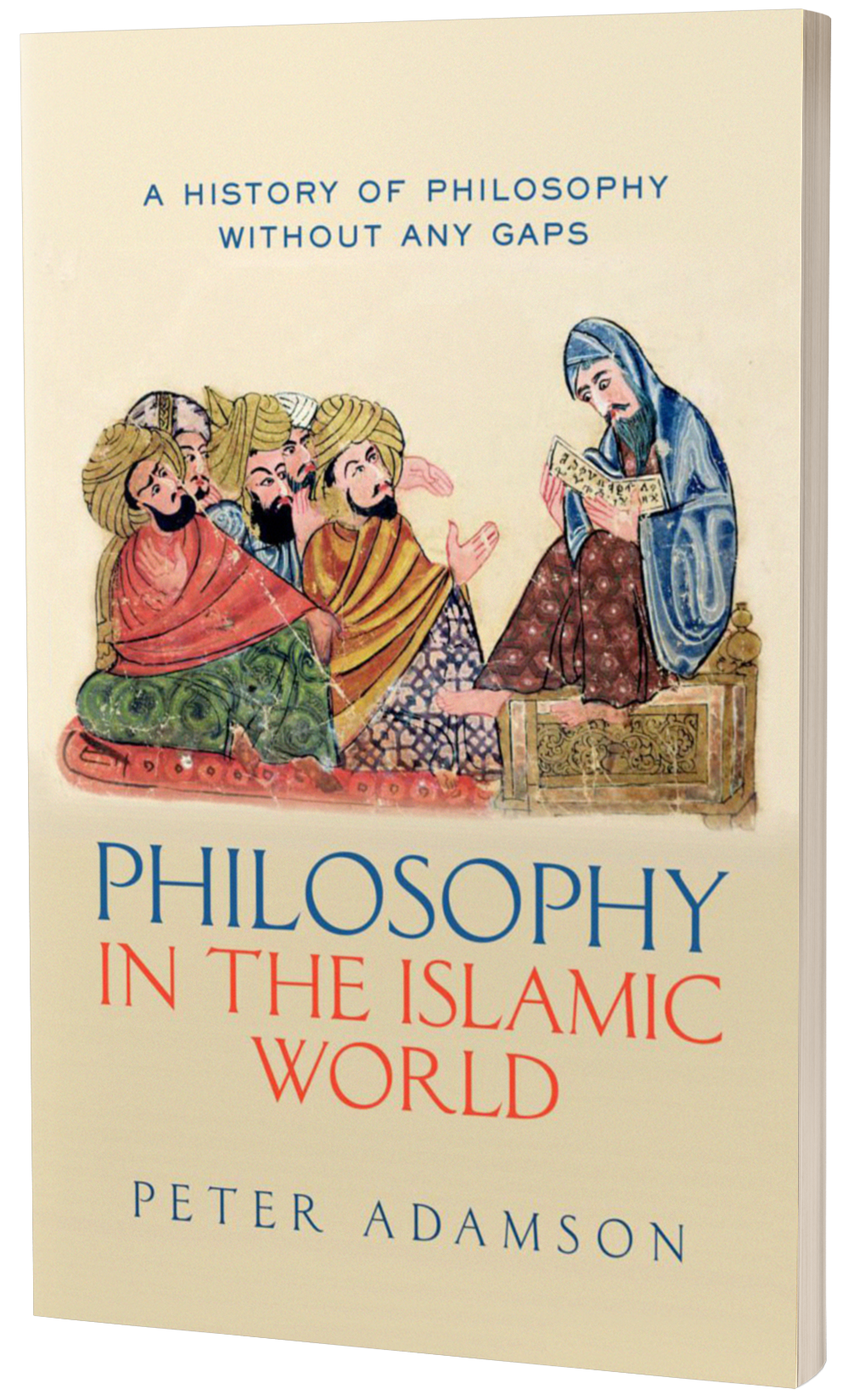
✧ هل كان هدفك الرئيس في شرح الفلسفة الإسلامية بلغة بسيطة للفلسفة في العالم الإسلامي [تاريخ الفلسفة بدون أي تجاوزات A history of philosophy without any gaps, Vol 3] هو تعميمها؟ أم أنك تريد الوصول أيضاً إلى الأكاديميين؟
لقد تمت كتابة هذا الكتاب إلى حد كبير إلى عامة الناس، على الرغم من أنني أعتقد أن النهج الشامل الذي اتخذه يعني أنه ينبغي أيضاً أن يكون مفيداً للمتخصصين، على وجه الخصوص. أود أن يأخذ الأكاديميون الآخرون بعض جوانب ما أقوم به في هذا الكتاب، مثل دمج دراسة الفلسفة اليهودية في مفهوم الفلسفة في العالم الإسلامي، وإيلاء المزيد من الاهتمام لـفكر "ما بعد الكلاسيكية" وبالأساس، كل ما حدث بعد القرن الثاني عشر الميلادي.
✦ لماذا تعتقد أن الفلسفة الإسلامية قد أهملت على مر التاريخ الحديث؟
بالطبع لم يتم إهمالها في كل مكان؛ ففي البلدان الإسلامية كان هناك اهتمام بالتقاليد الفلسفية السابقة. لكن في أوروبا كان هناك ميل لتقدير فقط بعض الشخصيات التي تُرجمت إلى اللاتينية في العصور الوسطى، مثل ابن سينا وابن رشد، بسبب تأثيرها على الفلسفة الأوروبية. لم يُترجَم الفلاسفة المهمون الذين جاءوا فيما بعد، مثل فخر الدين الرازي أو ملا صدرا (محمد بن إبراهيم القوامي الشيرازي)، إلى اللغة الأوروبية؛ لذلك ظلوا غير معروفين إلى حد ما بالنسبة للباحثين المشتغلين بهذه اللغات.
✧ هل تعتقد أن فلسفات العديد من الثقافات لم يتم دمجها في تاريخ الفلسفة في الغرب؟ أم أن الفلسفة الإسلامية تقدم هنا على أساس أنها "فلسفة العالم/عالمية" إلى جانب الفكر الصيني والبوذي والهندي؟
نعم؛ هذا صحيح، ما يزال هناك اتجاه في أوروبا وأمريكا الشمالية يهتم بجمع كل التقاليد غير الأوروبية معاً في شيء واحد، يسمى "الفلسفة غير الغربية"، أو "الفلسفة العالمية"، أو "الفلسفة الكونية". بمعنى أنه ليس لدي أي اعتراض على هذا الأمر؛ لأنه يبدو لي خطوة مفيدة تَحثُ الناس على الاهتمام بهذه التقاليد الأخرى. لكن التعرف على الفلسفة الهندية ليس له أي صلة بالتعرف على الفلسفة الإفريقية أو أمريكا اللاتينية. كل ما نحتاجه حقاً هو منحة دراسية مخصصة لكل تقليد في حد ذاته، ويتم القيام بذلك بشكل متزايد ومتواصل. يعتبر وضع الفلسفة الإسلامية على وجه الخصوص أمراً غير عادي، لكونها غالباً ما يُنظر إليها على أنها تندرج تحت عنوان "الفلسفة غير الغربية"، على الرغم من أن تقاليدها تستجيب كثيراً للفلسفة الأوروبية، وخاصة لأرسطو، على عكس ما نجده في الهند أو الصين أو إفريقيا، أو الأمريكتين قبل الاستعمار.
✦ هل مصطلح "الفلسفة الغربية" له معنى حقاً؟ أم أنك تعتقد أن هذا المصطلح يذكرنا إلى حد ما بالعقلية الاستعمارية؟
إن المشكلة في هذه العبارة "الفلسفة الغربية" هي كونها غير واضحة لكل ما تتضمنه؛ فإذا كنت تفكر في الأمر على أساس التسمية الجغرافية، بمعنى أنه مهما كانت الفلسفة فقد حدثت في أوروبا -ولاحقًا في أمريكا الشمالية وغيرها من الدول "الغربية" الأخرى- فيجب أن تتضمن وتشمل حقاً الكثير من الفلسفة الإسلامية، وذلك ببساطة لأن المسلمين عمروا إسبانيا لفترة طويلة، وكتب هناك عدد من المفكرين المسلمين واليهود المهمين باللغة العربية. ومع ذلك، لا يعتبر هذا عادة جزءاً من الفكر "الغربي". ثم من ناحية أخرى، إذا كنت تعتقد أن الفلسفة "الغربية" تعني كل شيء يعود إلى الإغريق، فعليك حقاً تضمين شخصيات مثل ابن سينا، الذي عاش في الواقع في آسيا الوسطى، وهي منطقة تأثرت بشكل كبير بعد ذلك بالثقافة اليونانية الهيلينية.
✧ هل تؤمن برأي إرنست رينان فيما يتعلق بـ"إذلال" العلم في الفلسفة الإسلامية - رغم أن نبي الإسلام قال: "فضل العالم على العابد بسبعين درجة"، و"العلماء ورثة الأنبياء"؟
ترجع فكرة أن الوحي الإسلامي يدعو إلى الفلسفة أو العلم في واقع الأمر إلى فترة العصور الوسطى. وهذا ما يمكن أن نجده عند ابن رشد، على سبيل المثال. وبوجه عام، ليس هناك شك في أنه في الفترات الكلاسيكية والعصور الوسطى، كان هناك مجموعة من علماء المسلمين يعتقدون أن النظر العقلاني في العالم قد دعا إليه الإسلام. لكني سأحرص هنا على عدم افتراض وجود موقف واحد فقط داخل الإسلام. فعلى سبيل المثال، كان هناك أيضاً علماء دين لم يدعو إلى الاشتغال على المصادر العلمية الأجنبية، أو قالوا إن المعرفة التي نحتاجها هي موجودة في الوحي القرآني والسيرة النبوية. لذا؛ فهي تشكل صورة مركبة.
✦ كيف يبرر الفلاسفة المسلمون دراسة أفلاطون وأرسطو؟ تستشهد برد الكندي على النقاد الدينيين الذين اعترضوا على استخدام النصوص الفلسفية اليونانية. جادل الكندي بأنه يجب علينا احترام الحقيقة أينما وجدناها. ومع ذلك، وبما أن الفلاسفة لم يشكوا في الوحي النبوي، كان ما يزال عليهم أن يشرحوا لماذا لم تكن دراسة الفلسفة اليونانية أكثر مما هي عليه، حتى لو كانت تعاليمها صحيحة. بمعنى آخر، لماذا لا يكفي دراسة القرآن أو الكتاب المقدس؟ هذه قضية حيوية لفهم تفاعل العالم الإسلامي مع الفلسفة اليونانية.
صحيح ما قلت، رفض بعض علماء الدين في تلك الفترة دراسة الفلسفة اليونانية. لا نعرف بالضبط على من كان يرد الكندي عندما دافع عن التعامل مع الحكمة اليونانية، ولكن يأتي في هذا السياق مثال آخر بعد ذلك بقليل حول الخلاف عن قيمة المنطق. هنا بالذات، حيث نفى وعارض عالم نحوي اسمه السيرافي ضرورة دراسة الأعمال المنطقية اليونانية.
أعتقد أن هناك شكلين في الواقع يمكن أن تتخذهما هذه المعارضة للفلسفة اليونانية: الشكوى من أنها في الواقع غير متوافقة ومنسجمة مع تعاليم الإسلام -على سبيل المثال، من خلال التأكيد على خلود وقدم العالم بدلاً من خلق العالم وحدوثه - والقول، كما قلتَ، بأن الفلسفة اليونانية لا تضيف شيئاً لأن أي شيء حقيقي فيها يمكن أن يوجد أيضًا في الوحي الإسلامي. رد الفلاسفة على كلا الاتهامين بالطبع- فعلى سبيل المثال، من خلال تقديمهم لحجج فلسفية ضد خلود العالم، أو بإنكار أن القرآن ملتزم بعالم غير أبدي. وفيما يتعلق بتهمة تجاوز الفلسفة، كان ردهم المعتاد هو القول بأن الفلسفة هي في الواقع أداة مفيدة لفهم القرآن وتفسيره، وربما حتى القول بأن الفلاسفة هم أفضل من يمكن لهم تفسيره. هذا ما وجدناه لاحقًا يقوم به ابن رشد، على سبيل المثال. كتب الكندي أطروحتين يبين فيهما كيف يمكن أن تُستخدم الفلسفة في التفسير القرآني.
✧ هل تعتبر يحيى ابن عدي جسراً بين الفلسفة الإسلامية وورثتها في الفلسفة المسيحية؟
ليس ذلك كثيراً؛ لأنه يوضح أن الفلسفة في الفترة الأولى في أواخر العصور الوسطى، كانت مشروعاً متعدد الأديان: تعاون فيه المسيحيون واليهود مع المسلمين في ترجمة الفلسفة اليونانية وتفسيرها. من المثير للاهتمام أيضاً أن نرى كيف تم استخدام الفلسفة في المناظرات بين الأديان المختلفة، كما هو الحال مع تفنيد ابن عدي لانتقاد الكندي للثالوث.
✦ هل تعتقد أن تصور هيجل للتاريخ على أنه وعي ذاتي تقدمي يمكن الدفاع عنه تاريخياً؟ على وجه التحديد، هل يمكن تقسيم الفلسفة إلى مرحلتين، الفلسفة القديمة والفلسفة المسيحية الحديثة، مما يؤدي إلى المثالية الألمانية؟
لا، فأنا لا أقبل مثل هذا النوع من النهج "الغائي" [الذي يوجه نحو غاية معينة] لتاريخ الفلسفة. لا أعتقد أن الفلسفة تتقدم على طول أي مسار محدد سلفاً، أو حتى يمكن التنبؤ به، نحو وجهة نهائية.
في الواقع، ليس هيجل وحده من يعتقد أن الفلسفة تتجه نحو وجهة محددة. فبطريقة ما يمكنك أيضاً العثور على هذه الفكرة عند الفلاسفة التحليليين المعاصرين، الذين يفترضون أن نهجهم الفلسفي ينظر إلى أنّ كل الفلسفات السابقة قد استنفذت إمكانياتها وتم تجاوزها، ربما لأن الفلسفة التحليلية مستنيرة ومسترشدة بالعلم الحديث. إلا أنني لا أقبل ذلك أيضاً، لكوني أعتقد أن كل فترة وثقافة في تاريخ الفلسفة لها تاريخها الخاص، وتحتاج إلى تقييم ودراسة لمفاهيمها الخاصة- فقط لأن التقاليد الفلسفية المختلفة تطرح إشكالات مختلفة، بدلاً من محاولة الإجابة على نفس الإشكالات دائماً.
✧ ما رأيك في الدهريين أو الملحدين في الفلسفة الإسلامية؟ هل تعتقد، على سبيل المثال، أن أبا بكر الرازيّ قد عارض النبوة حقاً؟
أدافع عن قراءة غير مألوفة لموقف الرازي، وهو أنه لم يكن يهاجم النبوءة بشكل عام. بل أراد مهاجمة اتجاهات معينة داخل الإسلام، والتي يبدو أنها شملت الشيعة الإسماعيلية. كان يعتقد أن هذا النهج يرتكز بشكل كبير على سلطة الإمام. وعليه، ففي قراءتي، أعتبر هذا ما كان في الواقع نقاشاً عادلًا داخل الإسلام بل شوهه أنصاره من الإسماعيلية، الذين وصفوه بأنه هاجم كل الوحي وكل النبوءات.
✦ في القسم المعاصر من الكتاب، استبعدتَ بعضاً من أهم علماء الفلسفة المعاصرين في الإسلام، مثل أحمد فرديد، ومرتضى مطهري، وسيد جواد طباطبايي، وسيد حسين نصر، ومحمد حسين الطبطبائي. لماذا لم تتعامل مع الفلسفة الإسلامية الحديثة؟ والسياسية أيضاً؟
في حقيقة الأمر لقد تحدثت قليلاً عن محمد حسين طبطبائي وسيد حسين نصر. لكنك على حق في كوني قد تجاوزت القرن العشرين بسرعة كبيرة، ولم أتحدث عن القرن الحادي والعشرين على الإطلاق. كان هذا لسببين: أحدهما هو أنني ليست لدي تجربة ولا أملك اطلاعاً واسعاً، والآخر يتحدد في أنّ هذا الموضوع ضخم وواسع، أعتقدت أنه سيكون حقاً كتاباً إضافياً بالكامل إذا أقبلت على ذلك بشكل صحيح. لهذا، حاولت فقط التعرف على عدد قليل من المفكرين الجدد، الذين استلهموا من التقاليد التاريخية السابقة التي تمت تغطيتها في بقية الكتاب، مثل أركون وعبده ونصر.
✧ ما هدفك القادم؟ هل تريد الاستمرار على هذا النهج؟
لقد كان هذا هو الكتاب الثالث فقط، وستلحقه في النهاية سلسلة من المجلدات المتعددة. قد ظهرت إلى حدود الآن خمسة، بما في ذلك واحد عن الفلسفة الهندية الكلاسيكية، كُتبَ مع جوناردون جانيري Jonardon Ganeri. وستغطي المجلدات المستقبلية الفلسفة الإفريقية والصينية، بالإضافة إلى التطورات اللاحقة في أوروبا.
✦ في رأيك، ما الظروف الراهنة للفلسفة الإسلامية؟
طيب، مرة أخرى، لست متخصصاً في هذا الأمر، لكن انطباعي هو أن هذه الظروف تختلف كثيراً من بلد إلى آخر. لا يزال لدى إيران تقليد مهم في الانخراط في الفكر السابق، لا سيما في المدرسة الصدرية، ولا تزال شخصيات مثل السهروردي وابن سينا مؤثرة هناك. لكن هناك أيضاً علماء إيرانيون يشتغلون بالفلسفة التحليلية، أو يدرسون كانط وهايدجر أحياناً بالاشتراك مع النظر والتأمل عند المدرسة الصدرية. وهذا يحدث فقط في إيران!
بشكل عام، أعتقد أن الفلسفة في العالم الإسلامي ديناميكية ومركبة تماماً كما هو الحال في أوروبا أو أمريكا الشمالية. الشيء الوحيد الذي أود رؤيته هو المزيد من الحوار وتبادل الأفكار بين المجالين، بحيث إن كلاً من الأوساط الأكاديمية يمكن أن تتعلم من بعضهما البعض. لذلك؛ أنا سعيد جداً لدعوتي للتحدث معك، لهذا السبب بالضبط!

Issue 143: April/May 2021