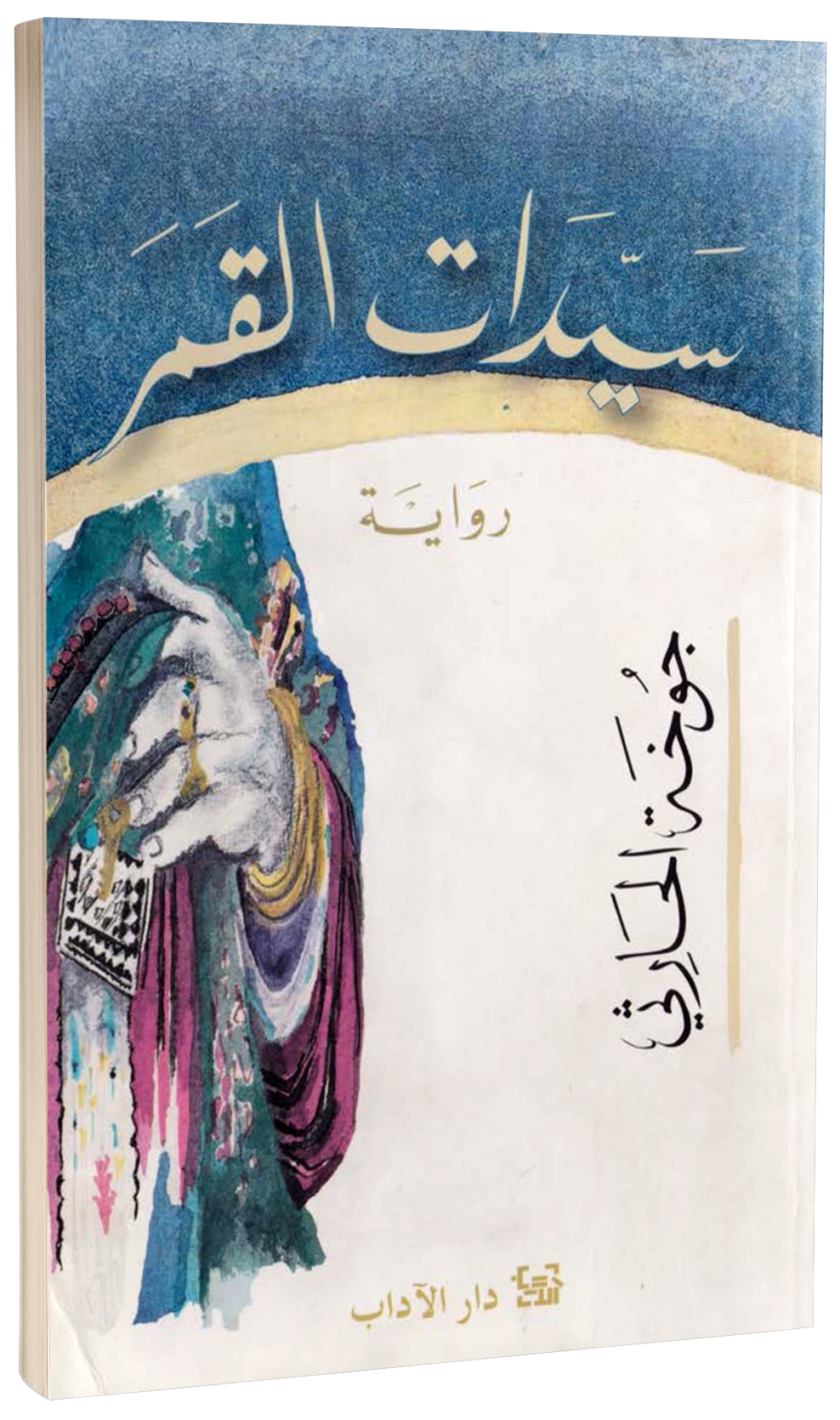
◂ بنية الرواية
تعتمد بنية "سيدات القمر" على فصول قصيرة أحياناً صفحة واحدة. تكرس الروائية سردها لكل شخصية على حدة، بحيث يكون لكل واحدة منها صوتها الخاص بها لتتحقق البوليفونيا، إلا أن عبدالله زوج مِيا يتصدر الموقف في سرده عن الماضي والطفولة والتقاليد، أثناء انتقالاته بين السماء والأرض وهو يجوب العالم مسافراً بالطائرات. ورغم أن مِيّا عمودُ الرواية المعماري، تتأسسُ عليه بنية الرواية منذ "الفصل" الثاني، لكن السرد يتدفق على لسان زوجها عبدالله، الصوت الثاني فيها، إلا أنه فعلاً الأهم، إنه الشخصية المحورية الأولى والأخيرة حيث ينتهي به السرد.
الفصول في هذه البنية قصيرة وبلا عناوين، ومع ذلك يفهم القارئ من جملةِ السردِ الأولى، وأحياناً بالتدريج، مَن هم أصحابها ومن هم رواتها أو لمن مكرسة. ويمكن القول إن الكاتبة أعطت كلَّ الشخصيات، رئيسةً كانت أم ثانويةً، حقَّهَا في السرد، كما هو واضح في الفصل المكرس لسالمه والدة ميا التي تعود إلى طفولتها، فيصبح فضاءا السرد المكاني والزماني أوسع بكثير. ونفس الشيء يقال بالنسبة للخادمة "العبدة" ظريفه، بحيث يمكن للقارئ أن يلاحظ أن هذه المصائر البشرية تسير في خطوط متوازية، ومتقاطعة أو متشابكة أحياناً.
تظهر في السرد "صورة الكاتب" الذي يقف خلف الشخصيات وبالذات الراوي، أو "الرواة" أثناء عملية سرد حكاياتهم، ليس بالضرورة بضمير المتكلم بشكل واضح، باستثناء عبدالله، الذي يأخذ زمام المبادرة في الحكي عن نفسه عبر الزمكانات، وعن الآخرين بدءاً من والده التاجر سليمان وعبيده وعشيقته ظريفه، مروراً بزوجته وأطفاله وانتهاءً بعائلة زوجته، حيث يجتمعون في طقوس الزواج والوفاة ومراسيمها.
وهي حكايات سلسة على شكل ذكريات تقدمها الروائية عن الأبطال، من خلال رواتِها من مختلف الأجيال بإسلوب هجين غير محدد بصيغة واحدة، لكن لكل شخصية خصوصيتها وزمكاناتها، فسالمه مثلاً تعود إلى آثار الحرب "والغلاء الفاحش واضطرابات القبائل" [ص: 99]، "الجوع هذا ما تتذكر من حياتها في بيت عمها..." [ص: 100].
تتيح هذه البنية الروائية فرصةً للكاتب؛ لكي يسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة في السلوك والأحداث، وحركة المجتمع، وتعين القارئ في الاطلاع على الواقع المعيش.
زايد ابن الفقير "منين" يأخذ أيضاً حقَّه في بنيان هذه اللوحة البانورامية عن منطقة "العوافي" بحيث لا تكتمل دونه، يسرد لنا الراوي قصة حياته منذ طفولته حتى أصبح ضابطاً في الجيش، لكنه مع ذلك يبقى إنساناً من الدرجة الثانية بسبب الأحكام النمطية عليه [ص: 126]، ونفس الشيء يقال عن البدوية نجية "سيدة" القمر، المتحررة، عشيقة عزان والد ميا، فلا يمكن أن تكتمل الصورة العامة عن سلوك الطباع بدونها. كلّ شيء محسوب هنا بدقة.
وهكذا؛ فإن البنية الروائية هنا تذكرنا بالسرديات الإطارية أو "المعلبة"، تعتمد كما أشرنا سابقاً، على حكايات خفيّة كثيرة واحدة داخل الأخرى، أو متوازية، عن الحب وقصص الزواج، وعلاقات العشق والغرام، رغم أن المجتمع العماني محافظ.
نجد هنا إشارة لحب ميا "الصامت" لعلي ابن خلف طويل القامة، وفيما بعد عبد الله وعلاقته الملتبسة مع ظريفة، وقصة حياة والدتها الملقبة بالخيزران لرشاقتها، لكن اسمها الحقيقي "العنكبوته" التي تُحبَسُ لرفضها أن تنامَ مع زوجها "نصيب"، ومن ثم حكاية العبد "حبيب" زوج ظريفة وولده "المنتفض" سنجر مع زوجته شنه ووالدتها، أو مغامرات عزان مع نجية القمر، ليس بالضرورة بطريقة تراتبية ومتسلسلة. ليس هناك قصة حب واحدة لبطل محوري تدور حولها الأحداث، كما هو الحال في النتاجات الكلاسيكية أو حتى الحديثة، لكنها أقرب إلى الرواية البوليفونية المتعددة الأصوات، بحيث يكون لكل صوت فصله الخاص، التي انتشرت في الأدب العربي في الستينيات والسبعينيات وما بعدها.
نلاحظ هنا أن الأسلوب اللغوي غير متعدد المستويات بما فيه الكفاية، وغير مختلف كثيراً في بعض الفصول تبعاً لمستوى شخصياتها الفكري والثقافي، كما يجب أن يكون في مفهوم البوليفونيا؛ لأنها هنا لا تتحدث دائماً هي بنفسها عن نفسها، بل يقف خلفها السارد أو "صورة الكاتب" التي أشرنا إليها، لكن يمكن لَمْس مستوى آخرَ لدى خالد العماني، المغترب المقيم في مصر، حيث يبدو -رغم ظهوره القليل على مسرح الأحداث- أكثر تدفقاً وحيوية وحماساً وشغفاً من الأصوات الأخرى، وديناميكية كونه فناناً "الفن بالنسبة لي ضرورة كالماء والهواء..." [ص: 190].
هذا ما نلاحظه في شخصية المغترب عيسى المهاجر، رغم أنه مندمج في المجتمع المصري لكنه غير متماهٍ ودائماً يحلم ببلده، و"حمل هَمَّ عمان على كتفيه" [ص: 191]، وهذا أيضاً أمر طبيعي في أوساط المغتربين والمنفيين عن بلدانهم لأسباب سياسية، لكنه أحياناً يتميز بالمباشرة عند الحديث عن الموضوعات السياسية والتاريخانية "جدّه الشيخ منصور... حاربوا مطلق الوهابي في غاراته المتكررة على العمانيين" [ص: 192].
تتميز هاتان الشخصيتان بطابع "البافَث"، الشغف أو الحماسة أيضاً بسبب اغترابهما عن بلدهما الأم، ما يبرر حيويتهما رغم ندرة حضورهما في القص. وهذا العمود، أقصد حكايات المغتربين العمانيين عن تاريخ بلدهم وولائهم له، يمارس حضوره أيضاً في روايات عمانية أخرى مثل: "التي تعد السلالم" للروائية هدى حمد. ونحاول هنا رصد أهم ثيمات (موضوعات) هذه الرواية:
◂ الزمان والمكان والهرونوتوب كموضوعات:
تدور الأحداث في منطقة العوافي، حيث تعيش عائلة عزان وسالمة وبناتهما الثلاث: ميا، أسماء، خولة، لكل واحد من أفراد العائلة قصته وزمنه الخاص، ويتداخل الماضي بالحاضر. يتضح زمن كتابة النص بالتصريح "أما الآن في أوائل الثمانينيات..." [ص: 58]، أو "في 25 سبتمبر 1926 كانت عنكبوته الملقبة بالخيزران تحتطب في الصحراء حين فاجأها المخاض..." [ص: 134]، ولدت ظريفه التي يقولون لها عندما كانت ميا نفساء إن عمرها على الأقل 50 سنة، بينما يمكن الاطلاع بالتدرج مثلاً عن انتقال سالمة إلى بيت عمها بعد الحرب العالمية وهي في الخامسة عشر، وزواجها من عزان، من خلال الذكريات والحكايات، فتضع الأم سالمه في هذه الفترة "ميا"، التي ستخلف بعد عشرين سنة من عمرها ابنتَها "لندن" في زمن الكتابة بداية الثمانينيات. وإنّ انتشار ماكنة الخياطة ماركة "الفراشة" مؤشر عى فترة زمنية محددة، كما يبدو في عُمان.
الأدوات والحاجات والسلع والماركات لها أيضاً زمنُها الخاص الذي راجت فيه، ويمكن أن يُستدلّ من خلالها على الفترة التي يصورها الكاتب، لو كنّا في بعض الدول العربية الأخرى لسمعنا مثلاً عن انتشار ماكنة خياطة "سنجر" في الستينيات والسبعينيات. وتذكر الروائية في هذا السياق أن العُماني أبا عيسى المهاجر وابنه الصغير خالد، "هاجرَا إلى مصر عام 1959" [ص: 145]، ويمكن القول عموماً: إن القارئ يحتاج إلى تركيز لمعرفة تسلسل الأزمان وأعمار الأبطال وفضاء الرواية، وقد يصعب عليه فهمها وتظهر لديه علامات استفهام.. وتتضح هنا علاقات الزمان بالمكان "الهرونوتوب" على حد تعبير باختين.
◂ المكان:
تعكسُ الروايةُ العلاقاتِ في الأطراف مثل "العوافي"، والمركز حيث العاصمة مسقط أو "مسكد"، كما تلفظها عائلة البطلة ميا. ومن هذه القرية تتحرك الشخصيات في عوالم متنوعة ومختلفة ومتفرعة، تعود إلى طفولتها في عمان وأصولها الإفريقية، كما هو الحال في ذكريات سالمه وهروب سنجر من أجل حريته.
تُصوّرُ الكاتبةُ الأبطالَ وهم يتحركون ضمن أماكن نشاطهم، بين السماء والأرض بالنسبة لعبد الله، أو سيارته عندما يكون مع والده أو ابنته، أما ظريفة فهي تتنقل من هذا البيت إلى ذلك حسب المناسبات، بينما تفضل سالمه بيتها القديم في العوافي.
يحدثنا عبد الله وهو يجلس في سيارة ابنته الدكتوره لندن "كنا في سيارتها الجديدة... نروح شاطئ السيب؟... الطريق الساحلي... تحاكي برج العرب بدبي" [ص: 53].
وتسلّطُ الروائيةُ الضوءَ على تطور المكان وتغيره تبعاً لحركة الزمان، المنازل يتم تعميرها وتوسيعها، كذلك العمران والمدنية "عرفت مصابيح النيون الطريق لكل بيت في العوافي" [ص: 67].
◂ التقاليد والناستولجيا:
أغلبُ حكاياتِ الرواية مستمدٌّ من الموروث الشعبي، ويتم تسليط الضوء بخاصةٍ في جلسات النساء، على التقاليد و"الأصول" التي لا تستغني عنها المجتمعات، ونصائح النساء الكبيرات في السن للعرائس في ليلة الدخلة وأسرارها، كما هو الحال في أعراس ميا، وخولة، وأسماء، وسالمة التي تؤخذ عنوةً إلى زوجها عزان [ص: 159]، ووفاة والد عبد الله، وتفصيلات غسله ودفنه [ص: 181]، بغض النظر عن كونها باليةً ومتخلفةً أو عكس ذلك.
غَسلُ الميت بالذات يمارسُ حضوره أيضاً في رواية "سندرلات مسقط" لهدى حمد. وتصوير التقاليد، أو الطقوس هنا من قبل الكاتب قد لا يكون لأغراض النقد الاجتماعي فحسب، مثل "لا ينبغي أن تكون البنات، وهن يكبرن ويتفتحن في مواجهة عيونهن الفضولية، كما لا ينبغي أن تسمع البنات كلام الكبيرات" [ص: 86]، بل كحالة نفسية تعبر عن الشوق، يشعر بها الإنسان مغترباً كان عن بلده أو مقيماً فيه، هي شعور الناستولجيا، أو الحنين إلى الماضي أيضاً، للمقارنة بين الأزمان والأماكن وتطور المجتمع. نقرأ في الرواية: "لاتوجد في العوافي غير سيارة الشيخ سعيد لحمله إلى مستشفى السعادة في مسكد "مسقط"... خرج كل الناس من بيتهم لمشاهدتها، أمّه العجوز توكأت على عبداتها وخرجت لتراها، حين سمعت هدير المحرك... صرخت لأهل العوافي أنها من الشيطان..." [ص: 104]. نفس الشيء يقال عن ذكريات عبد الله عن الطفولة، وحنينه إلى الماضي [ص: 133]، "أوكل لظريفة مهمة تربيتي... وما إن كبرت قليلاً حتى علقت الخرز في عنقي لحمايتي من الحسد" [ص: 166]، وسالمة التي تتذكر تفاصيل حياتِها عندما نُقلت لتسكن عند عمها [ص: 148-150]، حتى السحر يأخذ طابعاً تشويقياً عند الجيل الجديد، حيث تتسائل الدكتوره لندن "لماذا لا يقول الناس عن جدتي إنها ماتت مسحورة"؟ [ص: 160].
وتوجه الرواية انتقادَها لبعض التقاليد باسم الدين، بينما تحاول الشابة أسماء إثبات عكس ذلك معتمدةً على أحاديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وبالذات بخصوص المرأة الحائض والنفساء. أو سلوك التجار والأغنياء المتناقض مع الإسلام، بخاصة عندما يدرس التلاميذ سورة "الهمزة" {ويل لكل همزة لمزة}، فيقول عبدالله "وتصببتُ عرقاً خوفاً من أن أقول إن أبي تاجر... تعني شخصاً قبيحاً" [ص: 66]
أو حادثة اغتصاب معلمات مدينة صلاله، وهو انتقاد لاذع وصريح، يقدمه الراوي كأنه أمر شائع في مجتمع محافظ، كذلك الانتقاد الشديد لتربية الأطفال التقليدية القاسية، عبد الله يتذكر قسوة والده: "ولد فطوم.. ولد فطوم.. تكبّر علي أنا؟ تخالفني أنا؟.... فقدت الوعي حين هوت إحدى لكماته على مكان ما في رأسي..." [ص: 91]، ويتذكر فيما بعد "بعدما ضربتُ سالماً فاجأني الإحساس المرعب بأني أصبحتُ أشبه أبي..." [ص: 122]، وهذه هي الكارثة في بعض مجتمعاتنا العربية، حيث تتوارث الأجيال نفس التربية التقيلدية؛ لأسباب معروفة لمتخصصي علم الاجتماع والتربويين.
موضوع أليغوريا التطورات الاجتماعية
تصر ميا على أن تسمي ابنتها البكر لندن، ورغم أنها تبرر ذلك بأنها ليست الأولى في عُمان بهذا الاسم وتشرح معناه بالعربية، وتقول: إنَّ "هناك امرأةً لها نفس الاسم"، لكنه من وجهة نظري كناقد تعبير مجازي أليجوري عن قوة العلم والغرب والتطور، وليس صدفة أنها متمدنة إن لم نقل متحررة، وتصبح طبيبةً وقوية ومحترمة، والدُها يتحدث معها بصراحة عن فسخ خطبتها واغتصاب صديقتها حنان.
تقول سالمة عن بنتها ميا: "يا أختي أي رجل هذا يخلّي بنته تتسمى هذا الاسم الغريب؟ ماله شور... لو عنده عزم وشور كان ما يخليها تسميها اسم بلاد النصارى لندن"؟ [ص: 73]، ونشير هنا إلى أن الأم سالمة تلد وهي واقفة؛ كأنها تجسد أليغوريا النضج والقوة و"الرجولة".
حتى عنوان الرواية يحمل أليغوريا معينة، فالنساء في "العوافي" سيدات نشطات في كل مناسبات المجتمع وطقوسه الاجتماعية، ولا يمكن الاستغناء عنهن رغم التسلط الذكوري عليهن، سالمة تقرر زيجات بناتها، إنها قوية "إي والله يا ميا ولدتك أنت وكل أخوتك واقفة مثل الفرس" [ص: 11]، "امرأة مسيطرة" و"عروس الفلج"، "وجهها مدوّر ببشرة صافية"... وعيناها نافذتان" [ص: 44]، أما ظريفه العبده فلا يمكن الاستغناء عن خدماتها، بينما الجيل الجديد يمثل التطور بطريقة أخرى، فالشابة خولة وعلى عكس أختها الكبيرة ميا، ترفض تزويجها من شخص غير حبيبها ابن عمها الذي تنتظره رغم ممانعة أمها، أما الصغرى أسماء فتتزوج التشكيلي خالد، والقمر هنا أليغوريا النور وأن عمان تنتقل في تطورها من العتمة إلى عصر الأنوار.
بل إن غريمةَ سالمة ومنافستها في حب زوجها عزان امرأةٌ غير عادية، قوية يهابها الرجال "أنا نجية وألقّب بالقمر وأريدك أنت" [ص: 38]، وتقول عن نفسها: "القمر لا تؤمّر أحداً عليها.. أنا لم أخلق لأخدم رجلاً وأطيعه.." [ص: 40]، وميا تؤكد أن المرأة لا تُضرب، إلا ما ندر، ولهذا تقف بحزم ضد أحمد لمعاملته السيئة لابنتها لندن.
موضوع الرق والعبودية:
أما موضوع الرق والعبودية والعنصرية؛ فإنها تحضر في روايات عمانية مثل "التي تعد السلالم" للكاتبة هدى حمد، وليست هذه الرواية هي الأولى في هذا المجال، حبيب زوج ظريفه "كان يردد دائماً بأنه سيعود إلى أرضه التي انتزع منها، ولحريته التي اغتصبها القراصنة" [ص: 70]، أما ابنه سنجر فقد كان يقول بكل وضوح مستفزاً والدته ظريفه: "علمني وزوجني لمصلحته هو، من أجل أني أخدمه وتخدمه امرأتي وأولادي، لكن لا، ياظريفه، التاجر سليمان ماله دخل بي، نحن أحرار بموجب القانون... أنا حر، أسافر كما أريد..." [ص: 94].
أخيراً؛ لا بد من الإشارة إلى أن الأدب العربي حافل بروايات تعالج مثل هذه الثيمات، إلا أنها الآن أخذت منحىً آخرَ بسبب تركيز الإعلام الغربي على الإسلام والإرهاب، والتطرف الديني والعلاقات التقليدية المحافظة، واضطهاد المرأة في المجتمعات العربية، وأصبح الكاتب العربي يجد نفسه في كثير من الحالات بأنه في موقع الدفاع عن النفس، والتبرير والتفسير، ويشعر بتأنيب الضمير وواجب توجيه الخطاب إلى القارئ الغربي.
إنها رواية بانورامية كتبت بتقنية حديثة عن الواقع العماني المتغير، رغم الصعوبات والتاريخ المليء بالتضحيات التي قدمتها مختلف أجيال العمانيين؛ من أجل التطور دون التخلي عن الهُوية والانتماء.