عديدةٌ هي الدواوين الشّعرية العربيّة التي اختارت لعناوينها كلمة "تراتيل"، تعدد يعود في اعتقادنا، لطبيعة المفردة وعلاقتها بالشعر والإنشاد، وحسن الصوت والتلاوة، فالتراتيل جمع لترتيلة من فعل "رتل"، فعل أثار جدلاً حول دلالته في النص القرآني، حتى وإن كان أغلب المفسرين أجمعوا على دلالة واحدة للترتيل وهي:" الترسُل والتبيين والتلبث، والتأني والتمهل في التلاوة، وهي جميعاً معان متقاربة".
قال ابن عطية 546هـ: "ورتّل" معناه في اللغة، تمهل وفرّق بين الحروف لتبين. والمقصد أن يجد الفكر فسحة للنظر وفهم المعاني، وبذلك يرق القلب ويفيض عليه النور والرحمة، قال ابن كيسان: المراد تفهمه، ومنه "الثغر الرتل" أي الذي بينه فسخ وفتوح، ورُوي أن قراءة رسول الله صلى الله عيه وسلم كانت بينة مترسلة، لو شاء أحد أن يعد الحروف لعدّها".
وفي الويكيبيديا الترتيل أو الترنيمة لغة تعني التناسق والتحسين والتطيب في التراص، وتستخدم أساساً لوصف طقوس عبادة أو صلاة، تتم عبر تلاوة أدعية أو مدائح، أو نصوص مقدسة مع لحن ونغم بغرض أداء صلاة، أو العبادة تقرباً لآلهة أو مقدس".
لجاذبية الكلمة وشساعة حقلها الدلالي، استوطنت عناوين عدد من الدواوين الشعرية العربية، التي يصعب حصرها في هذا المقام، تعدد يتنوع فيه المضاف إليه اللصيق بها، وفي هذا الإطار يمكن التمثيل بـ"تراتيل الزمن الضائع" للشاعر الجزائري بادر سيف، و"تراتيل السراب" للشاعرة الليبية بشرى الهوني، و"تراتيل الجمار الخابية" للشاعر عبد الله فراحي، و"تراتيل عاشق" للشاعر مزهر علي الشهري، وأشهرها تداولاً "تراتيل المواجع" للشاعر محمد الماغوط... إضافة إلى "تراتيل الملحاء" للشاعرة فتيحة البو.
"الملحاء" هو ما يميز تراتيل شاعرتنا، والملحاء جمع ملحاوات ومؤنث أملح؛ أي ما كان ذا جمال وحلاوة أكثر من غيره، كبش أملح أسود يعلو رأسه بياض، أملح الشخص: طيب، أتى بكلام مليح يجتمع الناس في السهرة حوله لأنه يلح حديثه".
إنها دعوة من الملحاء، الشاعرة، للإنصات والاستماع لتراتيل وعددها ست احتواها الديوان، من بين خمس وأربعين قصيدة تميزت بقصرها واقتصادها اللغوي، وهي على التوالي تراتيل لوالدي/ البحر/ الريح/ الوطن/ السندريات/ الذات.
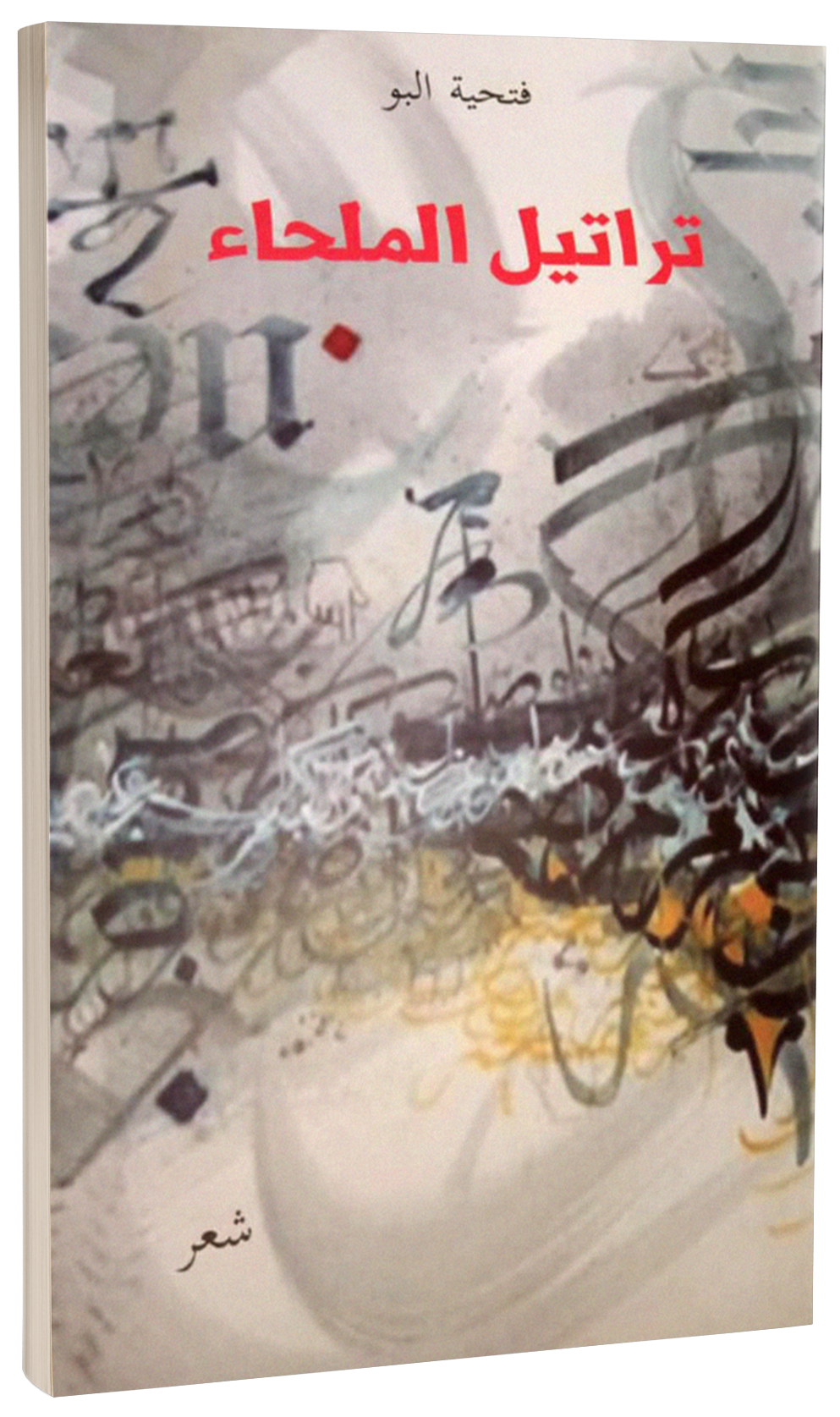
ففي باكورتها الشعرية الأولى "تراتيل الملحاء" تتناسل الاستعارات المتسائلة عن هذا الحضور الملتبس، الذي يلف فتيحة البو ويقذف بها إلى متاهات العبور، حيث النداءات المتعددة لضياع المعنى والانفصال عن جوهر الحياة، يصير للفواجع جراحات تحفر في الذاكرة والوجدان، وتُبعد الكينونة عن لحظة إشراق تتصالح فيها مع الكائنات، فكل شيء منذور للبعد والقلق الوجودي الذي يشع بين السطور. ووحدها الشاعرة تقاوم بتراتيل وترانيم تريد أن تعيد للزمن كينونته المنسية.
كثافة التراتيل في الديوان تنحو نحو خلق جمالية غنائية تزيد القصائد بهاءً، انطلاقاً من الدلالات الوجدانية التي يدثرها الفقدان والضياع، والرغبة في الانصهار والتوحد التام مع مكونات الطبيعة، فالشعر هنا يتحرك في اتجاه السفر نحو الأعماق، والأخذ بأسباب الحياة وكل الممكنات التي تجعل من الحياة قابلة للاحتضان.
التراتيل جسر ومعبر لغوي به تنفتح اللغة على مباهجها، وينفتح المتخيل الشعري على نواصي الكلام البديع، حيث الترتيلة ترسم للمدى آفاقاً واسعة للتأويل والتبصر لاستبدال الظاهر، والبحث عن التطابق والتجانس المخفي وراء شفافية اللغة. هكذا تعبُر ترتيلة الريح كل المسافات لتحط الرحال أمام الطفلة التي مرت في القطار:
الطفلة التي مرت
في القطار
وأنا على الرصيف أرقبني
كانت ترسم
وجه الريح
أنا الطيف الذي
علق بصمة
على كتف الريح واختفى
على حافة الناي [ص: 83]
بين الطفلة والطيف جناس خفي، يجعل الريح يمسح عن وجهه ظلاله ويحتفي ببصمته المعلقة على كتفه، بين الوجه والكتف تناجي الذات طيفها وشبيهها، نرجس الأسطورة يبحث عن صورته أو ظله، يتماهى في لحظة مسافرة عبر حقول الزمن، لا يخلد فيها سوى صوت الناي.
إنها استطيقا المتخيل الشعري عند فتيحة البو، التي تجعل من التراتيل بوابة للغوص في كينونة الذات، انطلاقاً من قبسات تستلهم مكونات الطبيعة، كما هو الحال هنا مع البحر:
أودعتك جناحي
قل للنوارس أن تبطىء قليلاً [ص: 22]
وبعد ذلك؛ فإن الترتيلة تتصاعد وتتدرج لتقف أمام الذات مبهورة متسائلة، قلقة، تستحضر من مقامات التصوف ما كان رؤية أو رؤيا:
أتراني
مشيت بعيداً
أم أن الرصيف الآخر
اختفى؟ [ص: 98]
أميد بي
أرى الله في
ولا أراني [ص: 6]
في قصيدة "تراتيل الوطن" تلفظ "الذات" وحدانيتها وعزلتها لتلبس رداء الجمع، فتكونُ "النحن" آصرة لتوحيد الرجاء والمبتغى، آصرة لتعميق النظر في "شرخ المرآة"، وكثرة الندوب وعتمة الآفاق.
إنها جراحات الزمن السياسي الذي جعل البلاد تتأخر، ولا تحقق حلم أبنائها في التقدم وفي العدالة الاجتماعية، جراحات أخّرتنا على خط الوصول، وأجهضت حلمنا الجميل، لذلك لا عجب أن تتكرر كلمة الحلم أربع مرات في قصيدة قصيرة، الحلم المجهض أو الكسيح، كمقابل جدلي للخيبات التي جعلت:
وطني سياجات تتعالى
العمر فيه حبات تعب
والموج جناح لحلم كسيح [ص: 89]
حينما ينهار الحلم بسبب الخيبات والانكسارات التي توالت على الوطن وكانت الشاعرة، واحدة، ممن انخرطوا في صياغة خارطة طريقه على دروب التقدم والرفاهية، واقتسام الخيرات وتوزيعها توزيعاً عادلاً، يصبح هذا الانهيار هو نواة الكتابة ونواة القصيدة، نواة صلبة لترميم المُنكسر والمنهار، محاولة لإعادة كتابة الوجود بأفق مغاير، يتم فيه وصل الحلم بالرؤية المرتهنة لقناعات فكرية تنحاز للجمال والخير، وحب الناس والتعاطف معهم في مآسيهم.
إنه الحلم "المقاومة" الصمود في وجه كل الالتباسات والفظاعات والاغتراب، من أجل عالم بديل أكثر عدلاً وأكثر حريةً.
سعة الحلم في الديوان ترتفع عن هذا المسار ولا ترضى به، يهمها تدفق الزمن الوجودي وانسيابه، تحرص على الرؤية وتحتاط من انفلات الفرصة وضياعها، ورغم ذلك فهي لا تنضبط لامتلاك أخلاقيات الحضور، المعادلة مختلة بين انضباط وصرامة تحترم شروط اللقاء والموعد؛ لأنها بكل بساطة ترتمي في أحضان الإشراقة الصوفية، فقصيدة "حلم" التي لا يتجاوز عدد أسطرها الشعرية إحدى عشر سطراً تبئر الزمن في اتجاه فتح الفوارق بين الهنا والهناك، تعيد عن طريق التصوير الاستعاري استدعاء المفهوم الفلسفي للزمن قافزة على التصور الفيزيقي المتعارف عليه، احتضان للزمن الخصب الذي يصالح الذات مع محيطها، ويحقق اللقاء مع كل الكائنات القادرة على اقتسام ما يسميه ابن عربي الزمن الأنفسي، زمن الرؤيا والإسراء.
تواعدنا
على زرقة اللقاء
جئت في وقتك
بالدقيقة
بتوقيت الهناك
جئت متأخرة
في وقتي
بتوقيت الهنا
ولم يأت البحر
بقي مختبئاً
في قوقعة طفل صغير [ص: 56]
إنه نص شعري يحمل كوكبة دلالية متلبسة بمعجم الزمن: الموعد، اللقاء، الوقت، الدقيقة، التوقيت، التأخر، البقاء، وكلها تضع الانزياح الكبير في التقابل بين الشاعرة ومن تواعدت معه، على أساس أن التوقيت مختلف بين الهنا والهناك، تدرج من الزمن الفيزيقي إلى الزمن النفسي، كما كان يفعل الشاعر الإنجليزي ت س إليوت وهو يرتل نشيد الأضداد. ثم إن تلازم الزمن بالمكان، الهنا والهناك، يترجم مرايا الروح الظامئة إلى فرح صوفي:
نحن فقراؤك
يا ألله
نفك طلاسم الطريق
ونرصف الحصى
مواعد للفرح
بتسعيرات آجلة [ص: 93]
في الديوان منطقة عازلة لا تستجيب للتراتيل، ولا تخضع لامتدادها الموضوعاتي، بل تؤسس حقلاً شعرياً متميزاً، ينهض على مواكبة تداعيات الحالات التي توجد فيها الذات متفاعلة مع محيطها الخارجي، تقتنص من شوارد اللحظات الخفي والمستتر، العميق والمثير يتحقق ذلك بتطويع اللغة وجعلها تغوص في الاستعارات، تشتغل على الانزياحات الكبرى التي تولد الدهشة والجمال.
إن الانزياح هنا بالمعنى الذي صاغه جون كوهين1 في كتابه "بنية اللغة الشعرية"، يجعل من الكلمات تحدد بُعدها écart عن الخطابة والتقرير "وتخرق قاعدة من قواعد اللغة، أو مبدأ من مبادئها"، الشيء الذي يحقق أثراً جمالياً، فالانزياح ليس إلا خروجاً على الطبيعة اللغوية بكل مظاهرها التركيبية والدلالية، من أجل بناء القصيدة أو البيت الشعري المثقل باستعارات ومجازات تحيد إلى عالم يحتاج تريثاً لاستقبال الدلالات الجديدة، والمعاني غير المتوقعة من أجل نسج خيوط المعنى، والاقتراب من عوالم الشعر وخفاياه:
يحدث
أن أرسم للعالم جناحاً
ومنقاراً جديداً
وأنتزع من بين الجثث والدماء
بياضاً قليلاً [ص: 42]
بمثل هذه اللغة الشفافة، الضاربة في عمق التصوير، تُنسج معظم قصائد الديوان باحتفاء تلقائي، نابع من قراءات سابقة لمتون الشعر العربي الحديث، واستفادة من تجاربه المتميزة التي ترقى على ما أصابه اليوم من بوار وتطاول.
في تجربتها الأولى "تراتيل الملحاء"، تؤكد فتيحة البو أنها شاعرة تمتلك من ناصية الشعر الشيء الكثير وتعد بالمزيد .
هامش: 1. كوهين جون: بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال، البيضاء، المغرب ص: 14-28] .