مارينا لازاريفا
«لا تكن مجرد سمكة رقمية في حوض سمك وسائل التواصل الاجتماعي»
لقد تحوّل عالمنا بشكل ملحوظ إلى مجال التقنيات الرقمية والافتراضية. تمتلئ الحياة اليومية بتقنيات المعلومات التي اخترقت عملنا وأوقات فراغنا، وطغت التقنية على تفكيرنا الفردي، وأزالت الصلة الأساسية بين الإنسانية والطبيعة. اليوم، يفضّل الناس قضاء أوقات فراغهم في دور السينما، وأزقة البولينغ، والمقاهي (ويفضّل أن يكون ذلك مع وصول مجاني إلى شبكة "واي فاي")، بدلاً من الذهاب إلى الغابة أو في نزهة. حتى رحلاتنا في الطبيعية اليوم يجب أن تكون مريحة ومحمية. الاستعداد لها هو أشبه بالتحضير للمعركة، بما في ذلك تعبئة البخاخات المضادة للبعوض، والمظلات، والخيمات، ومعدّات الشواء، والكراسي، والأطباق، ولعب الأطفال، ومفارش المائدة، والبطانيات، وشواحن الهواتف المحمولة.
نحن نستعد لجميع المفاجآت المحتملة للطبيعة، ونحاول أن نجهّز أنفسنا قدر الإمكان لمواجهة هذا العالم غير العقلاني والمضطرب. وحتى بعد كل هذا الإعداد، لا نخصّص وقتنا للتحدّث مع أصدقائنا، ولكن نمضيه في البحث عن أفضل المواقع للصور، التي نقوم بعد ذلك بنشرها بأسرع ما يمكن على الشبكات الاجتماعية. يبدو أن العقلية هي أنك إذا لم تشارك صورك للنزهة مع "الأصدقاء الاجتماعيين"، فقد لا تحدث النزهة أبدًا. لسوء الحظ، في ظل هذه الظروف، لا تحدث النزهة حقًا: لقد أنفقنا نصيب الأسد من جهودنا على أشياء ثانوية تمامًا؛ نلاحظ جمال العالم الطبيعي حصريًا من وجهة نظر أنه يصنع صورة جيّدة؛ ونسمع قصص أصدقائنا دون تركيز، وهم بدورهم، منغمسون في عالم الواقع الافتراضي أثناء "النزهة".
وجهة نظر لا تُنسى
يحاول العديد من الأشخاص اليوم التقاط كل خطوة يتخذونها بالصور، وإلا فقد يتولّد لدى أصدقائهم انطباع بأنه ليس لديهم حياة. لذلك على الرغم من أن فيسبوك وانستغرام وتويتر وتلغرام، والشبكات الاجتماعية الأخرى مثقلة بمحتوى الصور، يحتاج المصوّر في الوقت الحاضر إلى إبلاغ الجمهور كل يوم. يجب ألا يكون المنشور مكتوبًا بقدر ما هو موثّق بالصور. أصبحت تطبيقات تحرير الصور، بدورها، شائعة بشكل لا يصدق؛ لأنها تساعدنا على "خلق" الحياة التي نريد أن نظهرها للآخرين. قد نعيش في حي فقير ونرتدي ملابس رثة، لكن صورنا على الشبكات الاجتماعية تجعل حياتنا تبدو وكأنها حكايات خرافية.
يجب تقديم عطلات الأطفال وحفلات الزفاف وأعياد الميلاد وجميع أحداث الحياة الأخرى بوضوح كجزء من هذا "الحلم". ما يهم أكثر هو كيف ستبدو إجازتك في الصورة، وليس كيف ستمضي الإجازة؛ يجب أولاً وقبل كل شيء أن يكون الطعام "حسن المظهر" وليس لذيذًا؛ يجب أن تكون الابتسامات في الصورة، حتى لو لم تكن بالضرورة في الواقع؛ يجب أن تكون الملابس فاخرة وليست مريحة. الهدف الرئيس هو التأثير المبهر، وليس جودة التجربة. إذا كنت ترغب في إثارة إعجاب ضيوف حفل الزفاف بكعكة متعدّدة المستويات، فلا توجد مشكلة، إذا لم يستطع أحد تخمين أن معظم الطبقات هي من الورق المقوى. إذا كنت ترغب في تقديم احتفال كبير لأصدقائك بعيد ميلاد طفلك، فلن يرى أحد أن وراء صور الابتسامات تكمن إهانات ومشاجرات خفية. لذلك نحن نعيش من أجل الجمهور، وننشر صورًا لا تصدق من القصص الخيالية على الشبكة، ونحاول خلق الوهم بأنه لا توجد مشاكل، أو صداع، أو قلق، أو صعوبات. ومع ذلك، فإن أسوأ ما في الأمر هو أننا لا نخدع الآخرين، ولكننا نخدع أنفسنا.
تتشابه حياتنا أكثر فأكثر مع حياة الأسماك في حوض السمك: يمكن للجميع النظر إلى الداخل، والجميع يطرقون الزجاج، ويطلبون الاهتمام.. وبصفة عامة، يسعدنا أن نُظهر أنفسنا، وأن نضع أنفسنا في أفضل ضوء، ونقف أمام أشخاص غير مألوفين لا يهتمون بنا على الإطلاق. بعد كل شيء، كل واحد منّا منشغل بنفسه.
لسوء الحظ، لا يمكن تفسير هذا التركيز الذاتي بالمعنى الذي اكتشفه مارتن هايدجر (1889-1976). كتب أن الشخص الذي يركّز على نفسه يحاول سماع صوت كيانه. بدلاً من ذلك، فإن التركيز الذاتي للعصر الرقمي هو هوس مؤلم لإبراز الذات بأكبر قدر ممكن من الفعالية على خلفية إخفاء الهوية الجماعية. لكننا ننسى بسرعة أسماء "أبطال" الإنترنت الحديث، لأن غدًا سيحل محلهم أبطال جدد. قد ننسى أيضًا أن أسماءنا وحياتنا عابرة، حيث نحاول بعناد نقشها في عالم الشبكات الاجتماعية. نعتقد بطريقة ما أنه إذا سمع عدد كافٍ من الناس عنا، فإن حياتنا ستكون مهمّة. على كوكبنا المكتظ بالسكان، تبدو الشهرة على الأقل بمثابة بعض الإنجازات. لكن في الحقيقة، نحن نضيع حياتنا ووقتنا في ملذات قصيرة المدى تتحوّل إلى أشباح.
لذلك نحن نكذب على الآخرين وعلى أنفسنا. نحن نمزّق أنفسنا بعيدًا عن الواقع ونغرق في عالم من الخيال. نحن نعيش من أجل الجمهور، ونذوب في حياة الآخرين، ونشوّه ونقطع الصلة بين الإنسان والطبيعة، وبين الإنسان والإنسان، وبين كل إنسان ونفسه. نحن نبذل الجهد والوقت والمال لإقناع الآخرين بـ"المؤثّرات الخاصة" لحياتنا، متناسين أن "الأداء" سينتهي قريبًا، وسوف نُترك لحالنا مع أنفسنا في عالم من الفراغ والنسيان. بعد كل شيء، فإن اللامبالاة بالعالم الداخلي - للتعليم الذاتي الأخلاقي، والتنمية الذاتية والنمو الشخصي - ستؤدي إلى إفقار روحي، سيكون بانتظارنا عندما نُترك وحدنا مع أنفسنا.
الاغتراب في الفضاء السيبراني
المشكلة هي أننا نبحث عن معنى حياتنا في المكان الخطأ. نحن دائمًا وحيدون في مواجهة الموت واليأس واللانهاية. في القرن العشرين، اهتم الوجوديون، وبخاصة هايدغر في كتابه "الوجود والزمان" ((1927، بهذه المشكلة ولاحظوا أن الناس كثيرًا ما يلاحقون القيم الخاطئة. بدلاً من سماع كيانه، والتركيز على نفسه، والتقاط اللحظة الفورية والاستمتاع بها، يذوب الفرد في عبثية العالم العام، ويمحو شخصيته (لإمتاع الجماهير)، ويغلق أذنيه وينأى بنفسه بغضب عن كل الأفكار التي يمكن أن تزعج راحته، بما في ذلك الأفكار عن الموت واليأس والشعور بالوحدة. الكتلة المجهولة غير مبالية بنا، لكننا ننتظر بعناد أمامها بحثًا عن المجد والتصفيق. نحن نسقط، ننهار، نحطّ من قدر أنفسنا، بينما نوثّق هذه العملية ببهجة. إنه لأمر مخز أن تطلق على نفسك اسم إنسان إذا تم اختزال سلوكك إلى سلوكيات القردة الغريبة أمام الكاميرات، وأداء الحيل والتظاهر لتسلية جمهور مجهول في الغالب.
لقد نسينا أيضًا إلى حد كبير كيف يبدو صنع شيء بأيدينا. بشكل عام، لم نعد نطبخ أو نحبك أو نبني أو نرسم. نحن بعيدون عن ممارسة أنشطتنا، عن طبيعة العمل نفسه، عن جوهرنا. ربما لا نريد حتى إضاعة الوقت في إعداد عشاء عائلي؛ لأن الإعلانات تظهر لنا عالماً خالياً من القلق حيث يمكن لكل ربّة بيت طلب وجبات جاهزة دون إتلاف طلاء أظافرها. لكن نزعتنا الاستهلاكية تقلّل من قيمة عملنا وتحوّله إلى عملية خط أنابيب. لقد أصبحنا نوعًا من "العوالق المكتبية" الذين يؤدون واجباتهم بشكل أعمى، ويحلمون بإكمال يوم العمل في أسرع وقت ممكن. اليوم، لا يستمتع الجميع بما يفعلونه، والقليل منهم محظوظ بما يكفي للعثور على وظيفة يحبونها. وفي الوقت نفسه، فإن الوقت ينفد حيث إن سعينا لتحقيق أهدافنا الشبحية يصبح أسرع وأسرع. نتيجة لذلك، نفشل بشكل كارثي في الاستثمار في حياتنا.
يتجلّى الاغتراب أيضًا في علاقاتنا. حدث مؤخرًا أن لاحظت زوجين يمشيان في الحديقة. بدلاً من التواصل والاستمتاع بالمنظر، أمضيا الوقت على هواتفهما. استغرقت الفتاة وقتًا طويلاً مع الكاميرا، وظهرت أمامها بطرق مختلفة، بينما كان الرجل يلعب لعبته المفضّلة. لم يتحدثا كثيرًا، ولم يهتما بوجودهما كثيرًا، ولم يكونا مهتمين بما يفعله الآخر. كيف يمكن أن تصبح الأدوات أكثر إثارة بالنسبة لنا من أحبائنا؟ وهذا لا ينطبق فقط على الشباب: فهناك الآلاف من الأمهات اللاتي يتراسلن مع صديقاتهن ولكن لا ينتبهن لأطفالهن؛ أو الأزواج الذين ينشغلون بالألعاب على هواتفهم ويتجاهلون كل ما يحيط بهم؛ أو أطفال متصلين بعالم من وحدات البكسل بدلاً من التعرّف على العالم الحقيقي أو اللعب مع أصدقائهم الحقيقيين. قد نقول إن العالم الحديث قد خلق ظروفًا يتمتع فيها الشخص بميزة واحدة فقط من ثنائية الحرية والمسؤولية، متجاهلاً تمامًا الجانب الثاني. في عالمنا الجديد الشجاع، لا أحد يتحمّل مسؤولية أي شيء! على سبيل المثال، يمكننا حذف تعليقاتنا في أي وقت - مما يحرّرنا من المسؤولية عن عواقب كلماتنا. جنبًا إلى جنب مع الآخرين (كتلة غير معروفة ومجهولة الهوية)، فإننا نروّج لأحداث معينة ونعبّر بالصوت عالياً بالموافقات أو الإدانات، لكننا لا نأخذ في الاعتبار التحقّق من البيانات.
تنتقل عادة التصرف بهذه الطريقة في العالم الافتراضي في النهاية إلى العالم المادي: نبدأ في الاهتمام حصريًا بالغلاف الخارجي، متناسين العالم الداخلي والقيم الأخلاقية. نحن "معتزلة" القرن الحادي والعشرين.
أنت لا تعرف ما تملكه حتى تفقده
لقد تحوّلت حياتنا إلى مجال الافتراضية والتكنولوجيا، ميزتها العزلة عن الناس والطبيعة وأنفسنا. ومع ذلك، في عام 2020، واجهت البشرية مشكلة غير مسبوقة في العقود الأخيرة من التقدّم المستمر. أجبرنا فيروس كورونا على إعادة تقييم حياتنا وقيمنا. حتى ذلك الحين، كنا نبحث في الغالب عن فرصة للجلوس بشكل مريح على الأريكة بينما يمكننا السفر بحرية عبر الفضاء الافتراضي. ولكن بعد أن حصلنا من كوفيد على فرصة الدراسة أو العمل من المنزل، أو التواصل مع الأصدقاء عبر الشبكات الاجتماعية ومؤتمرات الفيديو، أو حضور المسرح بملابس النوم الخاصة بنا، اكتشفنا أننا نفتقر بشدة إلى التواصل المباشر. لذلك يذهب البعض منا الآن بكل سرور للتنزّه في الحدائق، والجلوس مع الأصدقاء في المقاهي، وحتى الرغبة في العودة إلى المكتب، حيث يدعونا زملاؤنا "الجسديون" لشرب القهوة.
الحقيقة هي أنك لا تعرف ما لديك حتى تفقده.. لقد فقدنا العالم الحقيقي، حتى سئمنا من أجهزة الكمبيوتر والأدوات الخاصة بنا. ومن الغريب أن فيروس كورونا قد أعاد شعبية المنتزهات والمشي لمسافات طويلة والنزهات. المتنزهات لم تمتلئ بهذا العدد الكبير من الناس منذ وقت طويل.
في مقال لمجلة "الفلسفة الآن" (العدد 143 لعام 2021) بعنوان "الحقيقة والاغتراب في عالم كوفيد''، أشار أليكس دويل إلى أنه عندما حاول فهم الموقف الذي وجدت فيه البشرية نفسها في 2020-2021 مع وباء فيروس كورونا، عاد إلى موضوع الانفصال: عن الطبيعة، عن الآخرين، عن الذات. جادل بأن تطبيق زووم لا يمكن أن تحلّ محل الاتصال المباشر بين الناس، ولا يمكن لأي صورة أن تحل محل المنظر الحقيقي من قمة جبل. من خلال قطع اتصالنا الجسدي، يعرّض الوباء للخطر ليس فقط صحة رئتينا، ولكن أيضًا صحتنا العقلية. بعد كل شيء، فإن هيمنة التقنية على مجالات الاتصال، والعمل، والتجمعات الودية، والخدمات الكنسية، وحتى التفاعل مع الطبيعة، قد حرمت الفرد من خصائصه الأساسية، حتى لو كانت تفصله عن العالم الحقيقي.
لكن ربما ساعد الوباء المزيد من الناس على إدراك أنه لا يمكننا التقاط الجمال واللحظات الفريدة من نوعها في العالم الطبيعي رقميًا. لن تجعلنا أي صورة نعيش الأحاسيس التي نختبرها في لحظة تأمّل مباشر. يمكن قول الشيء نفسه عن حياة الشخص: بغض النظر عن عدد الصور المذهلة التي نلتقطها، فإن حياتنا ليست هناك، بل تكمن في "هنا والآن"، أي اللحظة الراهنة. يمكن أن تذكّرنا الصور بحياتنا الماضية، ويمكن أن تجعلنا نفكّر في سيولة الحياة؛ لكنها لا تمثّل الحياة نفسها. على العكس من ذلك، نحن بحاجة إلى استيعاب كل لحظة بشكل كامل، والشعور بالقلق، والكفاح، والعيش. يجب أن نتوقّف عن النظر إلى حياتنا بشكل أساسي من خلال شاشات الأجهزة والكاميرات، وأخيراً نفتح أعيننا ونشعر بوجودنا بتنوعه الثري؛ لأنه لا توجد تطبيقات محرّر صور يمكن مقارنتها بعظمة وجمال الطبيعة والحياة نفسها.
لا تَعْرِض تفاصيل حياتك
في الفصول الدراسية وفي وسائل النقل العام وفي المقاهي وفي الشوارع وحتى في المواعيد، نرى الناس ينظرون باستمرار إلى الشاشات. إنهم يتحوّلون إلى كائن افتراضي، لا ينتبهون لأصدقائهم، أو ابتسامة أحد المارة، أو ألوان قوس قزح في السماء الممطرة. لكن الذوبان في الكتلة الافتراضية، مع الرغبة في إرضاء الجميع -لكسب ما يعجبهم ومتابعتهم بأي ثمن- يتحوّل الفرد إلى بديل؛ شبح لا يعيش بل يشتغل. خلال فترة الفيروس التاجي، تم تحديد تفاهة الإنسانية وتقنياتنا بوضوح في سياق العواقب الوخيمة للنشاط غير المسؤول والاستخدام غير الكفء للتكنولوجيات. إنه دواء رهيب، لكنه ربما سيساعد البشرية على إعادة التفكير في اتجاهها وقيمها وموقفها من الطبيعة. يجب التأكيد على أن المشكلة ليست أن الناس يحاولون جعل بيئتهم أكثر راحة: بل لقد توقفنا عن ملاحظة الجمال في الأشياء، أو عن تقدير عظمة الطبيعة. تتحوّل الطبيعة مرة أخرى إلى موضوع للنشاط البشري يمكن استخدامه لأغراض خاصة دون القلق بشأن العواقب.
بدلاً من ذلك، علينا أن ندرك مرة أخرى أن التفرّد يتغلغل في العالم الطبيعي. كل لحظة غروب، كل سحابة، كل ورقة شجر هي فريدة من نوعها. ولكن بدلاً من الاستمتاع بهذا التنوّع، يحاول الناس فرض نظام وتطابق على العالم عبر تقزيمه في إطارات وخوارزميات، من خلال تحويله إلى صور. نحن نعلن بإصرار أن الإنسانية هي حاكمة العالم ونمجّد أنفسنا، ولكننا لا ندرك أننا نجعل من أنفسنا، لا أسياد الطبيعة، بل طفيليات وأعداء لها. لذلك يجب أن نعيد الإنسان إلى نفسه وإلى الطبيعة.
وبالتالي يبدو أن الطريقة الوحيدة لنعيش حياتنا بشكل أصيل هي إخفاء حياتنا: عن الآخرين، عن الشبكات الاجتماعية، عن القيم الشبحية التي تفرضها الجماهير المجهولة الهوية على الفرد - للعيش، وفقًا لفهم هايدجر لهذا المصطلح: الاستماع لذاتنا، الشعور بجوهرنا، والخشية من الموت... هذا "العرض" لن يتوقّف أبدًا على عكس حياة المرء. فهل العرض يستحق كل هذه التكلفة؟
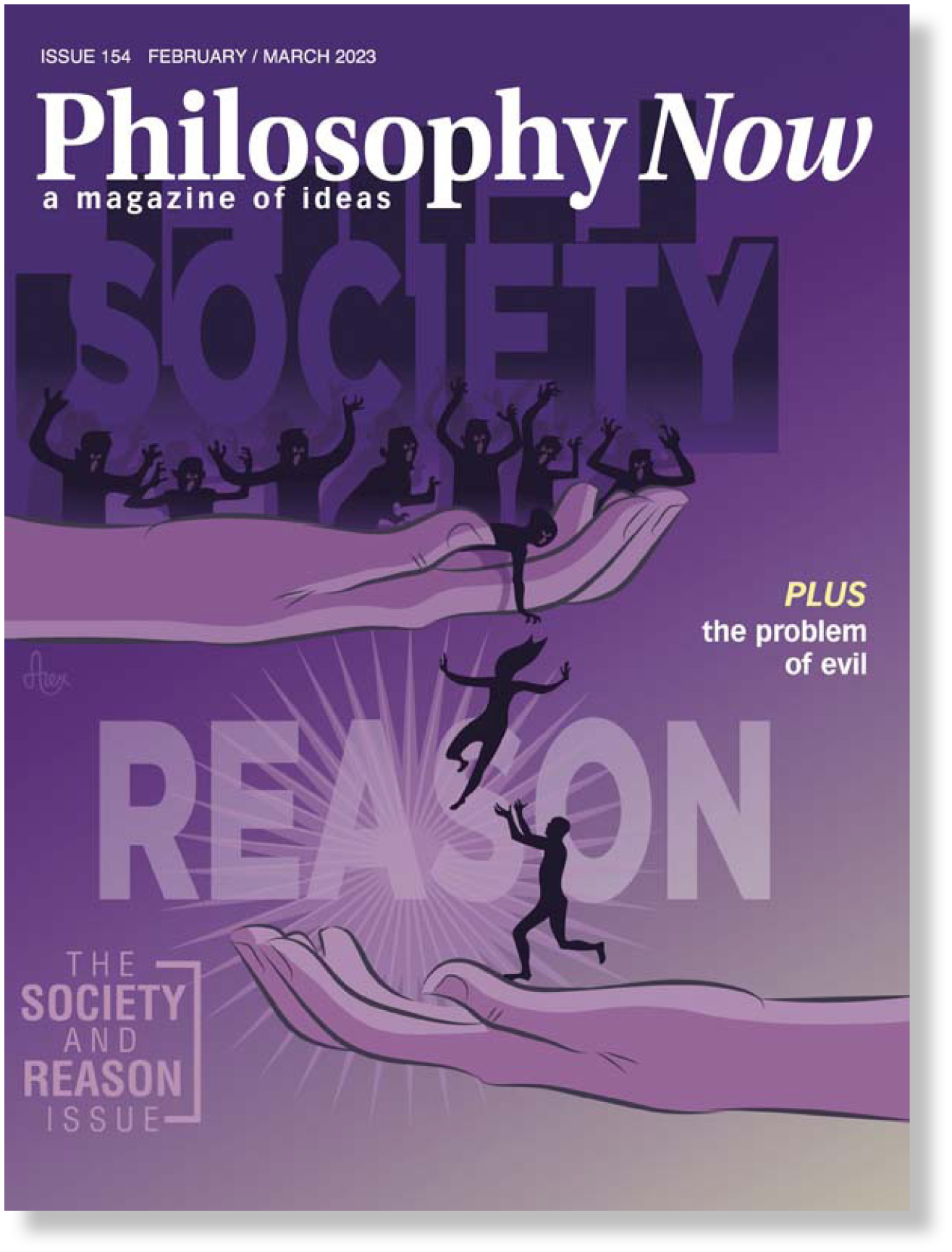
المصدر: مجلة Philosophy Now عدد فيفري/مارس 2023.