بعد مرور أكثر من قرنين على ابتداع لويس كارول Lewis Carroll))1 لرائعتيه العجابيتين، ها هو ذا لوتشيانو فلوريدي (Luciano Floridi) -أستاذ فلسفة وأخلاقيات المعلومات في جامعة أكسفورد- يستقدم "آليس" من غيابات "بلاد العجائب" وغياهب "غابة المرآة"2 إلى "فضاءات التعلم الإلكتروني"، بقصد اختبار فرضياته عن "الثورة الرابعة"3 (The 4th Industrial Revolution) وكيف يعيد عصر المعلومات تشكيل الواقع الإنساني4؟

1. عصر المعلومات: براديغمات مستجدة
ينطلق لوتشيانو فلوريدي من مسلمة مفادها أن التعلم يتعلق باكتساب المعرفة وطرق تنميتها، بيد أن المعرفة "لا تشمل فقط الاكتساب الضروري للحقائق والمعادلات، ولكن تشمل أيضاً فهم القيم والتفسيرات وتثمينها، وأساليب المعيشة والتقاليد، والقدرات والمهارات"5. قد تبدو القائمة غير مكتملة، غير أننا في المحصلة نجد بالضرورة تفاعلاً بين المتعلم ومتعلقات سيرورة التعلم. وما دام الاقتران حاصلاً بين التعلم والمعرفة؛ فإنه من اللازم عندما تتغير مسالك المعرفة أن يقتفي التعليم أثرها ويحذو حذوها.
في هذا السياق يعتقد فلوريدي أن مجتمع المعرفة في الوقت الحالي يشهد "نمواً معرفياً هو الأسرع في تاريخ البشرية؛ إنه نمو نوعي وكمي، في كل من النطاق والوتيرة (اتساعاً وسرعة)"6. ويبدو أن هذا التسارع قد أفرز إرباكاً ملحوظاً في تصوراتنا للتعليم وفلسفة تنضيد النظم التربوية. في سياق التعليق على هذا الإرباك كتب فلوريدي: "كان أحد ردود الأفعال الشهيرة الذي انتشر على نطاق واسع هو محاولة تحويل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من كونها جزءاً من المشكلة إلى أن تكون جزءاً من الحل، وهذا مثمن، ولكنه مُشَتِّت. إن التحدي الحقيقي للتعليم في مجتمعات التأريخ المفرط هو بشكل متزايد ماذا نضع في المناهج التعليمية وليس كيف ندرسه؟"7. قد يبدو هذا الزعم وجيهاً بالنظر إلى وفرة المساقات على شبكة الإنترنيت وازدهار سوق التعليم الإلكتروني وإتاحة مخزون هائل من المحتوى التعليمي لملايين الطلاب. فمنذ أواخر الثمانينيات من القرن الفارط صار أنصار التعلم الإلكتروني متحمسين لما بات يعرف باسم مووس MOOs (نظم الواقع الافتراضي على الإنترنيت القائمة على النص، والذي يتصل به آنيا عدة مستخدمين)، والنصوص التشعبية (Hypertexts)، ونظم الواقع الافتراضي التي تستخدم القفازات والنظارات، وهايبركارد (HyperCard)، والحياة الثانية (Second Life)، والآن المقررات (المساقات) الهائلة المفتوحة عبر الإنترنيت (مووكس) (Massive Open Online Courses) (MOOCs)، وما سيعقبها من طرازات واختصارات. وبالرغم من كل هذا فإن المأزق الحقيقي هو سؤال: "ماذا؟"، وليس: "كيف؟"8. إن صيغة "المأزق الحقيقي" تحيل -بما لا يدع مجالا للشك- على أن الإجابة عن سؤال "ماذا؟" (المتعلق بالتعليم في مجتمعات عصر المعلومات) يظل ضبابياً وصعباً للغاية. ليس فقط "لأننا لم نعش هذا العصر من قبل"، ولكن وبالإضافة إلى ذلك أيضاً لأن الإجابة ما تزال مرتبطة بسؤال آخر، هو "لماذا التعليم"؟ للجواب عن هذا السؤال يلوذ لوتشيانو فلوريدي بحكاية "آليس" قصد استثمار أبعادها التمثيلية.
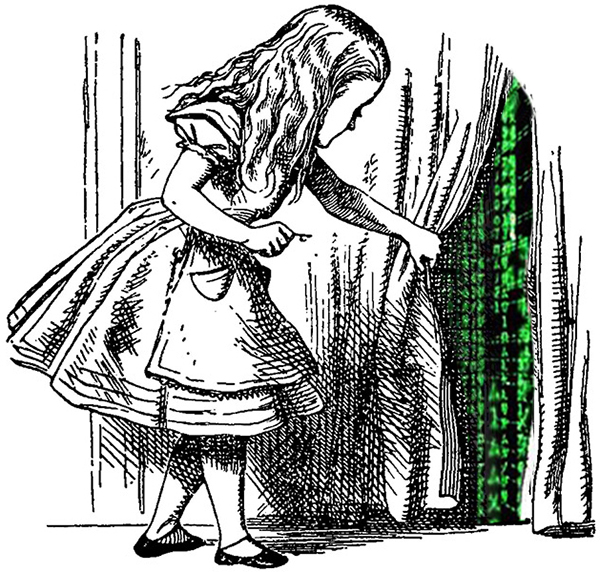
2. آليس في عصر التعلم الإلكتروني
يفترض فلوريدي أن "آليس" في عصر التعلم الإلكتروني تمارس لعبة مطاردة الوحش على الحاسوب. مبدئياً، ثمة أشياء تعرفها "آليس" مثل أن هنالك وحشاً مختبئاً (هذه معرفة تمتلكها)، وثمة تفاصيل أخرى تعرف آليس أنها لا تعرفها، مثل المكان الذي يختبئ فيه الوحش، وهذا ما يدفعها إلى البحث عنها (هذا افتقار إلى المعرفة، أو ببساطة افتقاد للحكمة). وثمة مزيد من التفاصيل التي ليست متأكدة تماماً أنها تعرفها، مثل هل الأسلحة التي في حوزتها فعالة بما يكفي للفتك بالوحش، وهذا هو السبب في أنها تحاول الحصول على مزيد منها، (هذا معرفة تندرج ضمن منطقة عدم اليقين). وثمة أشياء لا تعرف آليس أنها لا تعرفها، مثل أن هناك سيفاً سحرياً يمكن أن يقتل الوحش، (هذه معرفة مجهولة لديها).
من زاوية تحليل معلوماتية، يترجم فلوريدي حكاية مطاردة آليس الافتراضية للوحش على النحو التالي:
1. معرفة: معلومات تمتلكها "آليس" (هنالك وحش).
2. افتقار إلى الحكمة: معلومات تدرك آليس أنها تنقصها (أين يختبئ الوحش)؟
3. عدم يقين: معلومات تدرك آليس أنها ليست على يقين منها (هل الأسلحة التي في حوزتها فعالة وكافية للفتك بالوحش).
4. جهالة: معلومات لا تدرك آليس أنها تنقصها (لا تعلم أنه ينقصها معرفة أن هناك سيفاً سحرياً يمكنه القضاء على الوحش).
وفق هذا التحليل المعلوماتي؛ فإن هدف التعليم هو: زيادة (1)، وخفض (2) و(3) و(4).
بخصوص العنصر (1)، ومع فيض المعلومات التي تغمر حياتنا، ومن ضمنها المساقات الهائلة المفتوحة عبر مووكس (MOOCs)، واعتماداً على المشاركة التفاعلية والوصول السلس إليها من خلال الويب، يصير من السهل زيادة المعارف الأساسية كمياً ونوعياً بحسب احتياجاتنا التعلمية.
أما بخصوص العنصر (2)، فمن اللازم أن نتعلم حدود معرفتنا، وما نوع المعلومات التي نحن بحاجة إليها، وبالتالي الأسئلة الفطنة التي يتعين طرحها من أجل استكشاف ما نجهله.
أما فيما يتعلق العنصر (3) فمن اللازم أن نكون في سياق السيرورة التعليمية حذرين بخصوص ما نعتقد أننا نعرفه ونثق فيه. وفي هذه الجزئية نستحضر أهمية التفكير النقدي وفن التشكيك ومهارات التمحيص والتدقيق. فليس فينا من هو معصوم من الخطإ أو منزه عن الزلل. ويبقى الفرق في مدى استعدادنا لاستكشاف أخطائنا وعدم الاستسلام بكل اليقين والاطمئنان غير القابل للنقد أو الدحض لمعارفنا.
أما العنصر (4) فهو مشكلة خاصة وسياقية. وعليه فلا يمكن توصيفه إلا بحسب خصوصيته وسياقيته. وفي حالة آليس المذكورة آنفاً، حيث لا تعرف ما الذي ينقصها، فهي في أمس الحاجة لحكيم يخبرها أنها تفتقر إلى بعض المعلومات عن وجود سيف سحري، بحيث يمحو حالة معينة مما لديها من جهالة. وهذا هو "ما يمكن أن يقوم به التعليم الإلكتروني المعولم والعابر للحدود والجغرافيات التعليمية والحواجز الأكاديمية. إن التعليم الإلكتروني -وفق رأي لوتشيانو فلوريدي- "لا يمكنه محو جهل البشرية، ولكن يمكنه أن يضع كل إنسان على جانب واحد من الفجوة نفسها"9.
في كل ما مضى ثمة مشكلة تظل منتصبة في طريقنا تنتظر حلاً. ما الذي يتعين أن تتعلمه آليس، الحقائق أم المهارات؟ يتساءل فلوريدي: "هل الأكثر أهمية هو تعليم "آليس" أن الوحش له سبعة رؤوس، وأنها تحتاج إلى الفتك بتلك الرؤوس بالترتيب حتى تقتل الوحش؟ أم تعليم "آليس" كيفية الفتك بالرؤوس السبعة للوحش؟"10. عملياً، يبدو أن الدفع في اتجاه الاختيار القسري بين قطبي هذه الثنائية يستضمر بعض التضليل؛ لأن آليس سوف تحتاج في الآن ذاته إلى معرفة الحقائق "تعرف أنَّ: Know-that"، ومهارات التنفيذ "تعرف كيف: Know- how"، وإلا فإنها لن تفوز في اللعبة. قد يساجل البعض مستهيناً قائلاً: إن فيضاً من المعلومات بخصوص "تعرف أن" على بعد نقرة واحدة، لذا يتعين تصريف الجهد ناحيةَ الدراية بالتطبيقات؛ أي: "تعرف كيف". غافلاً عن أن تفضيل كفة الدراية بالتطبيقات لن يرسخ إلا "ثقافة المستخدمين والمستهلكين فقط، بدلا من ثقافة المصممين والمنتجين أيضاً"11. وعليه، فإنه حتى عندما يتعلق الأمر بخيار "تعرف كيف" فإننا نكون في أمس الحاجة إلى توجيه مزيد من الاهتمام إلى ما بات يعرف بمعرفة الصانع (Maker’s knowledge)؛ وهي "المعرفة التي يتمتع بها أولئك الذين يعرفون كيفية تصميم وإنتاج المصنوعات اليدوية؛ أي أولئك الذين لديهم معرفة كيفية إيجاد المعلومات وتصميمها وتحويلها"12. وإذ يبدو هذا مطلباً مستعصياً في ظل ثقافة طالما تأسست على الفجوة اليونانية المتأصلة بين إبيستيم (Epistime) "العلم النظري أو المعرفة الذهنية" التي تصنف ضمن التفكير العالي في برج عاجي أومقصورة فاخرة، وبين التطبيقي أو التقني أو الفني المرتبط بـ"الدراية والمهارات التطبيقية" ذات القيمة الثانوية وفق تراتبية نمطية رسختها الصورة الذهنية عن المهارات الحرفية والتكوين المهني في كثير من مجتمعاتنا.
أما بالعودة إلى حكاية "آليس في عصر التعلم الإلكتروني" فإنه يتعين التأكيد على أن الثنائية السابقة (المعرفة النظرية أو معرفة البرج العاجي أو المقصورة الفاخرة، والدراية التطبيقية أو مهارات المستخدم أو المنفذ) تظل قاصرة؛ لأن كليهما يضع آليس في دائرة المستهلك للمعلومات فقط، ولا ينظر إليها بوصفها منتجاً. لذا يتعين في عصر المعلومات أن يوجه الجهد صوب ما أشرنا إليه سلفاً بمعرفة الصانع (Maker’s knowledge)؛ ذلك أن "جزءاً مهماً من العمل الحقيقي للتعليم يجري على مستوى مصمم اللعبة"13. وهكذا نتجاوز قصور الثنائية التعليمية السابقة بالانتقال إلى منظور ثلاثي المطالب:
1. أن تتعلم "آليس المستخدمة" كيف تنفذ لعبة المعرفة التطبيقية بكفاءة مهنية.
2. أن تتعلم "آليس المفكرة" كيف تلاحظ وتفهم وتدرس لعبة المعرفة النظرية بدقة تجريدية وبتفكير نقدي.
3. أن تتعلم "آليس المصممة" -ولعل هذا هو الأهم- كيف تبتكر اللعبة وتصممها وفق ما تقتضيه احتياجات عصر المعلومات.
خاتمة
ملاك الأمر ومحصلة القول بالنسبة إلى "آليس في عصر التعلم الإلكتروني" هو أن الاستثمار في المطلب الثالث هو "الاستثمار الأفضل"14، بيد أن هذا الاستثمار لا يكون إلا من بوابة "لغة البرمجة" و"هندسة المعرفة" وما تستلزمانه من تفكير ابتكاري وخوارزميات ورياضيات ولغات طبيعية وصناعية وغرافيك وفن إبداعي وخيال علمي وتصور شبكي... ولا شك أن آليس الفطنة والمشتعلة شغَفاً القادمة من غيابات "بلاد العجائب" وغياهب "غابة المرآة" إلى عصر المعلومات، ومعها الجيل الذي هو من صميم هذا العصر، لا بل قد تخلَّقَ في رحمه، لقادرون على كسب هذا الرهان إذا ما أتيح لهم أن يسلكوه منذ مراحل تعلمهم المبكرة في مدارس تضع نصب أعينها أن "مجتمع المعلومات هو مجتمع تصنيعي حديث، المعلومات فيه هي المادة الخام التي ننتجها ونشغلها وهي أيضاً المنتج النهائي الذي نستهلكه"15.
الهوامش
1. كان لويس كارول (واسمه الحقيقي تشارلز لوتفيدج دودجسون Charles Lutwidge Dodgson) يشتغل أستاذاً للرياضيات بكلية كريست تشيرش بجامعة أكسفورد (Christ Church d'Oxford)، لكنه كان في الوقت ذاته مولعاً بهواية الحديث مع الأطفال. ويبدو أن ذلك كان مصدر إلهام بالنسبة إليه من أجل إبداع رائعتَيْه "آليس في بلاد العجائب " (Alice in Wonderland)، و"آليس في المرآة" (Alice Through the Looking Glass). أما "آليس" فهي ابنة هنري جورج ليدل (Henry George Liddell) عميد الكلية. وقد كان كارول ينفق الساعات الطوال معها رفقة شقيقاتها، يحكي لهن حكايات تخييلية شيقة من بنات أفكاره... بعد العودة من إحدى النزهات، أصرت الطفلة آليس على أن يُدَوِّنَ لويس كارول ما حكاه لها. استجاب لطلبها، وكتب الرواية بخط يده. بعد مدة، وقعت النسخة المخطوطة بين يدي الروائي هنري كنجزلي (Henry Kingsley)، حين كان في زيارة للعميد هنري ليدل وقرأها. أعجب بها، وحث لويس كارول على نشرها. فصدرت الطبعة الأولى من رواية "آليس في بلاد العجائب" سنة 1865. فذاع صيتها وانتشر صداها في الآفاق. وكان ذلك باعثاً على كتابة الجزء الثاني "آليس في المرآة"، سنة 1871. وحين توفي لويس كارول في العام 1898 كانت الروايتان من أشهر كتب الأطفال في إنجلترا، وبحلول العام 1932، صارتا من أشهر كتب الأطفال في العالم. تنظر السيرة الذاتية للويس كارول في نهاية رواية "آليس في بلاد العجائب، وآليس في المرآة، تأليف لويس كارول، ترجمة سهام بنت سنية وعبد السلام، مراجعة سارة بنت نهاد وعناني، دار التنوير، بيروت، ط1، 2013. ص: 361-362.
2. كتب لويس كارول (Lewis Carroll) في مستهل الفصل الأول من سرديته العجائبية، على لسان آليس " (Alice) وما الفائدة من كتاب لا صور فيه ولا حوارات؟" (رواية آليس في بلاد العجائب، لويس كارول، ترجمة شكير نصر الدين، المركز الثقافي العربي، ط1، الدار البيضاء، 2012، ص: 5). محيلاً على زفرة امتعاض ممض من سطوة الضجر على ممكنات حلم طفولي يأبى الحصار والانحسار.
إن الكتاب الذي تطلعت إليه "آليس" بضجر -وهو بين يدي أختها، فلم يَرُقْها دَرْبُه، ولم يشغفها حُبُّه- كان في الأصل كتاباً لا صور فيه ولا حوارات، لا إمتاع فيه ولا إقناع. وبدا لها أن "متعة صنع باقة من الأزهار تستحق عناء النهوض ثم المشي لاقتطافها" (أليس في بلاد العجائب، لويس كارول، ترجمة شكير نصر الدين، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 2012، ص:5). فصارت خطواتُها الجوَّالة نحو شيء يصيب شِغافَ قلبها، ويوافق هَوًى في دواخل نفسِها، بدايةَ السير نحو الارتقاء إلى التعلم الاستكشافي الجوال، واستقراء المخبوء تحت السطح، سواء في غيابات "بلاد العجائب"، أو في غياهب "غابة المرآة".
3. استُخدمت كلمةُ "الثورة الصناعية الرابعة" (The 4th Industrial Revolution) لأول مرة في عام 2016، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، وقد ألف كلاوس شواب (Klaus Martin Schwab) (وهو اقتصادي ورجل أعمال ألماني، يشتهر بأنه الرئيس المؤسس للمنتدى الاقتصادي العالمي) كتاباً بهذا العنوان لتفصيل القول في خواص الثورة الصناعية الرابعة.
4. ينظر: لوتشيانو فلوريدي (2017)، الثورة الرابعة: كيف يعيد الغلاف المعلوماتي تشكيل الواقع الإنساني؟ ترجمة: لؤي عبد المجيد السيد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.
5. لوتشيانو فلوريدي، ص: 112. / 6. المرجع نفسه، ص: 113. / 7. نفسه. / 8. نفسه، ص: 114. / 9. نفسه، ص: 116. / 10. نفسه. / 11. نفسه، ص: 117. / 12. نفسه، ص: 117. / 13. نفسه.
14. "التعليم الاستثمار الأفضل" هو عنوان أحد فصول كتاب بيل غيتس (1998)، "المعلوماتية بعد الإنترنيت، طريق المستقبل". تنظر: بيل غيتس (1998)، المعلوماتية بعد الإنترنيت، طريق المستقبل، ترجمة عبد السلام رضوان، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت. ص: 255.
15. لوتشيانو فلوريدي، ص: 117.