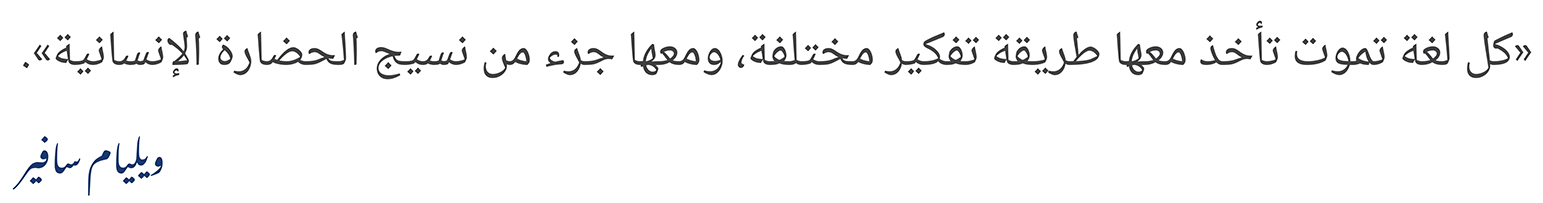
يحكي لنا التاريخ البشري، أن هناك لغات كانت تروى بها قصص أجيال كاملة، لغات حملت في جعبتها أسرار الطبيعة وحكمتها، لغات كانت تنبض بالحياة وتنبض بها الحياة في حكايات الجدة وأغاني الأطفال، لكنها اليوم صامتة، غائبة عن الوجود. فموت اللغة ليس مجرد اختفاء للأصوات والكلمات، بل هو خفوت وانطفاء لمصدر من مصادر الهوية والذاكرة الإنسانية. فاللغة ترتبط بأهلها قوة وضعفاً، ففي كل مرة تندثر فيها لغة ما، يضيع جزء من التراث الثقافي والروحي لشعب ما، وتضيع معه آلاف السنين من الحكمة المتراكمة.
فالحديث عن موت اللغة واندثارها هو حديث عن فقدان أصابنا جميعاً؛ فقدان التنوع والتاريخ، والقصص غير المكتملة. فكيف ولماذا تموت اللغات؟ وما الذي نخسره حقاً عندما تسقط آخر كلمات لغة في دائرة النسيان؟ يشهد التاريخ.. "أن عدداً كبيراً من اللغات أصابها الضعف بقوة وسيادة، وكم من لغات اختفت حيناً من الدهر لم يكن لها ذكر ولا وجود، بسبب اختفاء أهلها عن مشهد التأثير في الحياة، ثم سرعان ما ظهرت تحتل مكاناً لائقاً في مشهد التأثير بين اللغات، وذلك بسبب عودة أهلها إلى مشهد القوة والتمكين، كاللغة العربية مثلًا".
وهناك لغات أخرى ماتت واندثرت، فلم يعد لها ذكر ولا وجود بسبب فناء أهلها، فلم يبق متحدث واحد يتحدث هذه اللغة، غير أن حركة القوة والضعف للغة أو الاختفاء والموت لا تجري في اللغات خبط عشواء، بل وفق سنة لغوية تنتظم في عوامل وأسباب للقوة والسيادة، من هنا يأتي عرضنا هذا لتسليط الضوء على مشكلة موت اللغة واندثارها، من خلال طرح الإشكاليات المحورية التالية: ما المقصود بموت اللغة؟ وكيف تموت اللغة ولماذا؟ وما أهم الآثار التي يخلفها موت اللغة؟ ثم ما بعض اللغات الميتة واللغات المنقرضة؟ وفي الأخير كيف نتعامل مع هذه المشكلة؟
أولاً: ما المقصود بموت اللغة؟
لقد بدأ الاهتمام بدراسة موت اللغة اندثارها في التسعينيات بسبب موت كثير من اللغات التي درسها علماء اللغة، وتم تأسيس عدد من المؤسسات حينها في أمريكا واليابان لحفظ اللغات.
فموت اللغة "موضوع فرضته علينا العولمة في إطار محاولة الكيانات الكبيرة فرض لغتها على الآخر، وابتلاع كيانات صغيرة واستلاب هويتها اللغوية والثقافية، فأصبحت لغات كبيرة مهددة بالزوال والاندثار"، الذي عرف في المعاجم العربية بالقول: عرفت بيوت القرية اندثاراً: أي اختفاء، ولم يبق لها أثر.
يمر الكائن البشري عبر الحياة بمراحل: الولادة، التطور، ثم الموت، هذه المراحل التي يتسلق الإنسان مراحلها هي المسار الذي يسلكه كل كائن كيفما كان ومن هنا فاللغات مثلها مثل الإنسان، تولد نظراً لأسباب وعوامل وتمر من منطق التطور والارتقاء، منها من يبقى حياً ومنها من ينقرض ويموت، أو بعبارة أصح يختفي وجوده، حيث لاحظ علماء اللغة، أن اللغات توصف بمصطلحات تخص البيئة كأن يقال (لغة منقرضة، متآكلة، محتضرة.. إلخ)، فبدأ البعض بالنظر إلى العلاقة بينهما أي اللغة والبيئة، وبينوا العلاقة بين التنوع البيولوجي والثقافي "اللغوي"، حيث إنهما يعتمدان على بعضهما البعض، إذن ما المقصود بموت اللغة؟
إن إيحاء عبارة "موت للغة صارخة وقاطعة في دلالتها، إذ تحمل أصداء مماثلة لأي عبارة تحوي تلك الكلمة غير المرغوب فيها، "فقولنا: إن لغة ميتة يشبه تماماً القول: إن شخصاً ما ميت، لأن اللغات لا وجود لها دون البشر. تموت اللغة عندما لا يتحدثها أحد".
فمعنى موت اللغة أن استعمالها قد انحسر لدرجة أنها لم تعد متداولة بين الناس، "فإذا كنت الناطق الآخر للغة ما، فلغتك ميتة بالفعل طالما الغرض من اللغة التواصل مع الناس، فعندما تكون أنت الناطق الوحيد للغة ما، فإن معرفتك بهذه اللغة تعد مستودعاً أو أرشيفاً لماضي أمتك اللغوي. إن لم تكن هذه اللغة مدونة أو مسجلة على أشرطة كحال الكثير من اللغات، فستبقى هذه اللغة متعلقة بمصير الأشخاص الناطقين بها"، ففي اللحظة التي يختفي فيها آخر متحدث للغة غير مكتوبة أو مسجلة، فإن هذا الأرشيف سيختفي إلى الأبد، وعندما تموت اللغة قبل أن تسجل بطريقة ما، تصبح كأنها لم تكن شيئاً من قبل، وحسب simon ager:
"من يخسر لغته يخسر عالمه"؛ ونتيجة لهذا، فإن اللغة الميتة هي اللغة التي فقدت الناطقين بها لسبب من الأسباب، إضافة إلى غياب توثيق لها يحميها على المدى البعيد ويرفع فرص إحيائها في ظل اختفاء المتكلمين بها، إذن ما هي الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى موت اللغة، أو بعبارة أخرى، كيف ولماذا تموت اللغة؟
ثانياً: كيف ولماذا تموت اللغة؟
إن موت أي لغة كيفما كان نوعها أو موطنها، يرجع بالأساس لعوامل عدة ومنها ما سبق ذكره في التعريف الأول، أي بموت آخر مستعمل لها، لكن أصحاب التصور الاجتماعي للتطور اللغوي يرون أن هناك أسباباً وكيفياتٍ أخرى يمكن أن تموت بها اللغة، كأن تموت بالتسمم مثلا، ويبدأ ذلك بتسرب رشح من الدخيل من لغات أخرى تحتاج إليه اللغة فتتقبله، بل تحس مع تعاطيها له في البداية بمزيد من الانتعاش والقوة والنشاط يشجعها على تقبل جرعات أكبر فأكبر من هذا الدخيل. ولكن قدرتها على هضم ذلك كله واستيعابه في بنيتها العامة تخونها في النهاية فتسقط من الإعياء، تاركة المجال للبقية الباقية من الدخيل تتسرب إليها بدون أية مقاومة حتى تجهز عليها وتميتها. هكذا ماتت اللغة السريانية في بلاد الشام...".
وكذلك يمكن للغة أن تموت موتاً طبيعياً، من الكبر والضعف والتقدم في السن، ولا بد في هذه الحالة أن يكون المتكلمون بتلك اللغة قد كثروا وتشعبوا، وتباعدت مواطنهم، وأقاموا لهم حضارات متباينة لا يتصل بعضها ببعض إلا من بعيد، فتولد لدى كل منهم لهجة محلية منبثقة من للغة القديمة، ومع مرور الأجيال تندثر اللغة الأم من ذاكرة الأبناء وعلى ألسنتهم تموت، وأمثلة ذلك (السامية الأم، والسنسكريتية، والفارسية القديمة، والجعزية الحبشية، واللاتينية).
وعليه يمكن القول، إن هناك عوامل كثيرة ساهمت في ظاهرة موت اللغة، لذلك فإن تشخيص الحالات المرضية يأتي دائماً معقداً، "ويحاول السوسيولسانيون تحديد عنصر واحد يصلح أساساً لتوضيح الطريق التي بها يتحول الناس من لغة إلى أخرى، ولكن كل هذه المحاولات محل خلاف.
ثالثاً: كيف نتعامل مع مشكلة موت اللغة؟
إن موت اللغة أمر وارد ومطروح ومتوقع بشدة، ما دامت طبيعة الوجود البشري تتسم بالتغير والتطور؛ على جميع المستويات التي تنظم حياة الإنسان وتحكم علاقاته بغيره وبذاته أيضاً.
لذلك فموت اللغة ناتج عن أسباب عديدة مرتبطة بتغير ثقافة الشعوب أو بعلاقة الصراع القائم بين الأمم، فكيف نواجه المشكلة؟ أو كيف نحمي اللغة من الانقراض والموت؟ ومن أين نبدأ؟
"اللغة لصيقة بالإنسان من المهد إلى اللحد، إنها روح جماعية وطاقة فاعلة تبعث الحياة في المجتمعات والأمم بما تحمله من معارف وعلوم؛ فاللغة وعاء الثقافة والدين والعلم".
فاللغة بما تحمله من حمولات وطاقات وأفكار، تكَوِّن هوية الإنسان الأولى، وفقدها يعني فقد الإنسان؛ لهذا فإن الحفاظ عليها لا يتم إلا:
باعتبارها جزءاً من الثقافة:
يكون الوعي بأهمية اللغة بالنسبة للأفراد المتكلمين بها، باعتبارها جزءاً مهماً من تكوينهم الفكري والثقافي، الذي يختزل ماضيهم ويجسد حاضرهم وقد يتنبأ بطبيعة مستقبلهم، إن الكثير مما يشكل هويتنا وذواتنا نعبر عنه بلغتنا "ومن غير الممكن أن يكون المرء عضواً في مجتمع ما إذا لم يتحدث لغة ذلك المجتمع".
من ناحية أخرى، فاللغة كما قلنا "جزء من كل" ما يعني أن الثقافة تضم في طياتها آلاف العناصر المتصلة بحياة المجتمعات وشعائرهم وعاداتهم وطقوسهم وممارساتهم... ذلك أنهم "يمكن لهم أن يكونوا أعضاء في المجتمع الأصلي دون أن يتحدثوا لغته، أو أن يتحدثوها بصورة مختلفة لوجود عناصر أخرى تشكل أساس الهوية الثقافية".
هنا تطرح مشكلة أخرى مرتبطة باللغة المهددة بالانقراض؛ فماذا نفعل إذا كان المتحدثون بها متناثرين هنا وهناك، وغير متصلين بالوطن الأصلي؟
قد تتعدد الأسباب الدافعة إلى ذلك مثل الهجرة الطوعية أو الإبعاد القسري؛ والملاحظ دائماً أن هؤلاء المتكلمين "يرغبون في الحفاظ على إرثهم الأصلي أو إعادة اكتشافه..."، في حين قد يكون هؤلاء يتحدثون لغة مجتمعهم أو لا يفعلون لكنهم بالضرورة يرغبون في الحفاظ على ثقافتهم وتراثهم، وكل ما يربطهم بهويتهم ويجعلهم يحسون بها.
وأمام هذا الوضع، تُتخد العديد من التدابير التي من شأنها أن توجه اللغة بشكل سليم وأن تُنشِّط كل القضايا التي تهتم بالثقافة، حيث "يدعو المفهوم الأبرز في اللسانيات الاجتماعية إلى مبدأ [الثقافة أولا]" إذ إن إصلاح اللغة سيكون فعالا أكثر بدعم الوسط الثقافي أو الحاضنة الاجتماعية التي وجدت فيها اللغة، مما يحفز الناس على استخدامها. إن تعزيز دور الثقافة ككل هو شرط أساسي لتعزيز نمو اللغة".
كما يمكن أن نشير إلى جانب مهم وهو جانب:
الدعم المالي:
فما من لغة مهددة بالانقراض أو في مراحل موتها الأخيرة تحتاج إلى دعم مالي من شأنه أن يساعد على جمع هذه اللغة في قاموس أو في معجم؛ وهذا ليس بالأمر السهل فمهمة البحث الميداني تتطلب توفر العديد من الإمكانيات المادية المرتبطة بالسفر والمعدات؛ حيث جاء في تقرير ديكسون: إننا إذا أردنا أن نعمل عملًا جيداً فنحن بحاجة إلى أن يعمل اللغوي الواحد ثلاث سنوات، ولن تكون 200000 ألف دولار كثيرة إذا ما أخدنا في الاعتبار مقدار الراتب ورسوم أتعاب مستشاري اللغة الأصلية والسفر والمعدات...".
هذا يجعل من المال والدعم المقدم من طرف الدولة أو الهيئات الدولية أو المجتمع الدولي، غاية في الأهمية، فمن خلاله يمكن للغة من أن تحافظ على بقائها ووجودها. كل هذا يجب أن يكون متزامنا مع وعي شامل بخطورة الوضع، وضرورة تظافر الجهود لتفعيل كل الطاقات من مبادرات وحملات دعائية وتحسيسية في إطار إرادة سياسية قوية وازنة.
التنوع اللغوي:
إن نشر ثقافة التنوع اللغوي بين الناس والجماهير، من شأنه أن يخلق وعياً بأهمية اللغة وبخطورة أن تكون هذه اللغة مهددة بالانقراض ومعرضة للموت؛ لذلك "وجب تعزيز موقف علني جديد نحو اللغة بشكل عام، ونحو اللغات المهددة بالانقراض على وجه الخصوص".
ويعتبر (دفيد كريستال) أن القيام بهذه المهمة يمر أساساً عبر التحسيس بأهمية التنوع اللغوي، وبقيمة اللغة الأصلية في حد ذاتها؛ واعتبار نقاء اللغة وصفائها ينتج عقلية تخاف التنوع وتقتل الاختلاف والتغير الذي هو سمة تميز اللغات فيما بينها. هذه التوعية تكون ذات أوجه متعددة أهمها الإقبال المتزايد على الشبكة العنكبوتية من أجل تبني رؤية عالمية حول ما يحدث في مختلف البلدان، وحول وضع اللغات المهددة بالانقراض، مما يجعل الناس يحسون بأنهم ليسوا وحدهم في هذا العالم؛ وهذا الشيء قد نعززه أيضاً بتأسيس منظمات دولية وعالمية ترسي التعاون في هذا الشأن. وأروبا مثلا كان لديها "المكتب الأوربي للغات الأقل استخداما 1982".
دور اللساني:
في الأخير يأتي دور اللساني، في محاولة الحفاظ على اللغات المهددة بالانقراض والزوال؛ حيث تكمن المهمة الملقاة على عاتقه في العمل على التشخيص والوصف والتحليل والتدخل أخيراً. كل ذلك من أجل مساعدة المجتمعات على الشعور بالتراث والثقافة التي تتضمنها لغتهم، لهذا فإن "اللسانيين يجب عليهم أن يروا دورهم الأوسع على أنه مساعدة للمجتمع الأصلي؛ كي يفهم ما يتفرد به إرثه اللغوي، وما هي القوى التي تهدد هذا التراث"، في هذا السياق يتوسع (د. كريستال) كثيراً معتبراً أن كل المخاطر التي تهدد اللغات داخل أي مجتمع قد تعرض مهمة اللساني للخطر أيضاً، ولهذا وجب أخد كل الحيطة والحذر ومراعاة الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية. ذلك أن "اللغة تعد عنصراً واحداً داخل نظام بيئي، ومن السهل مهما علت مقاصدهم".
ويعتبر أن ما يقوم به اللساني أثناء البحث الميداني قد تكون له مضامين وحسابات سياسية؛ ذلك أن العمل الميداني "يقدم على شكل مساقات ويحوي تعقيدات منهجية...".
عموماً، إن حياة اللغة وعمرها، مرتبط بوجود مجتمعات تتحدث بها وتوظفها، لذلك فإن المجتمع يساهم بقسط وافر جدّاً في العمل على حفظ اللغة المهددة بالانقراض، لأن موت اللغة خسارة فادحة وقاسية لكل من له علاقة بها، إضافة إلى أن موت اللغة واندثارها ليس مجرد ظاهرة لغوية فحسب، بل هو قضية ثقافية وإنسانية، تتعلق بفقدان جزء من الهوية والتراث. فكلما فقدت لغة ما، يُفقد معها جزء من التنوع الثقافي للبشرية، ولذلك تسعى العديد من المجتمعات والمنظمات إلى الحفاظ على اللغات المهددة بالانقراض وإحياء تلك التي اختفت. وصدق الشاعر محمود درويش عندما قال في إحدى قصائده:
"لقد استبدني هاجس النهاية
منذ أدركت أن الموت النهائي
هو موت اللغة
إذ خيل إلي بفعل التخدير أنني أعرف الكلمات..
وأعجز عن النطق بها فكتبت على ورقة الطبيب...
لقد فقدت لغتي...
أي لم يبق مني شيء".
المراجع:
• محمد محمد داود، اللغة كيف تحيا ومتى تموت، دار النهضة، 1 يناير 2016.
• ديفيد كريستال، موت اللغة، ترجمة فهد بن مسعد اللهيبي، جامعة تبوك، 2006م.
• حسن ظاظا، اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة، دار القلم دمشق، الطبعة 2، 1410هـ 1990م.
• عبد الواحد وافي، اللغة والمجتمع، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة2، 1370ه- 1951م.