يقول الشّاعر المصري عبيد عبّاس عن أدب الطّفل: "جُل مزايا أدب الكِبار هي عيوب في أدب الأطفال"! وهذا -من وجهة نظري- هو التّحدي الخطير الذي يواجه من خَبروا أدب الكِبار، عندما يكتبون للأطفال؛ فالعُمق والتكثيف -كمثال من أدب الكِبار- ينقلبان غموضًا وتعاليا في أدب الأطفال، ولا يعني ذلك أن على أدب الطّفل أن يأتي ساذجًا، تعليميا، مُباشرا، مُلقّنا، خطابيّا هروبا من التصوير والترميز، لكنّ عليه أن يُراعي المرحلة العمرية التي يوجّه إليها. لعلّنا نتفقُ أن لا معايير ثابتة في الكِتابة الإبداعية بمفهومها كإبداع، لكن هناك مقارباتٍ صيغت من قبل الدارسين والمهتمين بالطّفل وصلت بِنا إلى تصوّرات مقبولة حول اختلاف مقدرة الطفل على التلقّي من سن إلى آخر. ربّما أتحفّظ قليلا حول اعتبار بعض كتّاب أدب الطفل تلك التصورات أنماطاً مقدّسة ومحدّداتٍ صارمة للكتابة للأطفال؛ لأننا -حين يتساوى الأطفال في السن- سيختلفون في الثقافة التي أنتجتها البيئة والظروف والتعليم الذي عاشوه.
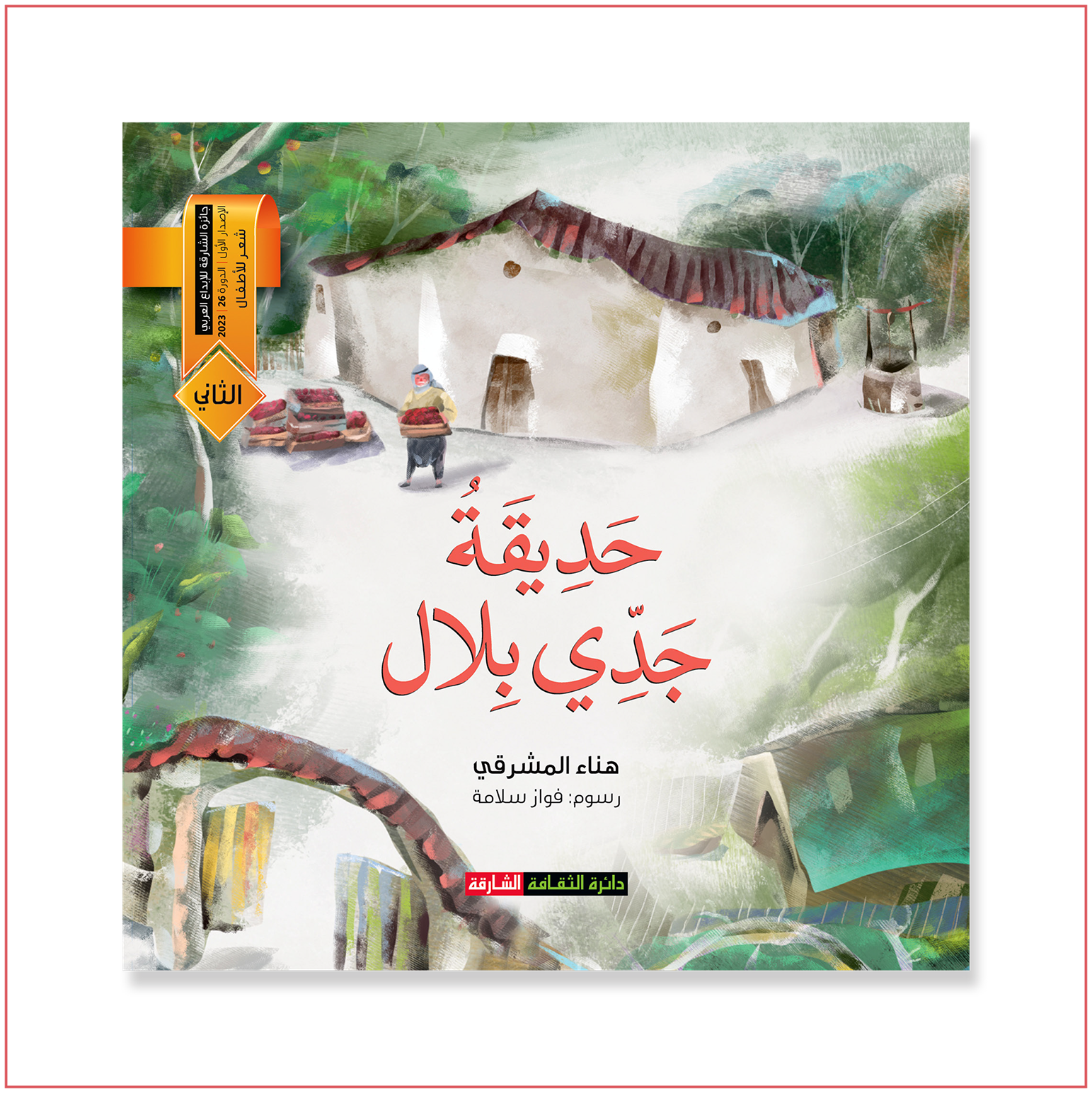
ومن خلال ما سبق، اخترتُ موضوع هذه المقالة القصيرة، وهو "محصّلة قصائد هناء المشرقي في ذات الطّفل"، مهتمّاً فيها بمجموعتها الشعريّة "حديقة جدّي بلال" الموجهة للأطفال من 8 حتى 12 سنة، والصّادرة عن دائرة الثقافة بالشّارقة 2023م. أحاول بيان أثر هذه القصائد في ذات الطفل وتكوين شخصيّته.
في المرحلة العمريّة من 8 حتى 12 سنة، يرى الباحثون أنّ الأطفال يتتبّعون التقاليد الإنسانية والقيم المُستقرّة من حق وباطلٍ، وشر وخير.. إلخ، وفي هذه المرحلة تتجلّى مفاهيم الصداقة والأخوّة. وفي هذه المرحلة أيضا ينتقل الطفل إلى الخيال القريب من الواقع، ويصبح تفكيره أكثر نضجاً، ويجنح الطفل في هذه المرحلة إلى المغامرة نظراً لتوقه إلى المعرفة وفهم الحياة. وقد توصّلتُ من قراءتي لكتاب الشعر "حديقة جدي بلال" إلى وجود محصلة وأثر تربوي حقيقي على ذات الطفل، وبناء شخصيّته من خلال استثمار عناصر الشعر الفنيّة لتشكيل القيم التربويّة والأخلاقية للطّفل.
تباينت قصائد الكتاب بين المتوسّطة الطول والقصيرة (25 قصيدة)، وتجنّبت القصائد الطويلة التي لن يكون من المناسب أن يتعامل معها أطفال المرحلة السنيّة 8-12 سنة (مع تسليمنا بوجود الفروق الفرديّة). وقد برزت بشكلٍ لافت إحدى أهم خصائص شعر الأطفال، وهي أن يحمل "الروح الطفوليّة"، حيثُ لم تُثقل الشاعرة القصائد بتصورات الكِبار المركّبة، لقد اختارت الشاعرة الأفكار الصغيرة لتقدّم رسائل كبيرة للأطفال، دون الوقوع في شرك التقريرية والخطابيّة والوعظ المُباشر؛ فالأطفالُ أيضاً ينفرون من الأوامر المُباشرة، خصوصاً وأن السنّ المذكورة- من ناحية نفسية وتربوية- يميلُ فيها الطّفل للانطلاق وإظهار بعض الشجاعة والمغامرة، وهو أكثر نضجاً، وبالتالي تقلّ حاجته للوعظ والإرشاد المُباشر.
وبحسب سمر دودين: "تقودُنا المراجعة العامة لتعريف عمليّة التفكير الإبداعي وعمليّات الوعظ والإرشاد، إلى اكتشاف أنّهما مساران مختلفان للمعرفة، أحدهما يقوم على المعرفة الإيمانية والتلقينية المُباشرة، التي تعتمد الترهيب والترغيب؛ أي أنّها تعتمد على المسار الذي يتبنّى عمليّة التقويم السلوكي، من خلال أعراف محددة ومعتقدات ثابتة تصبح مرتكزاً للالتزام والممارسة الدينية، أما المسار الإبداعي، فيقوم على التّحرر الفكري الذي يُساعد الكاتب في الهدم والبناء، وأن يسأل ويُسائل بلا خوف". لعلّ التصوّر السّابق يذكّرنا بخطورة الوعظ المُباشر على مُتلقّي الإبداع جنباً إلى جنبٍ مع المُبدع نفسه تشعّ هذه الرّوح الطفوليّة في قصيدة "الطمّاع والدجاجة"، تقول:
فقد كان عند البخيلِ طيورٌ
وقد كان بين الطيور دجاجهْ
تبيضُ له بيضةً كل يومٍ
ومن بيعها يشتري كل حاجهْ
ولكنه ليس يهدأ حتى
يخبئ من ماله في زجاجه
وتمضي القصيدة في تنويع للقافية، وهو ما يخلق جرساً موسيقياً حيويّاً، يختلف باختلاف الفكرة، وينقل للطفل الأثر النفسي بشكل متدرّج لتقدّم رسالة تربويّة ومعرفيّة، حيثُ التأكيد على نبذ صفة الطّمع، فيما تزكّي ضمنياً فكرة العمل والتّجارة المتمثلة في شراء "كل حاجة" بعد بيع بيضة الدجاجة.
كما أن الشّاعرة تجنّبت الوعظ المُباشر من خلال عدّة تقنيّات أثناء عملية الكِتابة، منها اختيار "حدّوتة" أو حكاية تنبني عليها فكرة القصيدة وبنيتها، وقد نعلم أهمية الحكايات في صقل شخصية الطّفل ومُساعدته على استكشاف العالم من حوله، فهي تُقدّم إجابات غير مُباشرة للأسئلة التي تُلح على الطفل في هذه المرحلة العُمرية، تقول في قصيدة "الإحسان للجار":
قالت لي أمي مرّهْ
اذهب للجدةِ "سمرهْ"
ناولها طبق الحلوى
وكذلك هذي الجرّه
هي جارتُنا منذ سكنّا
في هذا المنزل من فتره
لكن يا ولدي صحتها
تضعفُ لا تمتلك القدرة
لا يعرف أحد يا ولدي
عنها ما حبّت.. أو تكرهْ
والحدّوتة في بعض قصائد الكِتاب انقسمت إلى نوعين من حيث مصدرها؛ منها الحدّوتة التي نسجتها الشّاعرة من خيالها ومنها الحدّوتة الرمزية التي تُشكّل تراثاً معرفياً وقيمياً للأطفال، كقصّة السلحفاة والأرنب. إن الاتكاء على الحِكاية الرمزية المأثورة يُحقق أثراً معرفياً وتربوياً مُباشراً في شخصية الطّفل؛ لأنّه يربط الطّفل بمصادر معرفة أُخرى، وبالتالي يُصبح الشّعر بوابة للقصة أو الرواية أو المسرح، ويحقق هذا التّكامل جوّاً من الأثر التربوي والمعرفي يستشعره الطّفل بقوّة مع تعدد مصادره. تقول في قصيدة "الأرنب المغرور":
أتى الأرنبُ اليوم فيمن أتاهْ
يُباهي بسرعته السلحفاه
يقول لها سوف نُجري سباقا
ونجري سويًا إلى منهاهْ..
هذه القصيدة يُمكن أن تكون مثالا على دور نظريّة التلقّي في تحليل علاقة المتلقّي والمُبدع بالنص الأدبي؛ إذْ نجزمُ بمعرفة الطّفل بنهاية هذه القصّة، بحُكم اطلاع وقراءة وتعليم وإعلام سابقٍ تناولها كثيراً كثيراً، لكنّ أفق التوقّع لدى الطّفل هُنا لا محدود، حيثُ يحايثُ القصة في هذه المرّة الإيقاع والقافية وبالتالي يستطيع الطفل أن يحفظَ القصّة التي تعلّمها سرداً في شكل قالبٍ غنائي إيقاعي يحقق للطّفل تطلعاته.
لقد راعت الشّاعرة النسق التربوي الناظم المحوري في أدب الأطفال عموماً من خلال الابتعاد عن استخدام ألفاظٍ مُستهجنة أو تعبيرات موغلة في الرمزيّة، وهو ما يشكّل تشويشاً على الرسائل التربوية في شعر الأطفال.
بدا أن الشّاعرة التزمت السؤال التأسيسي في شِعر الطفل وهو: كيف نكتب للأطفال، وليس ماذا نكتُب للأطفال؟ فاختارت اللّغة المُبسّطة والإيقاعات المُنسابة في "المُتقارب" كمثال، وابتعدت عن البحور الشعريّة التي تطول فيها التفعيلات، فتنتج مللا، أو تختلف فيها التفعيلات، فيفقد الطفل حماسته للاستماع والقراءة المُغناة، وليس هذا بالضرورة هو المسلك الوحيد، فهناك تجارب كتبت شعر الأطفال وفق بحور يختلف فيها تكرار التفعيلات بين شطر وآخر بدافع كسر ما قد ينشأ من رتابة، لكنّ أيا كان البحر الذي سيكتب الشّاعر قصيدته للطفل وفق تفعيلاته، تظلّ اللغة هي التّحدي الأبرز، لقد اختارت الشاعرة الأسلوب الذي يمزجُ الفُكاهة بالفكرة، والعناوين القصيرة التي تلخّص مضمون النصوص ورسائلها، كذلك جعلت من "الحوار" أحد تقنيّات صياغة النّصوص لما يُشكّله من مسحة مسرحيّة دراميّة، تجعل الطّفل في مواجهة الفكرة ونقيضها، وما ينشأ بينهما من صراع متنام، وصولا إلى الحلول التي تصوغ رسائل المعرفة والسلوك والتربية. لقد جاء عنوان المجموعة الشعرية في مُجملها "حديقة جدّي بلال" متصلا ببيئة الطّفل ومستوى اللغة والإدراك، وحقق قدراً كبيراً من الإيحاء وتحفيز التفكير، فضلا عن كونه قصيراً، سهل الحفظ.
هي مجموعة شعريّة في مُحصّلتها تثري الوعي البيئي لدى الأطفال بشكلٍ غير مُباشر، كما أنّها لم تغفل القضايا التّاريخيّة الكُبرى، كالقضية الفلسطينيـة جنبا إل جنب مع قضية صون الوطن. ولا شكّ أن تنويع موضوعات القصائد مكّن الشّاعرة من تحقيق الأهداف المعرفيّة، عن طريق منح الطفل المعلومات والحقائق، والأهداف الوجدانية، عن طريق الصياغة الحوارية الدرامية لبعض النصوص، والأهداف المهارية من خلال تحفيز مهارات التفكير لدى الطفل، وحقّق كل ذلك -في مجمله- أثراً فكريّاً بشكل عام.