انصرف العديد من المؤرخين والباحثين في تاريخ الأدب العربي الذي غدا أحد الفنون الجميلة الستّة، إلى جمع أعمال الشُّعراء والكتّاب العرب، وتحقيقها في دواوينَ ومجاميعَ وسلاسلَ وكُتب، وصنّفوها حسبَ تسلسُلِها التاريخيّ عبرَ العصور، أو حسبَ أغراضها الرّئيسة كالوصف، والمدح، والهجاء، والفخر، والحِكَم، والخطب، والرّسائل وما إليها. توثق جولي مراد في كتابها الصادر عن (الدار العربية للعلوم ناشرون/بيروت، 475 صفحة) أهمّ ما صدر في هذا المجال، وهو كثيرٌ ووافر، حيث تُقدِّمُ المؤلفة للقارئ الذي لم يتسنَّ له الاطلاع كثيراً على كنوز الشِّعر العربي مجموعة عمليّة سهلةُ المنال، فتُلخِّصُ له سيرةَ الشّاعر أو الكاتب، وتختارُ في الوقتِ عينهِ، ما يُميِّزُ عملهُ من مقطوعاتٍ شعريَّةٍ أو نثريّةٍ، مبيَّنةً جدوى وضعها بأسلوبٍ واضحٍ بعيدٍ عن الإسهاب والتعقيد. ومن هنا انبثقت فكرة وضع دراسة تتناول (كنُوزُ الشِّعرِ في تراث العَربَ).
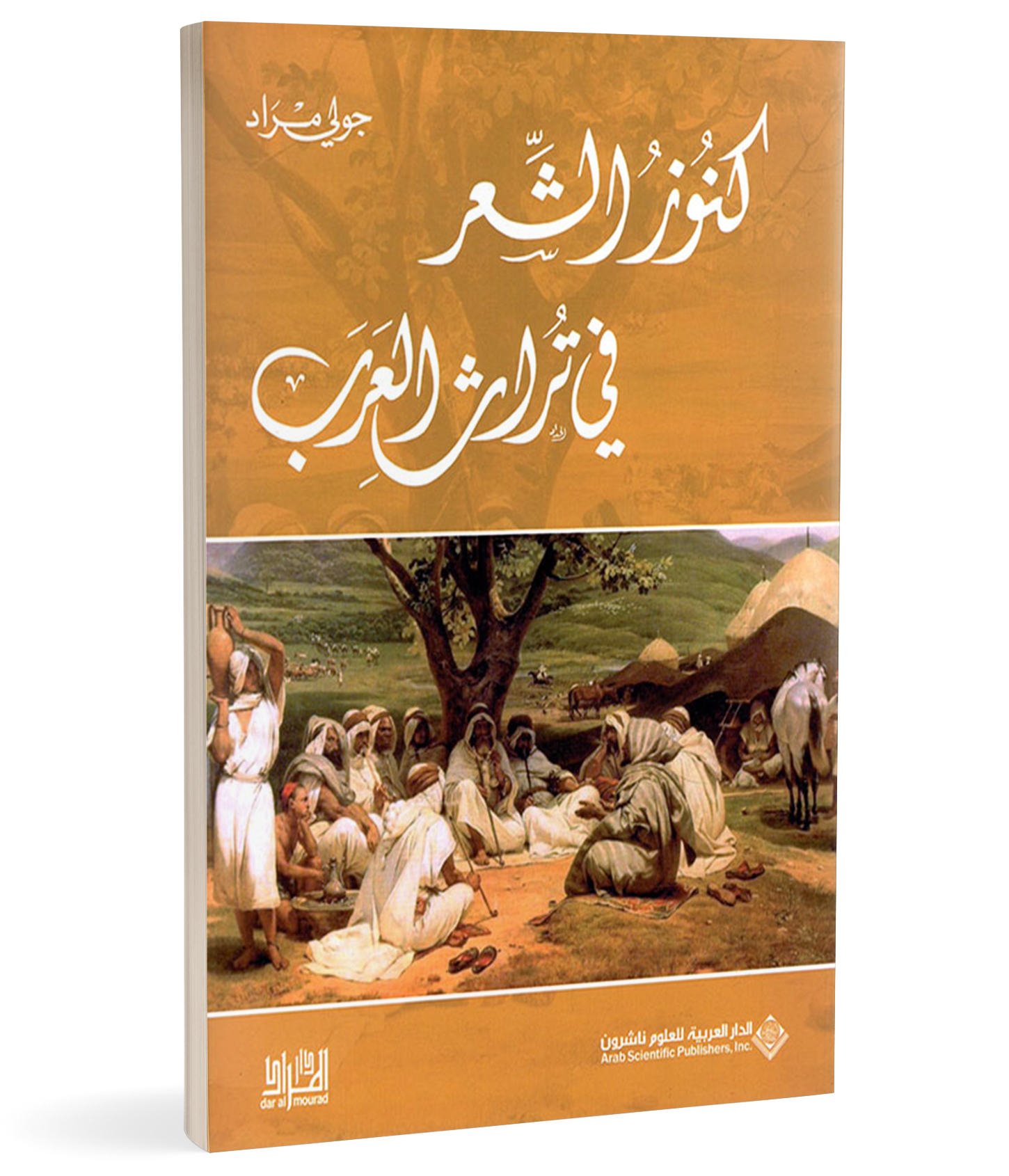
كنُوزُ الشِّعر ... في تُراثِ العَرَب | تأليف: جولي مراد | الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون | مكان النشر: بيروت
تاريخ النشر: الطبعة الأولى، تشرين الأول | أكتوبر 2019. | عدد الصفحات: 475 صفحة.
وبناءً على ما تقدم يحتوي هذا الكتاب منتخبات شعرية من: العصر الجاهليّ -صدر الإسلام- العصر الأُمويّ- العصر العبّاسيّ- الأدب الأندلسيّ- عصور الانحطاط.
الشِّعْرُ في العَصرِ الجَاهِليّ
العصرُ الجاهليّ هو عصر ما قبل الإسلام، وموطنهُ شبه الجزيرة العربيّة ذات المفاوز الواسعة التي تحوط بها، وتتخلّلها جبال وهضاب مختلفة، وقد كانت هذه المناطق ساحات حروب، وميادينَ غزوات، ومرتع أحداث سياسيّة، وظواهر اجتماعيّة، تركت أثراً بالغاً في الأدب الجاهلي شعراً ونثراً. إنّ أرقى ما وصل إلينا من الشِّعر الجاهليّ، لا يعود إلى أكثر من قرنين أو ثلاثة قبل الهجرة... وقد اعتمدت المؤلفة في عرضها لشعراء العصر الجاهليّ، قول المستشرق الألماني (ثيودور نولدكه)، ونصُّه: "لا يوجدُ لدينا بيتٌ شعريٌّ وثيقُ النصّ يُمكن أن يرجعَ إلى ما قبل سنة 500 ميلاديّة" [ص: 11]. حيث انطلقت الكاتبة من أوائل القرن السادس، بدءاً بالشَّنفرى، وتمّ تقسيمه إلى مراحلَ عدّة، ليسهلَ استيعابه، وهو كالآتي: الشُّعراء الصّعاليك: والصُّعلوك هو الفقير الذي لا اعتمادَ له سوى نفسه. والصّعاليك هم مجموعة من الشُّعراء ينتمون لقبائل عدة اتخذوا الصحراء موطناً لهم وتعاهدوا على أخذ المال من الأغنياء وتوزيعه على الفقراء. ومن أشهر هؤلاء الصّعاليك في العصر الجاهليّ، الشَّنفرى، تأبَّط شراً، وعُروَة بن الورد الذي كان يقودُهم ويغزو بهم.
أصحاب المعلّقات: أفضل ما في الشعر الجاهلي هي المعلّقات وعددها سبع، ودعوها بـ((السَّبع الطِّوال))، وقد أضاف إليها الخطيب التبريزيّ في شرحه ثلاثَ قصائدَ للنّابغة، والأعشى، وعبيد بن الأبرص. قيل قديماً إنّ المعلقات كانت تُكتب بماء الذهب، وتُعلّق على أستار الكعبة فيكرّمها العرب، والمقصودُ بالمعلّقات، أنّ أبياتها تستحقُّ أن تُعلَّقَ في الأذهان. أَمَّا أصحاب هذه المعلّقات فهم: امرؤ القيس، طَرَفة بن العبد، زهير بن أبي سُلمى، عمرو بن كُلثوم، الحارث بن حِلِّزة، لَبيد بن أبي ربيعة، وعنترة بن شدّاد.
شعراءُ البلاط: لا بلاطَ في الجاهليّة كما هو متعارفٌ عليه، إلاّ بلاط المناذرة في الحيرة الذين قلّدوا الفرسَ الساسانيّين في بعض مظاهر مُلكهم، وكانت قبائلُ الغساسنة في البلقاء، لا تزالُ أقربَ إلى البدو في منازلها المتعدّدة في سائر الأرجاء. ويتصدّرُ هؤلاء الشعراء النّابغةُ الذُّبيانيّ، الأعشى الأكبر، علقمة الفحل، المتلمّس، المثقّب العبدي، وعديّ بن زيد.
الشُّعراءُ الفرسان: كانتِ القبائلُ تُعظِّمُ شعراءَها الناطقين بمآثرها، فهم العقولُ التي تفكّر، والأصواتُ التي تُنادي بالمفاخر، ومن غلبتْ عليهم صفةُ الفروسيّة بكامل معانيها: المُهلهِل، عامر بن الطفيل، دُرَيْد بن الصِّمَّة، عمرو بن مَعدي كرِب، حاتم الطّائيّ، بشر بن أبي خازم، وغيرهم...
الشِّعْرُ في صَدْر الإسْلام
انبهرَ شعراء صدر الإسلام ببلاغة القرآن الكريم، وهم أنفسهم شعراء العصر الجاهليّ، وقد شُغلوا بالفتوحات، فأُصِيبَ الشِّعرُ في تلك الفترة بالرّكود، وقد حدث تغييراً جذرياً في أسلوبهم جرّاء تأثّرهم بأسلوب القرآن الكريم والحديث الشّريف، فأخذوا يبتعدون عن الجفاء والخشونة والقساوة التي تميّز بها الشعر الجاهليّ، فكان هناك الشعراء المخضرمون الذين ذهب قسمٌ من عمرهم في الجاهليّة فطُرِحَ، وأدركَ الإسلامَ شاعراً، فنظمَ في العهدين وعُرفَ فيهما [ص: 123]. وكان على رأس هؤلاء الشُّعراء شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسّان بن ثابت، الذي كانت له مواقف عظيمة في الدفاع عن الإسلام، وأيضاً منهم: كعب بن زهير، وعبد الله بن رواحة.
أَمَّا الشُّعراء الأمويّون، ففي عهدهم تطور الشِّعر وأخذ مناحٍ كثيرة، كالمديح والهجاء والغزل، وعلى رأس هؤلاء الشُّعراء: الأخطل، الفرزدق، جرير. وفي جميع عصوره، تميّزَ الشِّعر العربيّ بعددٍ من النِّساء الموهوبات، وكان منهنّ في الجاهليّة، إلاّ أنّهنّ لم يشتهرنَ مثل المخضرمات والأمويّات، وفي طليعتهنّ الخَنْساء وهي من أشهر الشُّعراء العرب... ومن أشهر شعراء تلك الحقبة: الحُطيئة، مَعْن بن أَوس، عمر بن أبي ربيعة، أبو محجن الثقفيّ، الخَنْساء، ليلى الأخْيَليّة...
الشِّعْرُ في العَصرِ العبَّاسيّ
يُعَدُّ العصر العبّاسي أطول العصور العربيّة زمناً، فقد امتد على خمسة قرون حتى 656ه، وكانت حاضرته بغداد التي اتخذها الخليفة الثاني أبو جعفر المنصور، عاصمةً لملكه، فأطلق عليها لقب دار السّلام.
ازدهرت بغداد في زمن الخليفة المنصور والخليفة هارون الرشيد وابنه المأمون، حيث تمّ بناء القلاع والجسور، وعمّر مئات المساجد والمكتبات والأسواق، فازدهرت بغداد وغدت من أهم المراكز الحضاريّة في العالم. وجلب هذا التمدُّن معه العلماء والأدباء واللّغويّين الذين اغتنموا هذا الاستقرار السياسيّ والاقتصاديّ، فنشط الرواة، وكثر المؤلّفون، وراجت سوق الورّاقين، وظهر على صعيد الأدب شُّعراء نوابغ اتسم نِتاجهم المنظوم بالفرادة والمتانة والطرافة [ص: 196]. فبلغ الشِّعر ذروته، ونستعرض هنا شُعراء العصر العبّاسيّ الذين عاشوا في حواضر العراق والشام ومصر...
شعراء العراق: قد لا يكون شعراء العراق من الذين نشأوا فيه، أو عاشوا فيه ولم يغادروه إلى سواه؛ وإنما عنينا بهم هم الذين عاشوا في بغداد تحت كنف الدولة العبّاسيّة، أو من تردّدوا إليها ولازموا البلاط، أو قصور الأُمراء والوزراء، سواء كانوا عراقيّين أم لا. لقد انطلقت النهضة الأدبيّة الشعريّة من العراق لتأثرها المباشر بالثقافات الدخيلة ولاسيما الفارسيّة واليونانية. فكان من نواة النهضة الشعريّة العباسيّة وبُناة أركانها، الشُّعراء: بشّار بن بُردْ، وأبو العتاهية، وأبو نُوّاس، وأبو تمّام، والبحتريّ، وابن الرّوميّ، وابن المعتزّ، والشّريف الرَّضى، إلى مِهيار الدّيلميّ [ص: 198]. ولم يكن شعراء الشام أيضاً من مواليدها، فثمّة من سكنها وفيها تفتحت عبقريّته، فحريٌّ أن نعزوه إليها. ومنهم: الصَّنوبريَ، وأبو الطّيِّب المتنّبي، وأبو فراس، وأبو العلاء المعرّي.
أَمَّا مصر فقد خلت من الشُّعراء، إلاَّ في العصر العباسيّ الرابع، حيثُ قرّب الخلفاء الفاطميّون والسّلاطين الأيّوبيّون الأُدباءَ منهم فتكاثروا، ولكن لم يبرع فيهم أحدٌ شأن الأقطار العربيّة. ومن بين هؤلاء الشُّعراء ابن الفارض، والبهاء زهير، وبعض الفرائد كاليتيمة، وفراقيّة ابن زُريق، ولاميّة العجم.
الشِّعْرُ في الأدبِ الأندَلسيّ
نظر مؤرّخو الأدب العربيّ إلى الأدب الأندلسيّ على أنّه نتاجٌ مختلط للأندلسيّين والمغربيّين؛ لأنّ الأدباء كانوا ينتقّلون بين هذين القطرين، وقد تأثروا بالعوامل عينها والمحسوسات ذاتها، فكانت الطبيعة مصدر الإلهام والإبداع والعبقرية الشعرية لهم، فأتت أعمالهم ممهورةً بنفحةٍ متوحّدةٍ، حتّى ليصعبَ تمييز أحدهما عن الآخر [ص: 372]. ومن بين شعراء الأندلس: ابن هاني الأندلسيّ، وابن درّاج القسطلي، وابن شهيد، وابن زيدون، وابن خفاجة، وابن سهل الإشبيلي، ومن المغاربة وقعنا على ابن حمديس الصقلّي.
الشِّعْرُ في عُصور الاِنحِطاط
منذ اكتساح المغول الممالك الإسلاميّة حلّت بها كوارثُ عديدة، وأحداثٌ سياسيّة واجتماعيةّ مروّعة، فباتت مجتمعاتُها ممزّقة، وانطفأت فيها جذوةُ القرائح، ودبّ الفساد في اللغُة الفصحى بانتشار العناصر الأعجميّة، وعمَّت رطانتهم فيها.
وبسط العثمانيّون سيطرتهم على البلاد العربيّة قاطبةً، وألغوا دورَ اللّغة العربيّة، وأحلّوا محلّها اللُّغة التركيّة، وشرعوا يسعون إلى تتريك العرب والقضاء على لغتهم وقوميتهم، فقضوا على ما تبقّى من الفصحى، فهيمنت اللّغة التركيّة على لغة الكتابة ولغة المخاطبات. وهكذا خيّم الانحطاط على اللّغة العربيّة وآدابها، وانحدر الشِّعر في تلك العهود وانصرف الحكام عن إكرام الشُّعراء، فتحوّل الكثير منهم إلى امتهان الحِرف لتأمين مأكلهم. وعلى الرغم من تلك الأوضاع فقد برز شعراء أفذاذ منهم: الشابّ الظّريف، صَفيّ الدّين الحلّيّ، وابن نباتة.
ولهذا الغرض انتخبت المؤلفة أروعَ القصائد التي تُحرِّكُ معانيها فكرَ القارئ ومشاعرهُ، وصدّرتها، وقدمتها، بسيرةِ مؤلِّفيها والمناسبة التي صيغتْ من أجلها. وما على القارئ سوى النّهل من مواردها ما طابَ لهُ، ليكتسبَ معرفةً أعمقَ بتاريخ الأدب العربيّ الذي استمرّ عبرَ أجيال، وينالَ مُتعةَ المطالعة مع روّاده الخالدين.