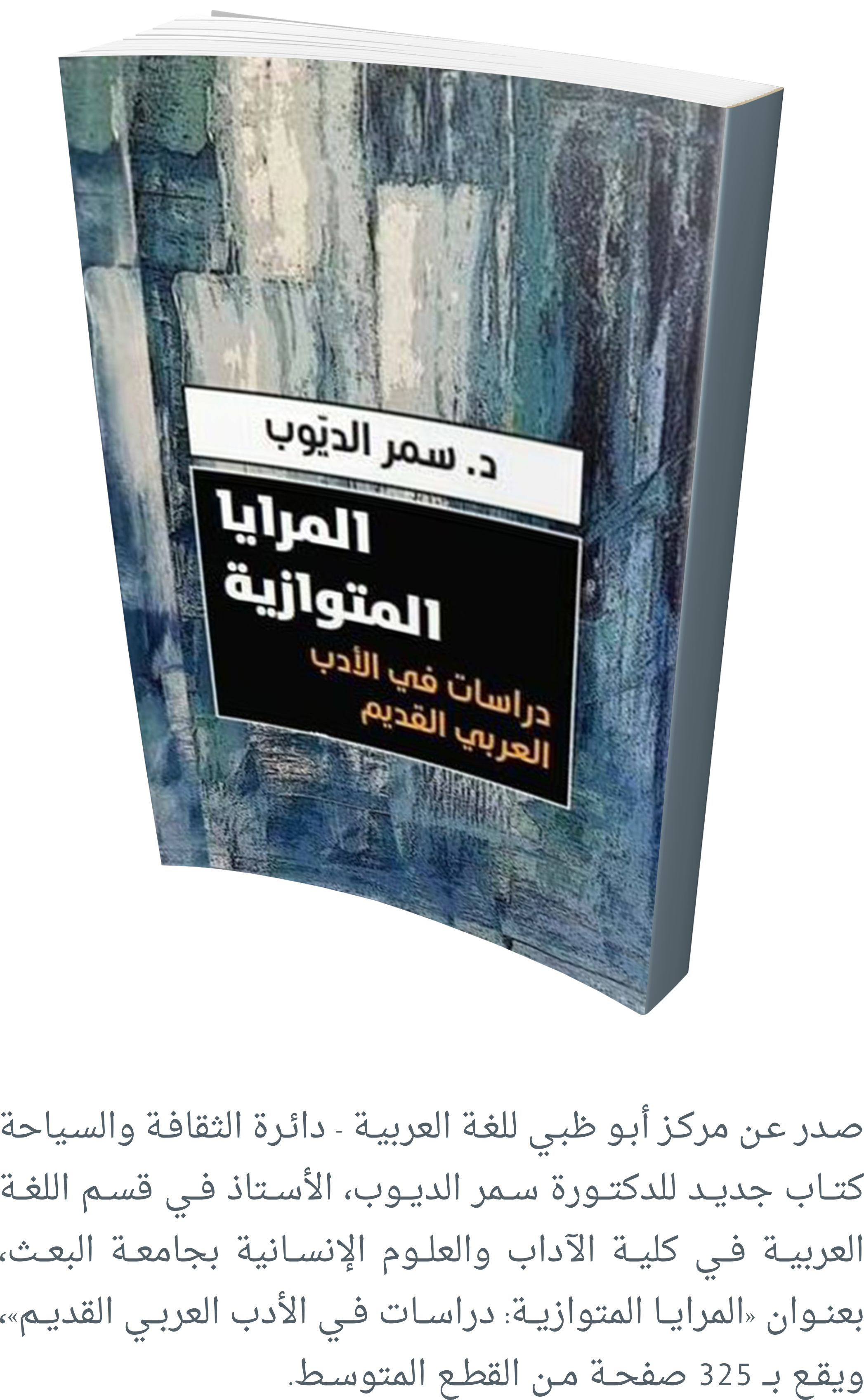
وترى الديوب أن تراثنا الأدبي يحتوي على كنوزٍ رائعة تحتاج إلى الكشف عنها بعين نقدية معاصرة؛ إذ إنّ النقد في أيامنا الحالية -كما يرى "آندريه جِيد A. Gide"- لا يزال يسير في الأرض السهلة، وحين نقارب نصّاً تُراثياً تشتد الحاجة إلى مقاربته برؤية معاصرة؛ بهدف الوصول إلى نتائج جديدة بعيداً عما توصلت إليه الدراسات التقليدية.
ومن هذا المنطلق؛ آثرتْ أن تنطلق من فكرة أن الأدب والنقد مرآتان متوازيتان- متقابلتان، لا تصحّ إحداهما من غير وجود الأخرى، فالنصّ الأدبيّ نصّ إبداعيّ، والنصّ النقديّ نصّ علميّ يعتمد على المصطلح؛ إنهما طرفان متضادان، وهذا التضاد مدعاة للتكامل، فالعلاقة بين الأدب والنقد علاقة توازٍ، وباجتماعهما نصل إلى التكامل.
إن النقد فن قد يصل إلى مستوى الإبداع، فيكشف أسرار الجمال والقبح، ويضيف الناقد إلى النص إبداعاً جديداً، ولا يقلل من قيمة الأدب حين ينقده، وتغدو العلاقة بين الأدب والنقد علاقة بين المرايا المتوازية، فالنصّ الأدبي مرآة، توازيها مرآة النقد، وقد وجدت أن العلاقة تحيل إلى التكامل بين المتضادّين، فلا يستقيم العمل الأدبي من غير نقد يظهر نسقه المضمر، وعلاقته بنسقه الظاهر، كما يعمل على الكشف عن خصوصية الخطاب، وفرادة الإبداع.
وقد اتخذت العلاقة بين الأدب والنقد أشكالاً أربعة: فقد تكون علاقة تابعية؛ فالنقد لاحق للأدب، وقد تكون علاقة عكسية؛ فيسود النقدُ الأدبَ، وترتد في هذه الحال أزمة النقد إلى أزمة الأدب، وقد تكون علاقة منطقية؛ فموضوع النقد النصّ اللغوي، ثم يتعدّى ذلك إلى العالم الذي يعالجه النصّ الأدبي، وقد تكون علاقة توازٍ، فالنقد نصّ مواز للنص الأدبي؛ إذ يبدع الناقد في آلياته ولغته من غير أن يسطو على آليات الأديب، ومن هنا تولدت فكرة المرايا المتوازية في إطار نظرتها إلى النص الأدبي التراثي.
وقد تخيّرت (د. ديوب) من النصوص الأدبية القديمة ما يمثّل محطات مهمة في تاريخ الشعرية والسردية في الأدب العربي، وتمت معالجة كلّ نص على وفق محورين:
- المصطلح النقدي المعاصر، الذي يطبَّق على النصوص الأدبية القديمة، بهدف الكشف عن أنساقها، وجمالياتها.
- النص الأدبي التراثي، الذي يثبت قدرة النص التراثي على الانفتاح على أدوات النقد المعاصر.
وحاولت البحث في إطار الأنساق، وتداخل الأنواع والأجناس. وتمثل فكرة المرايا المتوازية محور الكتاب بأكمله، فالأدب القديم والنقد الحديث يتقابلان ويتفاعلان، والنقد مرآة موازية للأدب، والثنائيات الضدية التي تنتظم البحث كله توصل إلى التكامل.
وترى أن كلّ نص أدبيٍّ ينفرد بصفة تجعل منه نصاً مختلفاً ينفتح على فضاءات مختلفة، وتحدد طبيعة المنهج الذي يطبق عليه، فالنصّ هو الذي يفرض على الباحث تخيّر أداته النقدية القادرة على استنطاقه.
ويترك النص الأدبي لدى قارئه أثراً جمالياً يربطه به، ويبقي أثر هذا النص بعد أن ينتهي فعل القراءة. وهنا يكمن سرّ جماله.
أما قراءة النص الأدبي؛ فتختلف من نصّ إلى آخر على وفق المفتاح الذي يسلّمه النص نفسه، والذي يمكن به الولوج إلى عالم النص الداخلي.
أما فيما يتعلق بمنهج العمل؛ فقد تخيرت من النصوص ما يمثل أهم مراحل الشعر والنثر في الأدب العربي القديم، وركّزت على الأدب الخاص، والأدب الشعبي، فالأدب لا يتميز بالمشهور منه فقط، بل يتميز بالفريد فيه.
وانتظمت الدراسة في عشرة فصول، عالجت في الفصل الأول البعد الدرامي في نونية تميم بن أُبيّ ابن مقبل، فالغنائية تمتزج بالدرامية في الأدب العربي القديم؛ لذا كان تركيزها على مصطلح البعد الدرامي، لا البناء الدرامي. وتعاملت في الفصل الثاني: "السمات الأسلوبية في نونية عروة بن حزام العذري"، تعاملاً إحصائياً بهدف الكشف عن خصوصية الأسلوب لدى الشاعر، وبحثت في بناء الشعر على السرد في همزية عبيد الله بن قيس الرقيّات في الفصل الثالث، فتحدثت عن المراوغة السردية، وركائز السرد في القصيدة.
وتحدثت في الفصل الرابع "خصوصية الخطاب في أدب التوقيعات: توقيعات صدر الإسلام أنموذجاً" عن الجهة المضادة للسردية، فبحثت في ركائز الشعرية في هذه التوقيعات. وبحثت في الفصل الخامس "المثل وفنّ الخبر" في علاقة المثل بنصّ الخبر، وفي الخطابات المتحاورة والمتجاورة في نصّ الخبر في إطار علاقته بالمثل.
وتناولت في الفصل السادس "الحجاج في الشعر العربي القديم: بائية إسماعيل بن يسار أنموذجاً" البعد الحجاجي، والمقصد الحجاجي في البائية، وتحدثت عن خصوصية الخطاب الحجاجي، وبلاغة الحجاج.
أما الفصل السابع "الحوار في النقائض: لاميّتا جرير والفرزدق أنموذجاً" فقد تحدثت عما له علاقة بالحجاج، وهو الحوار، فبينت نهوض النصّين على الحوار بأنواعه، وتحدثت عن علاقته بالفضاء النصي، وبسؤال الجنس الأدبي. وتناولت في الفصل الثامن "المونتاج الشعري في الشعر العربي القديم: رائية عبيد بن أيوب العنبري أنموذجاً" مصطلح المونتاج الشعري، وأوضحت أن الشاعر مُخرج جيد لنصّه، وتحدثت عن خطة المونتاج وأنواعه، وانفتاح النص التراثي على معطيات الفن السينمائي الحديث.
أما الفصل التاسع "الثنائيات الضدية في شعر الغزل العذري: يائية قيس بن الملوّح أنموذجاً"، فتحدثت فيه عن مصطلح الثنائيات الضدية، وافترضت بناء قصيدة الغزل العذري بناء ضدياً، واستخرجت الثنائيات الضدية النامية والمتحولة في القصيدة. وأفردت الفصل الأخير "ما وراء السرد في حكايات ألف ليلة وليلة: حكاية الحمّال والبنات أنموذجاً" للحديث عن مصطلح ما وراء السرد، وأثبتت حضوره في النص التراثي.
وقد أفردتْ في نهاية كلّ فصل قائمةً بالمصادر والمراجع الخاصة به.
والجديد في هذه الدراسة تطبيقها مصطلحات حديثة على النص التراثي، فلا توجد دراسة تحدثت عن "ما وراء السرد"، أو المونتاج الشعري، أو الحوار بمفهومه الحديث في التراث العربي.
ويُذكر أنّ للدكتورة الديّوب مجموعة مؤلفات في الأدب العربي القديم والمعاصر، من أهمها:
- [2017] الخطاب ثلاثي الأبعاد: دراسات في الأدب العربي المعاصر، دائرة الثقافة والإعلام في حكومة الشارقة.
- [2017] الثنائيات الضدية: بحث في المصطلح ودلالاته، العتبة العباسية، كربلاء، العراق.
- [2015] مجاز العلم- دراسات في أدب الخيال العلمي- الهيئة العامة السورية للكتاب. دمشق.
- [2014] النص العابر: دراسات في الأدب العربي القديم، اتحاد الكتاب العرب، دمشق
- [2013] التشكيل الفني في الشعر العربي القديم – شعر صدر الإسلام أنموذجاً، دار أرواد، طرطوس، سورية.
- [2009] الثنائيات الضدية -دراسات في الشعر العربي القديم، منشورات وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق.