
يحظى مفهوم الثقافة اليوم باهتمام واسع من قبل الباحثين والمثقفين والمفكرين، لما لها من صلة وطيدة بالإنسان والبشرية ككل، فالإنسان يتصل بأخيه الإنسان عبر الثقافة، وهو ما يفضي إلى التسامح والتعايش ونبذ كل صور الإقصاء. إذ لا توجد عند العقلاء فكرة أن ثقافة هذا البلد أفضل من ثقافة البلد الآخر. ويعد كل من إدوارد بارنات Edward Burnett Tylor و فرانز بُواس Franz Uri Boas من أبرز من عاجلوا هذا الموضوع معالجة منهجية دقيقة. وهذا ما شهد به دنيش كوش في تناوله لهذين العلمين في مجال الثقافة.
تايلور والتصور الكوني للثقافة
نحن ندين لعالم الأنثروبولوجيا البريطاني إدوارد بارنات تايلور بأول تعريف للمفهوم الإثنولوجي للثقافة:
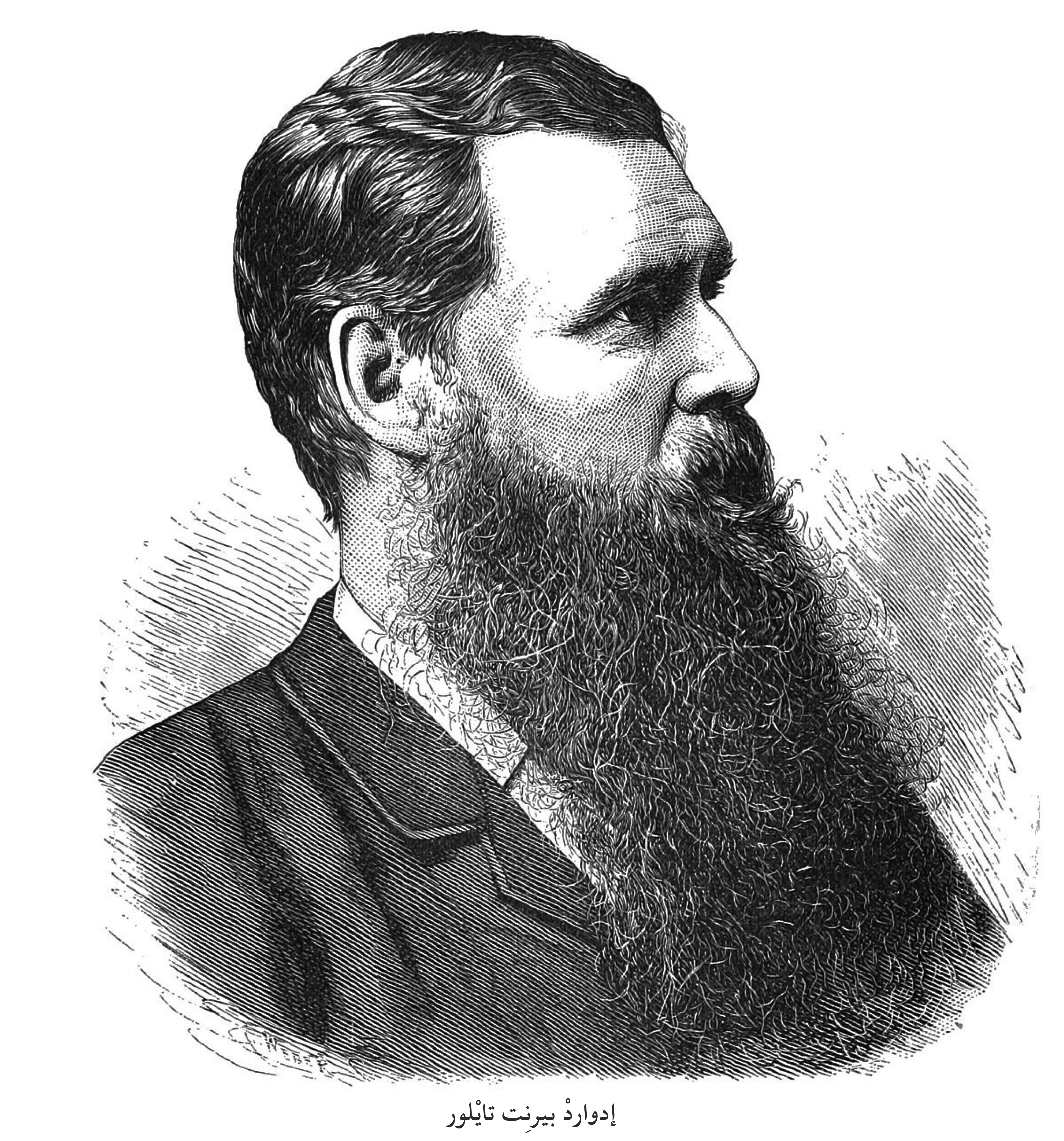
بقوله: "إن الثقافة أو الحضارة في معناها الإثنولوجي الأكثر اتساعاً، هي هذا الكل المركب الذي يشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والعادات، وكل القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضواً في المجتمع".
هذا التعريف حسب دنيس كوش يستوجب على وضوحه وبساطته بعض التعليق. من الواضح أنه حريص أن يكون وصفياً وموضوعياً خالصاً لا معيارياً، وهو فضلا عن ذلك يتقاطع مع التعريفات الحصرية والفردانية للثقافة: إن الثقافة بالنسبة إلى تايلور تعبر عن كلية حياة الإنسان الاجتماعية، وتتميز ببعدها الجماعي، والثقافة أخيراً مكتسبة ولا تتأتى –إذاً- من الوراثة البيولوجية.
لقد كان التردد بين مفهومي "ثقافة" و"حضارة" لدى تايلور مميزاً لسياق العصر، وإذا ما انتهى إلى تفضيل "ثقافة" فلأنه فهم أن "حضارة" -وحتى إذا ما وضعت في معناها الوصفي الخالص- تفقد خاصية المفهوم الإجرائي حالما تطبق على المجتمعات البدائية، وذلك بفعل أصلها الاشتقاقي الذي يحيل على تكريس المدن، وبفعل المعنى الذي اتخذته في العلوم التاريخية، حيث تعني رئيسياً الانجازات المادية ضعيفة النماء في تلك المجتمعات. تمتاز كلمة ثقافة بالنسبة إلى تايلور، في التعريف الجديد الذي وضعه لها، بكونها كلمة محايدة تمكن من التفكير على نطاق الإنسانية كافة، ومن القطع مع مقاربة ما لـ"البدائيين" تجعل منهم كائنات على حدة.
ليس مستغرباً أن يكون هذا المفهوم من ابتداع إدوارد تايلور المفكر الحر الذي غُلّقت في وجهه أبواب الجامعة الإنجليزية بصفته صاحبياً (مذهب ديني بروتستانتي يدعو من تشيعوا له إلى السلام والبساطة وحب البشر)، وإذًا أقلياً كان يؤمن بقدرة الإنسان على التقدم، وكان في ذلك يشاطر مصادرات ذوي النزعة التطورية في عصره. لم يكن يشك كذلك في الوحدة النفسية للإنسانية، والتي كانت تفسر ما يلاحظ من تماثلات بين مجتمعات شديدة التباين: الفكر البشري بالنسبة إليه يشتغل في ظروف متماثلة، بطريقة متشابهة أينما كان. كان منخرطاً أيضاً بوصفه وريثاً للأنوار في تصور فلاسفة القرن الثامن عشر الكوني للثقافة.
كان الإشكال الذي سعى إلى حله هو المواءمة في تفسير واحد بين تطور الثقافة وكونيتها. في كتابه "الثقافة البدائية" الذي ظهر سنة 1871 وسرعان ما ترجم إلى الفرنسية سنة 1876، وهو ذلك المصنف الذي اعتبر مؤسساً للإثنولوجيا بوصفها علماً مستقلاً، تساءل تايلور عن "أصول الثقافة" وعن آليات تطورها. كان بالفعل أول عالم إثنولوجي يعالج الظواهر الثقافية من منظور عام ونسقي. كان أول من حرص على دراسة الثقافة في المجتمعات بكل نماذجها وبكل صورها المادية والرمزية وحتى الجسدية.
على إثر إقامته في المكسيك، فرغ تايلور من تدقيق منهجه في دراسة تطور الثقافة بتفحص "البقايا" الثقافية. لقد مكنته إقامته في المكسيك أن يعاين تعايش عادات السالفين مع سمات ثقافية حديثة العهد، وكان يرى أنه يتيسر عبر دراسة "البقايا" أن يتم التدرج صعوداً إلى الكل الثقافي الأصلي وإعادة تركيبه، وبتعميم هذا المبدأ المنهجي انتهى إلى الاستنتاج القائل بأن ثقافة الشعوب البدائية المعاصرة كانت تمثل بصفة عامة الثقافة الأصلية الخاصة بالإنسانية: بقايا أطوار التطور الثقافي الأولى تلك التي لا بد أن تكون ثقافة الشعوب قد مرت بها.
كان منهج تفحص البقايا يستدعي منطقياً تبني المنهج المقارن الذي تولّى تايلور إدراجه في الإثنولوجيا. إن دراسة الثقافات المتفردة لا تستقيم بالنسبة إليه دون إقامة المقارنة بينها؛ لأن بعضها يرتبط ببعض، وبمواجهة أولئك الذين كانوا يقيمون قطيعة بين المتوحش والوثني، وبين الإنسان المتحضر والتوحيدي، كان حريصاً على بيان الصلة الجوهرية التي كانت توحد بين الأول والثاني، هذا الذي لم يكن لمنتهى مساره من مآل سوى الدنو من الأول، فليس بين البدائيين والمتحضرين اختلاف في الطبيعة، بل مجرد فارق في درجة التقدم على طريق الثقافة. قاوم تايلور بحماسة نظرية انحطاط البدائيين التي أوحى بها اللاهوتيون الذين لم يكن بإمكانهم تخيّل أن الله قد خلق كائنات "متوحشة" إلى هذه الدرجة، وهي النظرية التي كانت تيسر إنكار كون البدائيين كائنات بشرية مثل الأخرى. على العكس من ذلك، كان كل الناس بالنسبة إليه كائنات ثقافية، سواء بسواء، وكانت مساهمة كل شعب في تقدم الثقافة جديرة بالاعتبار.
كما نرى، لم تكن نظرية تايلور تنزع عنه حساً ما بالنسبية الثقافية، وهو حس كان بالأحرى نادراً في عصره. لم يكن تصوره للتطورية، ومع ذلك كان متصلباً في الموقف إذا لم يكن واثقاً تماماً من وجود توازن مطلق في التطور الثقافي الخاص بمختلف المجتمعات. لذلك كان يعتمد في بعض الحالات الفرضية الانتشارية أيضاً. إن مجرد التماثل بين سمتين ثقافيتين منسوبتين إلى ثقافتين مختلفتين لا يكفي بالنسبة إليه لإقامة الدليل على أنهما كانتا تحتلان الموقع نفسه من سلم التطور الثقافي: يمكن أن يكون قد حدث انتشار من ثقافة نحو أخرى. لكن، بصفة عامة كان بوفائه لحرصه على الموضوعية العلمية يبدو حذراً في تأولاته.
بالنظر إلى آثاره وانشغالاته المنهجية يُعتبر تايلور بحق مؤسس الإثنولوجيا البريطانية، وإليه يرجع الفضل -من جهة أخرى- في الاعتراف بهذا العلم؛ إذ أصبح سنة 1883 أول من يشغل كرسياً أنثربولوجياً في بريطانيا العظمى في جامعة أكسفورد.
فرانز بُواس والتصور التخصيصي للثقافة
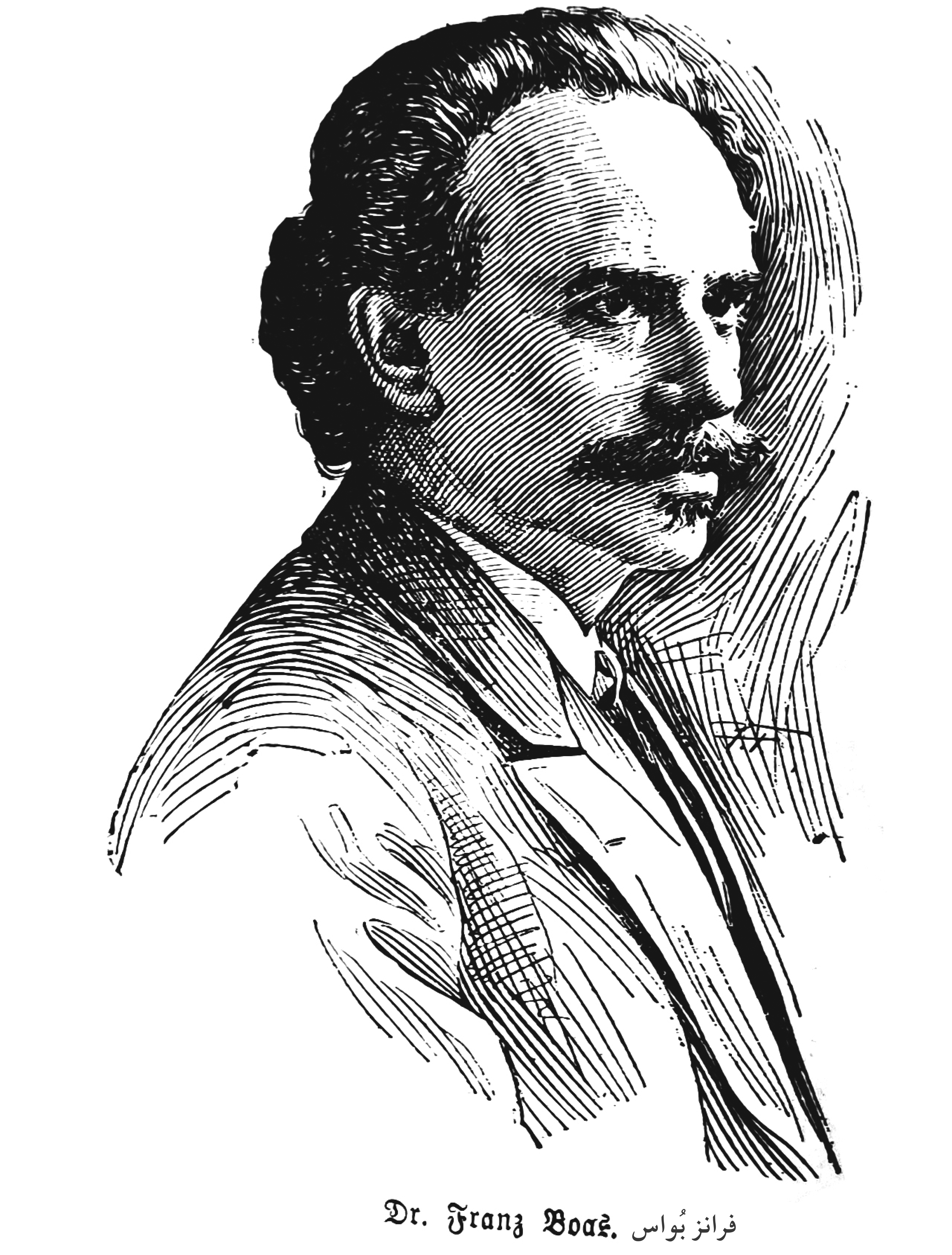
لئن كان تايلور "مبتدع" مفهوم الثقافة العلمي؛ فإن بُواس كان أول أنثربولوجي ينجز تحقيقات "على الطبيعة" بتسليط الملاحظة المباشرة والمطولة على الثقافات البدائية، وبهذا المعنى يكون هو مبتدع الإثنوغرافيا.
كان فرانز بُوا يتحدر من عائلة يهودية ألمانية ذات فكر ليبرالي. لقد كان حساساً تجاه مسألة العنصرية وكان هو ذاته ضحية لمعاداة بعض زملائه من السامية في الجامعة. كل أعمال بُوا هي محاولة للتفكير في الاختلاف الاختلاف الأساسي بين المجموعات البشرية -بالنسبة إليه- هو ذو طبيعة ثقافية لا عرقية وبفعل تكوينه في الأنثروبولوجيا الطبيعية أظهر نوعاً من الاهتمام بهذا التخصص، ولكنه حرص على تفكيك ما كان يمثل عصرئذ مفهومه المركزي: "العرق" في دراسة كان لها صدى بعيد، شملت مجموعة من وصلوا الولايات المتحدة ما بين عامي 1908 و1910، وبالاستناد إلى المنهج الإحصائي بيّن بُوا السرعة الفائقة التي حدثت بها تبدلات في السمات الجسمانية (وخاصة شكل الجمجمة) بفعل ضغط محيط جديد. لم يكن بالنسبة إليه مفهوم "العرق" البشري ذو الزعم العلمي والمتصوَّر على أنه مجموع دائم لسمات طبيعية تختص بها مجموعة بشرية قادراً على الصمود أمام التفحص. إن "الأعراق" المزعومة ليست ثابتة ولا توجد خصائص عرقية ثابتة، ومن المستحيل إذاً تعريف عرق ما تعريفاً دقيقاً حتى إذا ما استنجد بالمنهج المسمى "منهج المعدلات". إن خاصية المجموعات البشرية فيما هو فيزيائي، هي مرونتها وعدم ثباتها وامتزاجها. ولقد كان باستنتاجاته هذه يستبق الاكتشافات التي لحقته في علم وراثة المجموعات البشرية.
فضلاً عن ذلك، حرص بُوا أيضاً على بيان سخف الفكرة السائدة في عصره، والتي يتضمنها مفهوم "العرق" القائلة بوجود صلة بين السمات الفيزيائية والسمات الذهنية. كان بديهياً بالنسبة إليه أن المجالين يخضعان إلى تحليلين متباينين تماماً؛ ولأنه كان يتقصد التصدي لهذه الفكرة تحديداً، تبنى مفهوم الثقافة الذي كان يبدو له أكثر ملاءمة للأخذ بالاعتبار التنوع البشري. لا يوجد بالنسبة إليه تباين طبيعي (بيولوجي) بين البدائيين والمتحضرين، بل تباينات ثقافية وحسب، وإذاً مكتسبة لا فطرية. من الواضح إذاً أن مفهوم كلمة الثقافة لدى بُوا -وعلى خلاف ما أكد البعض- لا يستخدم بوصفه تورية إلماعية لمفهوم العرق؛ إذ هو تقصّد أن يبني الأول في مواجهة الثاني. لقد كان واحداً من أوائل العلماء الاجتماعيين الذين تخلوا عن مفهوم العرق في تفسير التصرفات البشرية.
وعلى عكس تايلور، كان بُوا الذي أخذ عنه على الرغم من ذلك تعريفه للثقافة، قد حدد لنفسه غاية في دراسة الثقافات (في الجمع) بدلا من الثقافة (في المفرد). وإذا كان محترزاً تجاه التوليفات التأملية الكبرى، وخاصة تجاه النظرية التطورية الأحادية التي كانت مهيمنة حينها في الحقل الثقافي، فقد عرض سنة 1896 في مداخلة علمية ما كان يعتبره "حدود المنهج المقارن في الأنثروبولوجيا". كان ينتقد نزوع غالب الكتّاب التطوريين إلى المقارنة غير الحذرة، ولم يكن ثمة بالنسبة إليه إلا ضعيف أمل في اكتشاف قوانين كونية لاشتغال المجتمعات والثقافات الإنسانية، وأضعفُ منه الأملُ في اكتشاف قوانين عامة لتطور الثقافات. ولقد وجه نقداً جذرياً إلى ما كان يسمى منهج "التحقيب" المتمثل في إعادة تركيب مختلف مراحل تطور الثقافات انطلاقاً من أصول مزعومة.
وكان بُوا في أواخر حياته يُلح على مظهر من مظاهر النسبية الثقافية، فهذه يمكن أن تعتبر أيضاً مبدأ إيتيقياً يؤكد كرامة كل ثقافة، ويدعو إلى الاحترام والتسامح إزاء الثقافات المختلفة. فطالما كانت كل ثقافة تعبّر عن طريقة متفردة ليكون الإنسان إنساناً، فقد حق لها التقدير والحماية كلّما كانت موضع تهديد.
إن الثقافة إذاً، تعد رابطة قوية تجمع بين الشعوب أكثر مما تفرق، بشرط التزام الحياد في إثارة الموضوع؛ إذ من الممكن أن تلجأ أقلام ما إلى نشر فكرة التفاضل الثقافي وهو ما يعد إقصاءً وانتقاصاً من قيمة ثقافة الغير، لهذا فنحن في أمس الحاجة إلى خطاب ثقافي جامع للوحدة البشرية بغية بناء عالمي قائم على العدل والتراحم.