يفضي بنا الحديث عن النص الروائي باعتباره جنساً غيرَ منتهٍ في تكوّنه وتشكّله، إلى وضع هذا النص في سياقه الذي ولدَ فيه، وفي المسار التاريخي الذي يسلكه، ومن ثمَّ تأويله وفق تلكم الآفاق التي تتيح لنا سبر أغواره واستكناه معانيه، وتفاعله مع محيطه الاجتماعي؛ غير أن هذا لا يعني أننا نروم في هذه المقالة تناول الرواية من الخارج؛ أي الاقتصار على سياقها الاجتماعي؛ ولكننا نبتغي مقاربتها من الداخل أيضاً، ذلك أنّ إغفالَ الجانب النّصي (إطاراً ودلالةً) يجعل هذه المقاربة مذْهبية / أيديولوجية تترصّد في العمل الأدبي ما يجبُ أن يكون، وليس ما هو كائن فيه، بل تبحث عما يجب أن يقوله هذا النص، لا فيما هو قائل؛ من هنا تنطلق هذه المقالة من الربط بين البنية الداخلية للرواية وسياقاتها الخارجية التي تتماس معها في أثناء إنتاج دلالتها الممتدّة والمتفرّدة. في هذا السياق نتساءل، إلى أي حد استطاعت رواية "غيثة تقطف القمر" للروائية زهور كرام، أن تُمثّل الذاكرة الاجتماعية في متنها السردي؟ للإجابة عن هذا التساؤل، نقترح ثلاثة مداخل لقراءة هذا العمل الروائي.
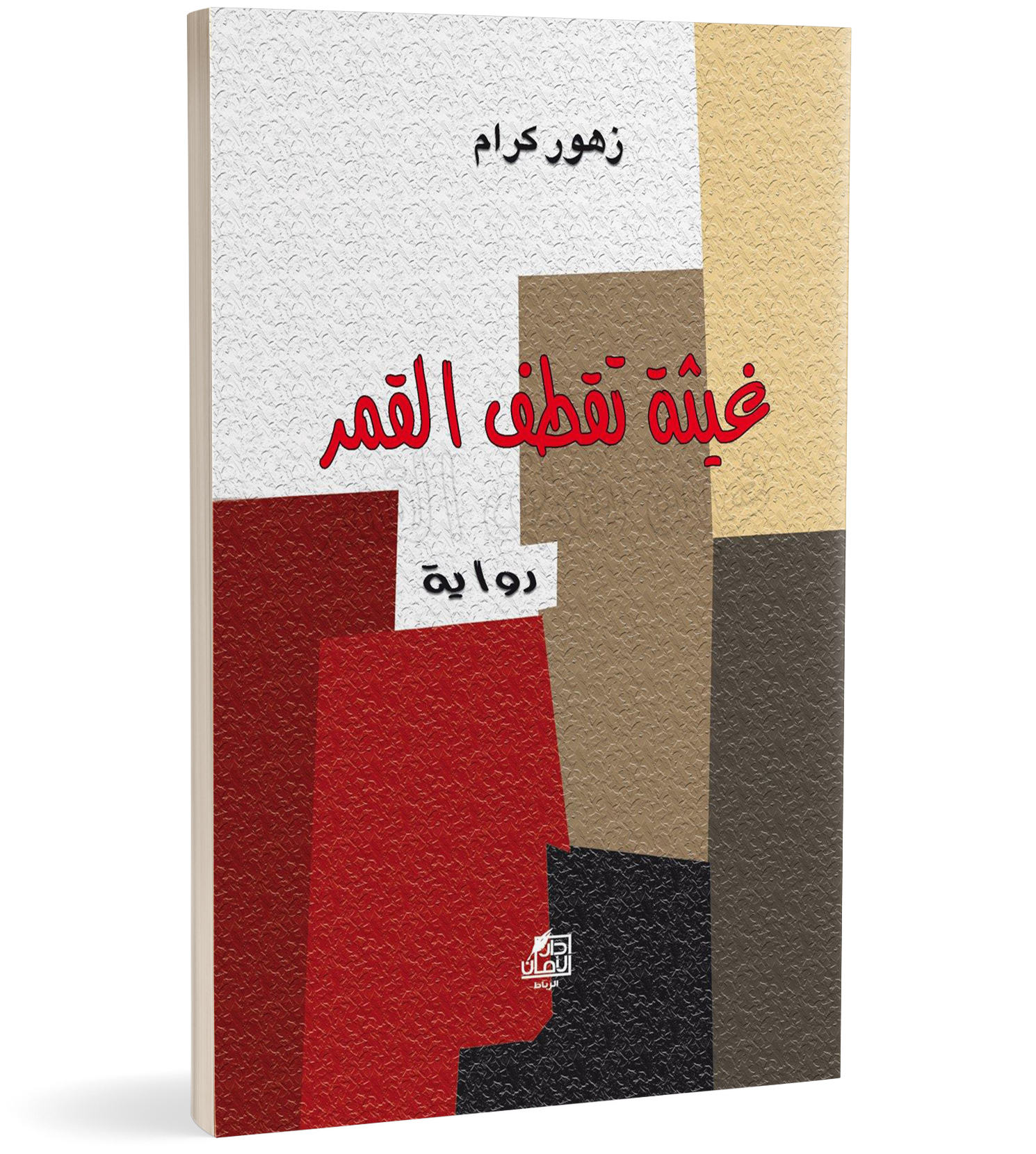
أولاً: رواية "غيثة تقطفُ القمر": البنية والإطار الدّلالي
1. البنية
تحكي رواية «غيثة تقطف القمر» قصّة الشخصية البطلة غيثة التي تشتغل صحافية في جريدة «الفترينا»، وبما أنها صحافية تجيد فنّ صحافة الاستقصاء بقدرتها العالية على «شمّ رائحة الفساد»، ستعمل على كشف أحد الفاسدين الذي يحمل اسم «السيّد السيدا» لتجد نفسها بعد فضحه داخل السجن، وتدخل غيثة معترك الحياة بكل مآسيها الاجتماعية، فيتخلّى عنها زوجها المحكوم بمنطق عشيرته الذي لم يستطع التخلّص منه... تعانق غيثة الحرية، لكن أكمات السجن وخيبات الأمل الكثيرة جعلتها جريحة اجتماعياً، فتحاول علاج جراحها بأقراص يبيعها شخص عابر في محطّة حافلات النقل، أقراص تداوي كل شيء قصدَ تجاوز محنتها وأزمتها.
تحاول غيثة الانخراط في المجتمع من جديد، لكنها تجد الفساد قد استشرى في المجتمع أكثر من السابق، بدءاً من زوجها الذي تخلى عنها لحظة اعتقالها واستنطاقها من طرف مكتب التحقيقات، ذلك الزوج الذي صدّقته عندما تقدّم إلى خطبتها، ذلك الزوج الذي آمنت به سنداً لها، يخذلها في أول امتحان حقيقي تواجهه في حياتها المهنية، ذلك الزوج الذي تخلّى عنها لأنها لم «تنتفخ بطنها» منه، منتصراً لمنطق عشيرته الذي ظلّ يرافقه منذ زواجه منها. تنهض غيثة لتجابه مَطَبّات المجتمع بعد السجن، فتجد نفسها أمام أخيها «عمر» الذي يعيش على أمل الهجرة إلى إيطاليا لإنقاذ نفسه من ربقة البطالة التي يعانيها مع زملائه حاملي الشهادات العليا، والذين يعتصمون أمام البرلمان في مواجهات درامية مع وعود الحكومة، ومن ثمَّ تحسين وضعه الاجتماعي والعودة بسيارة حمراء تستهوي بنات الحي.
بينما يلتحق عمر بإحدى مجموعات المعطّلين، وأمه تدعو له بالحصول على وظيفة، أو بالهجرة إلى إيطاليا. تسعى غيثة إلى معرفة الحقيقة وراء اعتقالها، ولماذا تخلّت عنها إدارة صحيفة «فترينا» ولم تُوكّل لها محامٍ يرافع عن قضيتها؛ لتتفاجأ أن الجريدة أصبحت في ملك «السيّد السيدا» لتعود أدراجها بعد أن تحطّمت آمالها! وأمام انحسار ذاتها المأزومة، يظهر «خالد» فاتحاً قلبه لها، ومضمّداً لجراحاتها، يمنحها رسالة مع باقة ورد، وقبلة مطبوعة على خدّها، لم تفتح رسالته إلا بعد حين، ولم تكن تعلم أن خالداً يقترح في رسالته تلك أن يعمل عمر عنده مستشاراً قانونياً، وذلك للتخفيف من معاناتها اتجاها أخيها، من جهة، ولإنقاذ عمر من جهة ثانية، لكنّ عمر رحل محلّقاً وراء أمّه التي فارقت الحياة هي الأخرى.
تعود "غيثة" من جديد إلى إدارة التحقيقات لتتأكد من عدم تورّطها في الموقع الإخباري «www.sidasayd.com» فتخرج منتصرة، وتعود إلى هوايتها المفضّلة، الكتابة، وتكتب مقالتها "غيثة تقطف القمر".
2. الإطار الدّلالي
تكتنز رواية «غيثة تقطف القمر» العديد من الأنساق الاجتماعية والثقافية المرجعية التي تعكس مجتمعاً مأزوماً وقلقاً، تحاول الرواية عبر عالمها ومكوّناتها أن تحفر في المناطق المعتّمة والمغيّبة التي ظلت مطمورة وراء خطابات رسمية ومؤسساتية، وعلى الرغم من كون الرواية جاءت مكثّفة في نسقها السردي وفي بنيتها اللغوية المتجسدة في الجمل القصيرة، وفي التنويعات الزمنية المتداخلة والمضطربة انسجاماً مع اضطرابات المجتمع، على الرغم من ذلك، فإنها –أي الرواية- تعمّق نظرة القارئ وإحساسه بالوشائج الرابطة بين الأحداث السردية وامتداداتها في الواقع، كما أنها –عبر ذلك– تدعو المتلقي إلى إعادة تشكيل وترميم الفراغات والفجوات النصية بغية تجسير التناقضات والتنافرات الدلالية التي تزخر بها الرواية، فضلاً عن إعادة ترتيب العناصر الجمالية المنتشرة في بنيتها اللغوية، والشخوص وتصوراتها، والفضاءات الغنية بالدّلالات، وكذلك التناصات العابرة، والأنساق الثقافية المضمرة فيها.
ثانياً: تسريد الوطن ثقافياً وسياسياً
تستهلّ رواية «غيثة تقطفُ القمر» خطابها بما يسمّيه «جرار جنيت Gérard Genette » بخطاب العتبات التي تعدُّ إحدى المعابر الدّلالية الأساسية للمرور إلى النص الأدبي1. وتنبع أهمّيتها من خلال كونها عناصر تكثيفية وتبئيرية لدلالات النص ككل. حيث تتعمّد الروائية «زهور كرّام» إثبات خطاب للشخصية البطلة غيثة في الصفحة السابعة قبل المقطع السردي الأول؛ وبغض النظر عن طبيعة ملفوظ هذا الخطاب، فإنه يضطلع بعدّة وظائف دلالية وفنّية، أهمّها تنظيم الوضعية التلفظية للنص الروائي، إضافة إلى تمكين القارئ من تجسير ما تضمنه خطاب هذا الملفوظ بِــــما سيحفل به النص في نسقه السردي اللاحق.
هكذا؛ فإنّ خطاب العتبة في الملفوظ التوجيهي الذي تستهل به الرواية خطابها، يفرض على القارئ ضرورة قراءته قراءة علائقية مع النّص المركزي، فلو «أمعنّا النظر في علاقة النص التوجيهي بالنص المركزي، لوجدناها علاقة جزء بكل.. ذلك أنّ النص التوجيهي يحمل دلالات عامّة، والنص المركزي يُفَصّل في أبعاد وجوانب ودقائق تلك الجوانب العامّة، بطريقة صريحة أو ضمنية»2. وبما أن نص «غيثة تقطفُ القمر» ينتمي إلى الحساسية الجديدة3 في الكتابة الروائية، فإنّ هذا النص التوجيهي يستوقف القارئ قبل شروعه في قراءة الرواية، ويدعوه لتأمّل دلالة هذا النص، تجنباً لتأويلات خاطئة ومتعسّفة، تحمّل النص ما يسَعُهُ، ويجنبه كذلك القراءة المُغرضة التي تُقوّل النص ما لا يقوله. جاء على لسان الشخصية «غيثة»: «عندما نعرف كيف ندافع عن الحب، نربح الوطن»4.
يقوم هذا المُستهل التوجيهي على ثنائية طالما تغنّى بها الإبداع العربي والعالمي على حدّ سواء، وهي ثنائية «الحب –الوطن» حيث لا ينمو الحب ويزدهر إلا بوجود وطنٍ، ولا ينشأ الوطن بمفهومه الواسع إلا بالحب والتضحيات التي يقدّمها المنتمون إليه؛ هكذا، إذن، يضمر الخطاب أعلاه، دلالة مفادها أنّ الذي لا يدافع عن الحب، لا يمكنه أن يربح الوطن.
بما أنّ الحب عاطفة أنثوية في الغالب5، فإنّ غيثة هنا تتغنّى بالحب من أجل الوطن، فهي تحب العدالة والديمقراطية، وتفضح الفاسدين من خلال كتاباتها الصحفية؛ وكل هذا من أجل «أن تربح الوطن». هذه الدّلالة التي يكتنزها مستهل الرواية والتي تقدّم تصوّراً خاصاً للوطن يقوم على تيمة الحب، تتكشّف تفاصيلها في فصول الرواية لاحقاً، تقول غيثة في سياق حوارها مع أخيها عمر:
«بلادي موطني
ماءٌ وملحٌ
بلادي موطني
فوسفاط وسمك
لماذا ننسى الدرس عندما نبدأ في الكبر»6
يشير هذا المقطع إلى بعض ملامح الوطن الذي تراهن غيثة على ربحه، وهو وطنٌ يتحيّزُ جغرافياً بواجهتين بحريتين، وغني بثروة هائلة (قمح، وفوسفاط، وسمك..). فهذا الوطن الجميل والغني الذي تصرّ غيثة على الدفاع عنه: «أترين علاقتنا بالمكان غير علاقة أبائنا به. يموتون من أجله، ونحن نبيعه بفلس»7 سرعان ما سيتحوّل إلى وطن مستباح من طرف «السيّد السيدا».
فانطلاقاً من متواليات الأحداث السردية التي تعاقبت في مجرى الرواية، يمكن تأويل جملة من الأنساق الثقافية والمرجعية التي تجسّد في أثنائها رؤية الرواية للواقع الاجتماعي من جهة، وتمثّل دلالات الوطن وتمثله عند الشخصيات من جهة أخرى. وفي مقدّمة هذه الأنساق الثقافية التي نستخلصها من توارد الأحداث داخل الرواية نجد المقابلة بين «الوطن الثقافي» و«الوطن السياسي».
تتسم هذه المقابلة على الدّوام بالصراع والتناحر؛ ففي الوقت الذي تبني فيه غيثة مفهوماً كونياً للوطن، مفهوماً قائماً على العدالة والمساواة، وتدافع عنه؛ تتجسّد رؤية نقيضة لهذا التصوّر وهي رؤية السيّد السيدا، التي تشكّل امتداداً للمصالح السياسية الضيقة التي تعمل على حماية امتيازات طبقة معيّنة، وتعمل أيضاً على تثبيت تلك المصالح بمختلف الوسائل الممكنة، وعلى رأسها: القمع والاعتقال وطمس الأصوات المثقّفة التي تقدّم بديلاً حقيقياً للوطن المستباح.
ثالثاً: تسريد الهجرة: «الأنا – المهمّش» و«الآخر –المنقذ»
انتهى الناقد قيسومة منصور في كتابه «الأنا والآخر في الرواية العربية الحديثة»8 إلى أن وعي الإنسان العربي في علاقته مع الآخر، يضمر تناقضات حيث يصرّ العربي على النظر إلى ذاته من خلال مرآة الغرب، التي غالباً ما تظهرهُ مهمّشاً وقبيحاً ومتخلّفاً ومتوحشاً، في مقابل الإنسان الغربي بصفته نموذجياً ومركزياً.
في هذا الإطار، أوّل ما يتبادر إلى ذهننا إزاء هذا التمثيل السردي لثنائية (الأنا والآخر) في رواية «غيثة تقطف القمر» هو التساؤل الآتي: هل استطاعت الرواية أن تخطّ رؤية جديدة لهذه الإشكالية؟ أم أنّها طَبَّعَتْ مع النظرة المُكرّسة في الأعمال الروائية العربية السابقة؟
قبل الجواب عن هذه الإشكالية، نسجل أولاً، بأن الرؤى والتصوّرات المبثوثة في أعمال روائية عربية موازية ذات الطابع الحضاري، رَسَّخَت ما يمكنُ أن نسمّيه: تابعية الشرقي-الأنا، للغربي- الآخر، كما عزّزت تفوقهُ الحضاري في إطار العلاقة الكولونيالية بين الشرق والغرب، والتي حملت أنماطاً جاهزة لخّصت الشرقي-الأنا فيما هو منحطّ ومتخلف وهمجي، وترتقي بالآخر-الغربي إلى مصاف ما هو نموذجي ومتحضّر.
ولهذا نجد البطل المجرّد من الاسم في رواية «الحي اللاتيني» عاجزاً عن فهم الآخر – شخصية «جانين مونتيرو» واستيعاب حضارته. الشيء نفسه يتكّرر في رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» التي كُتبت في أواخر ستينيات القرن الماضي؛ حيث حاولت الرواية أن تقدّم نقداً لآليات الخطاب الاستعماري الكولونيالي القائم على الهيمنة؛ فعلى الرّغم من كونها رواية ناقدة للأطروحة الاستعمارية؛ فإنّها بقيت وفيّة لمنطق الصراع الحضاري بين الشرق والغرب، ما يفسّر هذا هو انغماس بطلها «مصطفى سعيد» في براثن الانتقام من الغرب بكلّ الوسائل الممكنة، وعلى رأسها: الجنس والعنف والقتل، حيث تصبح هذه الوسائل عاكسة لتخلّفه ووحشيته، ومن ثمَّ حاجته للتحضّر، الأمر الذي يضفي شرعية على ادعاءات الخطاب الاستعماري القائم على دعوى تحضير الشرق وتمدينه وتنويره، في هذا السياق علّقت الناقدة يمنى العيد على بطل الرواية بقولها:
"مصطفى سعيد الذي ينتقم لتخلّفه وضعفه بإظهار قوته الجنسية وبقتل نساء الغرب... يثبت توحّشه ومن ثمّ ضرورة تحضّره، وهذا يعني أن استمرار الغرب في مهمّته التحضيرية مرهون باستمرار مصطفى سعيد في توحّشه. وعليه، يصبح استمرار مصطفى سعيد في سلوكه ضرورة لاستمرار الغرب في مهمّته"9.
في ضوء هذه الملاحظة، وجواباً عن التساؤل الذي صُغناه سابقاً، تقدّم رواية «غيثة تقطف القمر» رؤية جديدة لإشكالية (الأنا – الآخر)، رؤية بعيدة عن ملمح الصراع الحضاري، وقائمة على تفكيك نظرة «الأنا» تُجاهَ «الآخر» من الجانب الاجتماعي، دون اعتبار هذا «الآخر» عدوّاً كولونيالياً تجب محاربتهُ، أو الانتقام منه من خلال العنف الجنسي الذي هيمن على السرديات الحضارية؛ وبهذا تنغمس الرواية في أتون المجتمع لترصد صور التهميش والاحتقار الاجتماعيين، في وطنٍ مُستباحٍ من طرف الفاسدين.
يحضر «الآخر–الغرب» في الرواية قيدَ الدّراسة، عندما يبدأ «عمر» في التفكير في الهجرة، حيث تبرز عدة تساؤلات تبيّن قلق الشخصية، واضطراب المجتمع الذي تعيش فيه، منها: لماذا سيهاجر؟ وإلى أين سيهاجر؟ وهل الحلّ هو الهجرة؟ هذه الأسئلة التي تعمّق شعور ذات الشخصية بالانشطار، تؤكّد أنَّ اليأسَ قد تمكّنَ منها، وأنها تشعر بالغربة في وطنها، الشيء الذي لم يستطع عمر استيعابه، حيث جاء في الرواية: «خطا نحو البحر، لمست قدماهُ الماءَ، شعر بلسعة البرد تتسرّب إلى جسدهِ، تذكّرَ أنهُ أول مرّة يلمس الماء.. ماء البحر، هو ينتمي إلى مدينة غربها بحر ووسطها نهر، وضواحيها مستنقعات، استغرب كيف يكون الوطنُ بحراً ومحيطاً ولم يسبق له أن رأى البحر، سحبَ نفسه من هكذا استغراب، ألمْ يفكّر في الهجرة إلا حين استعصى عليه الفهم»10.
يوضّح المقطع السردي أعلاه، أنّ التفكير في الهجرة، وليد سياق اجتماعي محتقن، سياق تسوده جملة من القيم المفعمة بالتناقضات والتنافرات، والمثقلة بالتوتر النفسي والاحتراب الاجتماعي؛ الأمر الذي جعل فكرة الهجرة نحو «الآخر» في المعمار السردي للرواية تُنحتُ في مستنقع الالتباس والتشويش والارتياب والهزيمة النفسية؛ حيث تستغرب الشخصية عدم استمتاعها بالماء في وطن يزخر بالثروة المائية، ويستعصي عليها فهم واقعها الاجتماعي المأزوم، ممّا حتّمَ عليها –أي الشخصية- اتخاذَ قرار الهجرة عبر البحر حتّى وإن كان محفوفاً بالمخاطر «البحر وحدهُ يحقّق لك ما ضاع في الوطن... ألمْ ترَ مهزلتكَ؟ أيّ مهزلة؟ ألا تنتمي إلى وطن البحر والمحيط... وقدماك غريبة عن ماء البحر، أليسَ لك الحق في البحر والسمك والشمس والرمال»؟11.
صفوة القول؛ إنّ رواية «غيثة تقطف القمر» استطاعت بفضل تسريد مفهومي «الوطن» و«الهجرة» المرتبطين بالذاكرة الاجتماعية، وإعادة بنائهما وفق معمارها الروائي، تشخيصَ وتخصيبَ مختلف المنظورات والرؤى، والمصالح الطبقية المتصارعة في سياقها الاجتماعي.. الأمر الذي أسهم في انفتاح شكلها الروائي وتخصيب حركيته الفنية والإبداعية.
الإحالات
Gérard Genette : Seuils, Ed Seuil. Coll, poétique, Paris, 1999, p 15
2. عبد المالك أشهبون: عتبات الكتابة في الرواية العربية، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: 1، 2016، ص: 147. ┆ 3. لمزيد من التفصيل في هذا المفهوم، انظر: إدوارد الخراط، الحساسية الجديدة، دار الآداب، بيروت، ط: 1، 1993. ┆ 4. غيثة تقطف القمر، ص: 07. ┆ 5. علي حرب: الحب والفناء: المرأة – السكينة – العداوة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط 3، 2014، ص: 89. ┆ 6. غيثة تقطف القمر، ص: 24. ┆ 7. نفسه، ص: 25. ┆ 8. قيسومة منصور: الأنا والآخر في الرواية العربية الحديثة، دار سحر للنشر، تونس، ط: 1، 1994. ┆ 9. يمنى العيد: في معرفة النّص: دراسات في النقد الأدبي، دار الآداب، بيروت، ط4، 1999، ص: 272. ┆ 10. غيثة تقطف القمر، ص: 13. ┆ 11. نفسه، ص: 15.