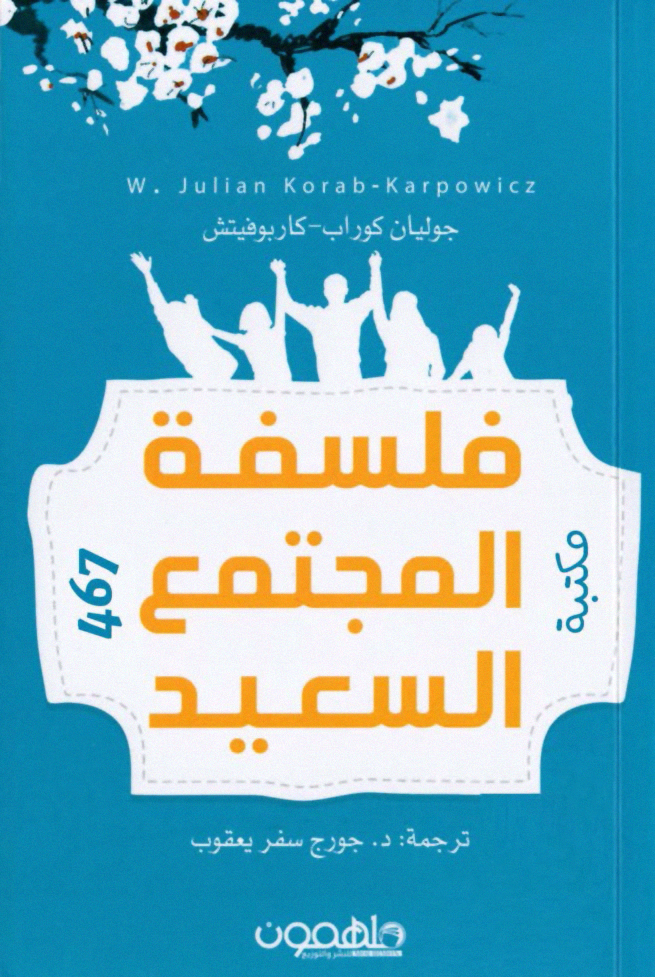
إذا تخيلنا عالماً مثالياً كاملاً، سيكون عالم التناغم الاجتماعي.. والتناغم الاجتماعي لا يعني أن نصنع من الجميع نسخة موحدة، كما أنه ليس مساواة سقيمة بين أفراد مجتمع لا طبقي. هو ليس دمجاً أو ردماً للفروق في المجتمع، بل هو ثراء اجتماعي وهو –نوعا ما- تشكيل يضم التباين والتنوع، نجد فيه التكامل المتبادل والفضائل ومكارم الأخلاق.. هكذا افتتح جوليان كوراب W. Julian Korab-Karpowicz كتابه "فلسفة المجتمع السعيد".
مشكلة التنافر في عالم اليوم
إن التناغم الاجتماعي المعبّر عن حالة الكمال، يرتبط بالسعادة والرفاهية والسلام، والجمال المادي والاجتماعي والروحي. أما التنافر فيحمل في طياته شيئاً من القبح، بل من النفور والفظاعة، ويؤدي إلى الخلافات. ونرى التنافر في أيامنا هذه على صورة عراكات مع الجيران، وفي المدرسة وفي السياسية، والتسلح الدائم والحروب المتعددة، وغيرها من النزاعات التي تفني البشرية، وكذلك في التغييرات المتسارعة والثورات المفاجئة، وغيرها من الأحداث التي يصعب توقعها. وهذا كله يستنفد الطاقات الاجتماعية، ويؤدي بالبلدان والحضارات إلى الانهيار. ولكن هل يوجد عالم آخر؟
لكي نكون صادقين؛ فإن عالم اليوم لا يقتصر على الصراع على السلطة والسيادة، وما يرتبط بهما من شرور وقبح أخلاقي، بل نجد فيه كذلك الكثير من الصلاح والجمال بكل الأبعاد الثقافية، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار التقدم العلمي التقني، وخاصة في مجال التكنولوجيا العسكرية، وإمكانيات استخدام أسلحة الدمار الشامل، وبأن عالمنا ما يزال مجالا للتنافر، سنجد تهديداً حقيقياً لاستمرار البشرية. في عصر العولمة وضعف الدول وارتهان علاقاتهما ببعضها، فإن ما يحدث في كل مكان ما في العالم يؤثر على ما يحدث في أماكن أخرى، وقد يؤدي نزاع إقليمي إلى نزاع عالمي.
ويذهب جوليان إلى أن اختزال الناس في صورة واحدة مبسطة، وفي أفراد تقودهم إرادة القوة والمصالح الخاصة فقط، أدى إلى معيارية وميكانيكية الحياة. فتراجعت الأسئلة الوجودية المتعلقة بالدين والأخلاق من الحياة العامة إلى الحياة الخاصة، وحلت الأيديولوجيات والتفكير الذرائعي محل التفكير الاستدراكي والقِيَمي، والعلاقات العابرة محل العلاقة الزوجية، وأُجبرنا على العزلة والفقر الروحي في عالم مليء بالنزاعات.
الإنسان.. والثقافة والحضارة
الميزة الأساسية في الإنسان هي أنه يستطيع أن ينتج الثقافة، فلا ثقافة بدون الإنسان، ولا إنسان بدون ثقافة. فكيف نفهم ذلك؟
مفهوم الثقافة كما نستخدمه اليوم يرتبط عادة بالإبداع الأدبي والفني. والإنسان المثقف هو الفرد الذي تلقى تربيةً ومؤهلاتٍ علمية بشكل جيد، ولكننا حين نقول: لا ثقافة بدون إنسان، ولا إنسان بدون ثقافة؛ إنما نقصد شيئاً آخر. فكملة ثقافة في أهم معانيها مرتبطة بمواكبة وتجديد قوانا المعرفية والإبداعية الكامنة وتهذيب أنفسنا؛ إنها طريقة فريدة للعيش البشري. وهي تعتمد على النشاط المنظم، والذي بنتيجته يتجاوز الناس محدوديتهم النابعة من حيوانيتهم، وبشكل أعم من بيولوجيتهم لكي يقيموا بيئتهم المُصطنعة الخاصة بهم.
إن المهارة في إنتاج الثقافة؛ أي إنتاج بيئة مصطنعة مركبة من عناصر مادية واجتماعية وروحية ميزة بشرية نادرة. فعلى عكس الحيوانات نحن لا نحيا في بيئة طبيعية، بل في بيئة ثقافية محددة تدخل فيها العادات والتسليات والتربية والأخلاق، والقانون والسياسة والاقتصاد، والعلوم والفلسفة والدين والفن. الطبيعة المحيطة بالحيوانات تشكل امتداداً لها، وهي تتأقلم مع هذا المحيط، بل مترسخة فيه. أما الإنسان فإنه يتخطى ذلك حين ينتج الثقافة.
وحتى لو افترضنا أن الحدود الفاصلة بين الإنسان والحيوان، ليست واضحة، وأن بعض الأنواع الراقية من الحيوانات تتميز بالتنظيم العالي ولديها بعض العادات، فعلينا أن نعترف أنه لا تقوم كما يفعل الإنسان بتكوين نفسها، ومكان عيشها بشكل واع ومستمر. كما أنها لا تملك المقدرة على التأمل العقلاني والأخلاقي في حياتها.
وتظهر مناقب المرء أي ميزاته وقيمه الثقافية في النمو المتكامل الروحي؛ أي الأخلاقي والعقلاني وهي: المعاملة اللطيفة والشجاعة وصفاء النفس وعمل الخير، والجد والعدالة والحكمة والحب. ونظراً لأن الإنسان يستطيع زرع مكارم الأخلاق، كما يستطيع زرع المساوئ في نفسه، فيصير بإمكانه السعي نحو الكمال الأخلاقي واكتمال الشخصية، ولكنه كذلك قد يسقط إلى الحضيض على المستوى الأخلاقي.
وبالتالي؛ فإن ما نجده عند الفلاسفة البدعويين أو اللاهوتيين في اختزال الإنسان بصفات بسيطة كالأنانية والشهوة أو إرادة القوة، لا يعكس ماهية الطبيعة البشرية. بل بالأحرى يبسطها ويهبط بها إلى المستوى الحيواني. وفعلاً نجد في عالم الحيوان أنّ تحكّم الغرائز والشهوات يلعب دوراً أساسياً في حياته، ولكن الإنسان وعبر القرون، وبنتيجة التطور صنع محيطه الثقافي الذي غيّر تصرفاته وعدّلها.
نستطيع أن نُنمي ما بداخلنا من قدرات، ونملك إمكانية فعل الخير والشر، أن نحيا في سلام أو حالة حرب، أو أن نحب أو نكره. من نحن وكيف نتصرف؟ يتعلق هذا الأمر بالعامل المجدِّد لنشاطاتنا من القيم الثقافية والأخلاقية التي نتعلمها ونتقبلها. ومن زمن بعيد لاحظ سقراط أن الناس هم أكمل المخلوقات. قد يتعاملون مع بعضهم برقة، ولكنهم أيضاً قد يتصرفون بقسوة لا تجدها إلا عند أكثر الحيوانات وحشية.
قد تقود الأنانية المفرطة –خاصة إذا سمح المجتمع بذلك- الإنسان فرداً أو جماعة، أن ينفّذ ما يريد على حساب الآخرين، ويتنازع على السلطة والهيمنة على الآخرين لا يقيده في ذلك أي قيد، ولكنه كذلك يستطيع وبفضل العملية الحضارية أن يهذّب نفسه أخلاقياً، ويتعلم التعاون في نطاق الجماعة، ويكتسب خصالاً كصفاء الروح والجد، وروح الزّمالة والرحمة.
إننا في أزمنتنا المعاصرة نعيش في مجموعات اجتماعية كبيرة، أو تكتلات مرتبطة ببعضها، فليس لنا إلا أن نعيش إما في حياة متحضرة أو بدون الحضارة. كما أن انهيار الحضارة يعني العودة إلى البدائية، وبكلمة أخرى إلى البربرية، إلى حالة تفقد فيها القواعد التي صاغتها الحضارة عبر القرون أهميتها، وهي التي تمكننا من تجديد الإمكانيات الكامنة في الإنسان. وقد تُنبذ قواعد أخلاقية صاغتها القرون ليبقى قانون سيطرة القوي على الضعيف، ويهبط المستوى الفكري ومن بعد العلوم والتكنولوجيا، ثم الصناعة والزراعة لتنتهي بالمجاعات، والهبوط إلى مستوى الصراع البدائي من أجل البقاء. ولذلك لا يمكن أن نختار إضعاف أو هدم حضارتنا، بل يجب أن نرسم أفضل الطرق للتطور الحضاري، بحيث تُفضي إلى الرفاه والنمو الأخلاقي والعقلاني للإنسان.
من هو الإنسان
يتساءل جوليان لنفكر من نحن؟ الإجابة على هذا السؤال تكمن في تسمية الإنسان ذاتها في أنه: homo sapiens أي الإنسان العاقل أي كائن يفكر. جوهرنا إذًا يكمن في أننا نفكر. التفكير عملية معرفية مركبة، تستند إلى ربط الظواهر ببعضها، واستنتاج النتائج من ذلك، وإصدار الأحكام واستخراج أخرى منها ومناقشتها، وليس التفكير، صفة محددة تشكل طبيعة الإنسان.
وبالنظر إلى ما نتميز به من المقدر على التفكير بأنفسنا، وهي تأملات تتضمن مسائل ذات طبيعة أخلاقية، لذلك فنحن لسنا كائنات عاقلة مفكرة بل أخلاقية كذلك. وإلى ذلك وبالنظر إلى مقدرتنا على الترفُّع عن شهواتنا وغرائزنا البيولوجية، وتجديد القوى الكامنة فينا، وتحويل طرق حياتنا وهو ما ينعكس في الثقافة التي نصنعها؛ فإننا كائنات حرة، وحريتنا ليست انعداماً للقيود أو فعل ما نريد دون قيود، بل هي على الأصح تحكُّمُنا المتزايد في الظروف المحيطة بنا وبأنفسنا.
إنها تقرير للمصير، وفي نفس الوقت إمكانية نمو الشخصية وتحقيق الذات، بكلمة واحدة إن العقل والأخلاق والحرية تشكّل جوهر الإنسان، وهي نقطة انطلاق البشرية، ولكنها في نفس الوقت مهمة كبرى.
إذا نظرنا إلى الإنسان من وجهة النظر التطورية، سنجد أنه كائن لم يكتمل في سعيه نحو الكمال بعد. هدفنا أن نطور أنفسنا ذهنياً وأخلاقياً. فهدف التطور في الحياة هو الكمال والاكتمال، والحياة البشرية رحلة نحو مجالات أرحب للحرية، وكمالات أخلاقية وذهنية.
الدليل على تطور الإنسان الأخلاقي هو التدرج في جعله على خُلق في الحياة الاجتماعية. بفضل القوانين الجيدة الناظمة في بلد ما تترسخ العادات فيكتسب الناس ميزات إيجابية معينة، وتتشكل مدرسة للأخلاق، وكما كتب ليون بيتراجينسكي: القانون مؤسسة تربوية للأمة وللبشرية، أما الدليل على التطور الذهني فهو نوعية التعليم والتطور الخلاق للعلوم والتكنولوجيا. ولكن يجب الانتباه إلى أن المستوى الأخلاقي والذهني اللذين تنتجهما حضارة معينة في المجتمع قد يتعرضان للانهيار، والناس إلى الانحطاط الأخلاقي والذهني، أي العودة إلى الهمجية.
إن البشرية وهي تنسلخ عن تقاليدها وعن الإيمان بالله، وتخضع للإيديولوجيات أو لأشكال التلقين، وتقلّص توجهاتها الحياتية نحو البحث عن الملذات أو إرادة القوة، وتخترع العداوات، وتستخدم ثرواتها المادية والاجتماعية والروحية في التسلح، وكثيراً ما تتجاذبها الحروب والنزاعات، إن هذه البشرية لن تقوم بمهمتها في استمرارية التطور. ولكن ما نظن أنه صعب أو بعيد المنال –نقطة الوصول- هو في الحقيقة سهل وفي متناول اليد. علينا أن نعثر ونتحقق بشكل صحيح، وننفذ ما في ذواتنا من إنسانية، والذي نترجمه عملياً في مقدرتنا على إنتاج الثقافة، وتجديد المقدّرات الكامنة فينا، وتطوير شخصيتنا وتوسيع مجالات حرياتنا وسعينا نحو الكمال.
بفضل هذه الأفكار نصبح أكثر مهارة في فهم ماهية الإنسان والكشف عن جوهر إنسانيتنا، ونسوغ بدقة مفهوم الكرامة الإنسانية. فالإنسان كهدف في ذاته وليس وسيلة لهدف؛ يعني أنّ لديه مهمةً ينفّذها وهي النمو الأخلاقي التام، وبشكل أعم تحقيق الذات، ولا يمكن أن يُعامل من قبل الآخرين كوسيلة. كما لا يمكن أن يُسخَّر ضد إرادته لخدمة أهداف حتى لو كانت أهدافاً سامية.
فكل واحد منها في رأي جوليان يجب أن يعي مهمته السامية؛ أي تطوره الأخلاقي والذهني الذي يتم عبر صناعة الثقافة. فالإنسان يصنع الثقافة ويصبح أكثر تمدناً حين يحقق ما في ذاته، وينفّذ في ذاته فَهْمَهُ وأخلاقه، هذه المهمة الاستثنائية في إنتاج ثقافة متقدمة، وفي التطور الفردي والاجتماعي الذي يشكل القوة المُحركة للمرحلة الحاضرة من التطور، هذه المهارة هي أساس الكرامة، تلك القيمة النادرة للكائنات البشرية.
يمكننا أن نكون سعداء في هذا العالم أفراداً وجماعاتٍ؛ ولكي نكون سعداء ليس علينا أن ننفصل عن مجتمعنا، فلا أحد خُلق كي يعيش وحيداً منعزلاً. فالسكينة الداخلية وما ينبع منها من سعادة هي تجارب سامية ورائعة، لكنها لا تستنفد كل إمكانياتها في تجرية السعادة. كما أن البحث عن الاكتمال الروحي داخل الوعي لا يعني أن علينا أن نهمل أشياء من الأبعاد الخارجية. كل العناصر تكمّل بعضها وتؤثّر على بعضها. فإذا كنا جائعين ومحتاجين للطعام، أو لو عشنا في مجتمع فيه اضطهاد ديني. في مثل هذه الحالة لا يمكننا أن نتفرّغ للدراسات الفلسفية ونطور شخصيتنا، ونختار مسالكنا الروحية. ومن هنا فإن محيطنا المادي والاجتماعي مهم إلى جانب المجال الروحي.