الإطار التاريخي والإبستيمولوجي للسؤال
يُمثِّل كتاب "كيف ينهض العرب" للأديب والمفكر اللبناني عمر فاخوري (1895 – 1946) أحد النصوص التأسيسية المركزية في خطاب النهضة العربية في النصف الأول من القرن العشرين، ولا تنبغي قراءة هذا السؤال – "كيف ينهض العرب؟" – بوصفه استفهامًا تقنيًا طوباويًا، بل بوصفه إشكالية فلسفية وجودية ومعرفية بالدرجة الأولى، فهو يسائل شرط إمكانية النهضة ذاته، ويحفر في طبقات الوعي الجمعي العربي بحثًا عن جذور "العطب" الحضاري، ويقترح، من خلال منهجية نقدية لاذعة، مسارًا للخروج من "الدهر السالب" (بتعبير هيغل) إلى فضاء التاريخ الفاعل.
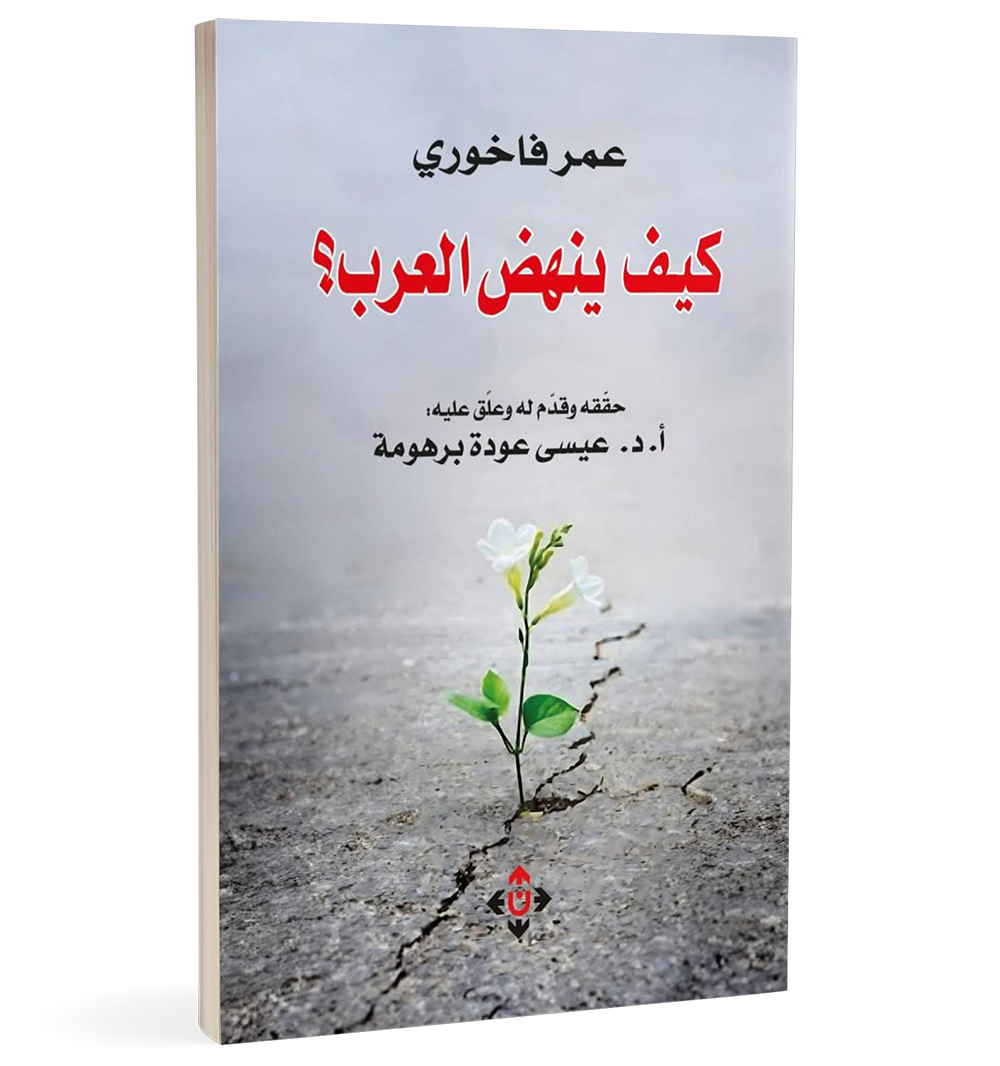
يأتي هذا الكتاب في سياق زمني مضطرب، إذْ كانت الذات العربية تتلقى صدمات متتالية: انهيار الخلافة العثمانية، واقتسام التركة عبر اتفاقيات سايكس بيكو وسان ريمو، وبدء مرحلة الاستعمار المباشر، وصعود المشروع الصهيوني، وفي هذا الفراغ الجيوسياسي والمعنوي، برزت أسئلة الهُوية والنهضة والتحديث بإلحاح غير مسبوق، فانطلق فاخوري من موقع المثقف العضوي (بالمعنى الغرامشي) الذي يتجاوز تشخيص العلل إلى اقتراح علاج يكون في غالب الأحيان "مُرًا" لكنه ضروري.
يهدف هذا التحليل النقدي إلى تفكيك الخطاب النهضوي عند عمر فاخوري، وفحص مقولاته المركزية (كالتقليد، والحرية، والعقل، والأخلاق) تحت مجهر الفلسفة النقدية، وقياس درجة اتساقه الداخلي، وتقويم إسهامه في الحوار الدائر حول النهضة ومآلاته في ضَوء التراث النقدي العربي اللاحق. وقد اعتمدنا على إطار نظري يستند إلى فلسفة التنوير (كانط)، والنقد الجدلي (هيغل وماركس)، ومقولات ما بعد الاستعمار (فانون وسعيد)، ونظريات التحديث والعلمانية، بالإضافة إلى حواره مع رواد النهضة الآخرين مثل الطهطاوي، الكواكبي.
التشخيص الفلسفي للعلة: بين "المرض" و"الأعراض"
يبدأ فاخوري بوصف "كيف" تكون النهضة، ويشرّح جذور "الجمود" الذي منعها. فيتجاوز التحليل السطوي للأعراض (كالتخلف التقني أو العسكري) إلى نقد البنية الفكرية والنفسية العميقة.
1. نقد العقل التقليدي: الاستلاب في مواجهة التراث: يرى فاخوري أن العلّة الأساسية تكمن في علاقة العرب المشوّهة مع تراثهم، فهو لا يهاجم التراث ذاته، بل "التقليد" بوصفها آلية استلابية. فلم يعد العرب، في تحليله، يمتلكون تراثهم بل أصبح التراث يمتلكهم، وقد تحوّل التراث من مادة حية قابلة للنقد والاستئناف إلى صنم مقدس يُتلى ولا يُفكَّر فيه. وأفضت هذه العلاقة "الطقوسية" إلى تصيير العقل العربي عاجزًا عن الإنتاج والإبداع، مكتفيًا باجترار مقولات السابقين. ويمكن إسقاط مفهوم "اغتراب" أو "استلاب" (Alienation) الهيغلي الماركسي، فيمسي المنتَج (التراث) قوة غريبة ومعادية تسيطر على منتِجها (الأمة) وتسلبه قدرته على الفعل الحر، وتتطلب النهضة، تبعًا لذلك، "قطيعة إبيستيمولوجية" (بمعنى باشلار) مع نمط التفكير التقليدي، لا مع مضمون التراث بالضرورة.
2. أخلاقيات العبودية والاستبداد: الجانب السيكولوجي للجمود: يمتد تحليل فاخوري من مجال الفكر إلى مجال الأخلاق والسياسة، فيربط جذريًا بين الاستبداد السياسي والاستبداد الفكري والاستبداد الأخلاقي، ولا يكتفي النظام الاستبدادي بقمع الجسد، بل ينتج "عقلية العبد" (Slave Mentality) التي تتقبل الخنوع وتخشى الحرية وتكره المسؤولية، وتتسرب هذه العقلية، التي حللها لاحقًا إريك فروم في "الخوف من الحرية"، إلى مجالات الحياة كلها: في التعليم (التلقين بدل التفكير)، وفي الدين (التقليد بدل الاجتهاد)، وفي الأدب (المحاكاة بدل الإبداع). ويرى فاخوري أن النهضة دون ثورة أخلاقية تقتلع فضائل الخنوع والتملق وتُعيد بناء "الأخلاق النبيلة" القائمة على الكرامة والمسؤولية الفردية والشجاعة المدنية، ويقترب هذا الطرح من مفهوم "إرادة القوة" عند (نيتشه) ليس بمعنى الهيمنة، بل بمعنى إرادة الحياة والتقدم والتفوق الذاتي.
3. الازدواجية والتناقض: أزمة الذات المنشطرة: يشخّص فاخوري ظاهرة الازدواجية في الشخصية العربية، إذْ يعيش الفرد في حالة انفصام بين القول والفعل، بين المبادئ المعلنة والممارسة الفعلية، بين التظاهر بالتدين وغياب الأخلاق العملية، بين التغني بالماضي والإعراض عن بناء الحاضر، وهذه الازدواجية، من منظور سيكو اجتماعي، هي آلية دفاعية للتعايش مع التناقضات الداخلية للمجتمع دون حلها. إنها تعبير عن "سوء الإيمان" (Bad Faith) الوجودي السارتري، فيخدع الفرد نفسه هربًا من حرية الاختيار وثقل المسؤولية، فالنهضة، بناءً عليه، تتطلب مصالحة الذات مع نفسها، وتحقيقًا للصدق والشفافية على مستوى الفرد والجماعة.
مقترحات النهضة: بين العقلانية التنويرية والخصوصية الثقافية
يقدم فاخوري مقابل هذا التشخيص القاسي، رؤيته للخروج، التي تندرج في إطار المشروع التنويري (Enlightenment) بشكل أساسي، ولكن مع وعي حاد بخصوصية السياق العربي.
1. الحرية شرط مطلق: من التحرير السياسي إلى التحرر الذاتي: تتبوأ الحرية مركز الصدارة في مشروع فاخوري النهضوي، ولكنه لا يقصرها على "التحرير" من الاستعمار الخارجي (الذي هو شرط ضروري لكن غير كاف)، بل يذهب إلى مفهوم أعمق هو "التحرر" الداخلي، فتحرر العقل من سلطة التقليد، وتحّرر الإرادة من عبودية الخوف، وتحّرر الضمير من النفاق والازدواجية، فهذه الحرية هي التي تخلق الفرد المواطن المسؤول، حجر الأساس في بناء الأمة الحديثة. ونجد صدى واضحًا لشعار تنوير كانط: "تجرأ على استخدام عقلك الخاص!" (Sapere Aude)، فالنهضة هي، في جوهرها، خروج الإنسان العربي من "قصوره الذي اقترفه في حق نفسه" وذلك لسبب لا يكمن في قصور عقله، بل في انعدام العزيمة والشجاعة على استخدامه دون قيادة الآخر.
2. العقلانية النقدية منهجًا: العقل عند فاخوري هو الأداة الوحيدة والسلطة العليا التي يجب أن تحكم الحياة الفكرية والاجتماعية، وهو لا يعني العقل المجرد المنفصل عن الواقع (كما في المثالية المتطرفة)، بل "العقل النقدي" الذي يخضع كل شيء للفحص والتمحيص: التراث، الدين، السياسة، العادات، فهذا الموقف يتقاطع مع مشروع "نقد العقل" الكانطي، لكنه يطبقه على مجال التاريخ والمجتمع العربي. فالعقلانية هي الضامن ضد الخرافة والأسطورة والشعبوية، وهي التي تسمح بقراءة التراث قراءة نقدية تستعيد روحه الإبداعية وتتجاوز قشوره الجمودية.
3. الأصالة والمعاصرة: نحو توليف جدلي: على عكس بعض الدعوات المتطرفة التي انغمست في التغريب الكامل أو الانكفاء على التراث، سعى فاخوري إلى صيغة توفيقية، فهو لا يدعو إلى قطع الصلة مع الماضي، بل إلى إعادة تعريف هذه الصلة. والأصالة ليست حفظ التراث، بل هي القدرة على إنتاجه من جديد، والمعاصرة ليست تقليد الغرب، بل هي استيعاب مناهجه في التفكير والعلم وإبداع صيغ محلية للتحديث، ويمكن فهم هذا الموقف عبر مفهوم "الجدل" (Dialectic) الهيغلي: إذ يكون التراث (الأطروحة)، والحداثة الغربية (نقيضها)، والنهضة الحقيقية هي (التركيب) الذي يستوعب ويتجاوز كليهما في آن واحد، ليولد حالة جديدة أصيلة ومعاصرة، وتتقاطع هذه الرؤية إلى حد كبير مع مشروع طه حسين في "مستقبل الثقافة في مصر".
4. الدين والعلمانية: إشكالية لم تحسم بشكل كامل: يعامل فاخوري الدين بإجلال كبير، لكنه يهاجم بشدة "التدين الشعوذي" والاستغلال السياسي للدين، فقد كانت دعوته إلى فصل الدين عن السياسة (أي العلمانية) واضحة، لكنها لم تكن علمانية عدائية تجاه الدين بل علمانية "وظيفية" تهدف إلى حماية الدين من تدنيس السياسة، وحماية السياسة من قدسية الدين، ومن ثَم تحرير المجال العام ليكون ساحة للعقل والحوار المدني. ويذكرنا هذا الموقف بطرح علي عبد الرازق في "الإسلام وأصول الحكم"، حيث يكون الخلاص في تحرير السلطة السياسية من الإطار الثيوقراطي (الديني) وإعادتها إلى مجال الشورى والعقد الاجتماعي البشري.
قراءة نقدية في مشروع فاخوري: الإنجازات والمحددات
رغم ثراء طرح فاخوري ورصانته، إلا أنه لا يخلو من ثغرات وإشكاليات تسمح بها القراءة النقدية المتأخرة.
1. النزعة المثالية والطوباوية: يقع فاخوري، ككثير من رواد التنوير، في فخ "المثالية"، فيركز على العوامل الفكرية والأخلاقية (البنية الفوقية في المصطلح الماركسي)، ويتجاهل إلى حد كبير العوامل المادية والاقتصادية والطبقية (البنية التحتية). ويبقى تحليل أسباب التخلف والنهضة دون معالجة جذرية لمسائل مثل نمط الإنتاج، التبعية الاقتصادية، التوزيع غير العادل للثروة، والاستغلال الامبريالي، تحليلاً ناقصًا، فقد غفل عن أن تغيير الوعي (رغم أهميته) لا يكفي دون تغيير الشروط المادية التي تنتج هذا الوعي وتعيد إنتاجه. هذا النقد هو في صميم المادية التاريخية الماركسية.
2. النظرة إلى الغرب: بين التبني النقدي والانبهار غير النقدي: يتعامل فاخوري مع "الغرب" ككيان أحادي متجانس هو مصدر العقلانية والحداثة، فهو يقع في فخ "الثنائية الضدية" (الشرق/الغرب) التي سينتقدها لاحقًا إدوارد سعيد في "الاستشراق". فلقد غاب عن فاخوري أن الحداثة الغربية نفسها هي مشروع إشكالي، يحمل داخله تناقضاته (كالحروب العالمية، الاستعمار، الاستغلال) وأنه ليس نموذجًا يجب استنساخه حرفيًا، بل يجب نقد نقيضه كما نقدنا تراثنا. فافتقر مشروعه إلى "نقد حداثة الغرب" بالقدر نفسه من الحدة التي انتهجها في "نقد تقليد الشرق".
3. المركزية الأوروبية الخفية: مرتبطًا بالنقطة السابقة، يمكن اتهام خطاب فاخوري، رغم غيرته القومية، بأنه يحمل في طياته "مركزية أوروبية" (Eurocentrism) خفية، فمعايير التقدم والرقي التي يتبناها هي في الغالب معايير غربية (العقلانية، الفردانية، العلمانية، الديمقراطية الليبرالية). فلم يطرح فاخوري بشكل جذري إمكانية أن تكون للنهضة العربية مسار مختلف، أو أن تنتج حداثة بديلة (Alternative Modernity) ذات مرجعيات قيمية مختلفة، ربما تأخذ من الغرب علومه ولكن لا تأخذ بالضرورة كل قيمه ونمط حياته، وقد تطور هذا النقد لاحقًا في أعمال مفكرين مثل حسن حنفي في مشروعه "التراث والتجديد".
4. إشكالية "الفرد" و"الجماعة": يركز فاخوري على تحرير الفرد شرطًا للنهضة، متأثرًا بالفلسفة الليبرالية، ولكنه قد يغفل عن الطبيعة الجماعية والروح المجتمعية (Gemeinschaft) التي تميز العديد من المجتمعات العربية. السؤال الذي يثيره هذا الطرح هو: هل يمكن بناء نهضة على مفاهيم فردية بحتة في مجتمعات ما تزال الروابط العائلية والطائفية والقبلية تؤدي دورًا مركزيًا فيها؟ ألا يؤدي التركيز المفرط على الفرد إلى تفكيك النسيج الاجتماعي دون بناء بديل قوي؟ هذا هو نقد (Communitarianism) للليبرالية.
5. الخطاب النخبوي والبعيد عن الجماهير: كتاب "كيف ينهض العرب" موجه في الأساس إلى النخبة المثقفة، فلغته فلسفية وأسلوبه نقدي عال، وهذا يطرح إشكالية التواصل مع العامة الذين هم، في النهاية، يجب أن يكونوا وقود النهضة وهدفها. فكيف يمكن لنخبة متنورة أن تقود تغييرًا دون أن تسقط في فخ "استبداد المثقفين" أو "دكتاتورية التنوير"؟ وكيف يمكن ترجمة هذه الأفكار المجردة إلى برامج عمل وسياسات وممارسات يومية تلامس حياة الناس العاديين؟ هذا هو الإشكال الذي واجه كل مشاريع النهضة من أعلى.
الخاتمة: تراث فاخوري وإشكالية النهضة المستعصية
بعد أكثر من سبعة عقود على صدوره، يظل سؤال عمر فاخوري "كيف ينهض العرب"؟ يتردد بقوة، بل perhaps بقوة أكبر، في واقعنا العربي المأزوم. مما يعني أن الإشكاليات التي نبه إليها – التقليد، الاستبداد، الازدواجية، غياب العقل النقدي – ما برحت فاعلة وبقوة.
وتكمن قيمة فاخوري في أنه كان "طبيبًا" ماهرًا في تشخيص العلل، وشجاعًا في وصف الدواء المر. فقدّم واحدًا من أكثر التحليلات عمقًا وصراحة لجذور الأزمة الحضارية العربية. مشروعه كان محاولة جادة لتأسيس "أنوار عربية" (Arab Enlightenment) تستلهم روح كانط وهيغل ولكن في تربة عربية إسلامية.
إلا أن المحددات التي أشرنا إليها (المثالية، النظرة الأحادية للغرب، النخبوية) تفسر جزئيًا (why) أن المشروع بقي حبيس الأرفف ولم يتحول إلى حركة جماهيرية تغييرية. لقد فهم فاخوري أن النهضة هي "ثورة في التكوين الذهني والأخلاقي" قبل أن تكون ثورة في الآلات والمؤسسات، لكنه قلل من شأن تعقيدات وقوى الردة والجمود التي تقاوم هذه الثورة، خاصة عندما تكون مدعومة بمصالح مادية وإمبريالية قوية.
وصفوة القول: يبقى عمر فاخوري واحدًا من عمالقة الفكر النهضوي الذين يجب قراءتهم ليس منجزةً مغلقة، بل نقطة انطلاق لنقد ذاتي أكثر جذرية، يشمل تراثنا وحداثتنا، وذاتنا والآخر، ويوائم بين التحرر الروحي والفكري والتحرر الاقتصادي والسياسي. سؤال النهضة لم يُجب عليه بعد، وكتاب فاخوري يظل مرجعًا أساسيًا وأداة لا غنى عنها لأي مَن يجرؤ على الخوض في هذا السؤال المصيري.