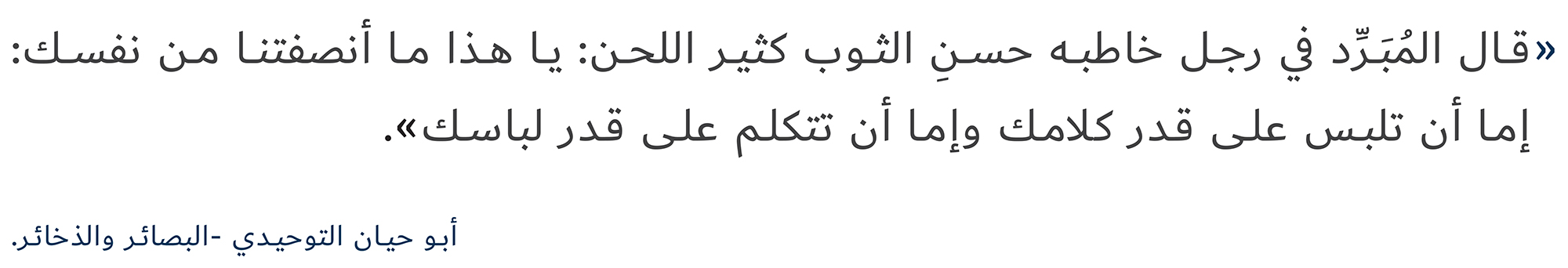
لا ريب أن التعليق الرياضي من بين أكثر أشكال الخطاب الإعلامي حضوراً وانتشاراً في المجال العربي المعاصر، لما يتصل به من متابعة جماهيرية واسعة، ولما يملكه من قدرة على التأثير في الذوق العام وتشكيل أنماط التلقي اللغوي؛ ومع ذلك، نادراً ما ينظر إلى هذا الخطاب بوصفه ممارسة لغوية وثقافية تستحق التحليل، إذْ غالباً ما يختزل في بعده التقني أو الانفعالي، ويفصل عن سياقه اللغوي والمعرفي الأوسع.
تأتي هذه المقالة في سياق مساءلة وضع اللغة العربية في الإعلام الرياضي، انطلاقاً من نموذج كأس العرب، بوصفه حدثاً عربياً جامعاً أتاح إمكان رصد طرائق اشتغال اللغة في التعليق، وما يعتريها من مظاهر تذبذب بين الفصحى والعامية، وبين السلامة واللحن؛ وليس المقصود من ذلك إصدار أحكام معيارية على أداء المعلقين، بقدر ما يراد الوقوف على الشروط الثقافية واللغوية التي تحكم هذا الأداء، وتفسير ما يبدو من اختلال في ضوء تحولات أعمق عرفتها علاقة المجتمع العربي بلسانه المبين.
تنطلق الورقة من فرضية مؤداها أن ما يطال اللغة في التعليق الرياضي ليس تعبيراً عن عجز بنيوي في العربية، وإنما هو نتيجة سياقات تاريخية واجتماعية وثقافية أثرت في طرائق اكتساب اللغة واستعمالها، وأسهمت في إضعاف حضور الفصحى بوصفها أداة تواصل حي في الفضاء العمومي؛ وانطلاقاً من ذلك، فإن تحليل التعليق الرياضي يفتح أفقاً أوسع لفهم أزمة الاستعمال اللغوي في الإعلام، ويتيح التفكير في سبل الارتقاء به، خاصة في ظل التظاهرات الرياضية الكبرى المقبلة.
المحور الأول:
التعليق الرياضي بين نقل الحدث وإنتاج المعنى
ينظر إلى التعليق الرياضي، في التداول الإعلامي، باعتباره ممارسة صوتية مرافقة للحدث الرياضي، وظيفتها الأساسية نقل مجريات اللعب وإضفاء عنصر التشويق على المتابعة، بيد أن هذا التوصيف يظل قاصراً، لأنه يغفل البعد الخطابي والثقافي الذي ينطوي عليه التعليق، بوصفه أحد أشكال الخطاب الإعلامي الأكثر حضوراً في المجال العمومي، وهو ما يجعل العناية باللسان جزءاً من وظيفة الخطاب ذاتها، لا مجرد زينة لفظية، إذْ إن البيان كما تقرر في التراث البلاغي لا ينفصل عن سلامة الأداء وتهذيب العبارة.
فالتعليق الرياضي ليس مجرد وصف محايد لما يقع في الملعب، بل هو خطاب لغوي ينتج المعنى في الزمن الآني، ويؤطر الحدث ضمن منظومة من القيم والدلالات، تتصل بالمنافسة والهوية والانتماء والذاكرة الجماعية؛ والمعلق، في هذا السياق، لا يكتفي بنقل الوقائع، وإنما يشارك في بنائها رمزياً، من خلال اختياراته اللغوية ونبرته وطريقة ترتيبه للأحداث؛ وهي اختيارات تظل في جوهرها رهينة بالكفاية البيانية التي يتملكها وبقدرته على مخاطبة المتلقي بما يلائم أفق انتظاره. ولله در الأخفش حين قال:
لَعمرك ما اللَّحن من شِيمتي ... ولا أنَا مَن خَطَأً ألحنُ
ولكنني قد عرفت الأنام ... أخاطب كُلاً بما يحسنُ
ويكتسب هذا الخطاب أهميته من اتساع دائرة متلقيه، إذْ يخاطب جمهوراً متنوعاً في مستواه الثقافي واللغوي ويتوجه إليه في لحظة انفعال جماعي، حيث تكون اللغة أقلُّ خضوعاً للتمحيص وأكثر قابلية للتأثير؛ ليغدو التعليق الرياضي بذلك، أحد الفضاءات الأساسية التي تتشكل فيها الذائقة اللغوية العامة، سواء من حيث ترسيخ نماذج لغوية سليمة، أو من حيث تطبيع أنماط استعمال مختلة، وهو ما يضفي على هذا الخطاب مسؤولية مضاعفة تتجاوز الإخبار إلى التشكيل.
وتزداد أهمية هذا المعطى في السياق العربي، حيث تنهل اللغة العربية من اقتران روافد الفصحى والعاميات؛ فالتعليق الرياضي، بحكم طبيعته الشفوية والمرتجلة، يتحول إلى مجال اختبار لهذه الازدواجية ويكشف عن حدود قدرة الفصحى على التحول إلى أداة تواصل حي في الفضاء الإعلامي خارج السياقات المدرسية والكتابية، وهي حدود لا يمكن فهمها دون استحضار مركزية أدوات البيان ذاتها، وفي مقدمتها النحو الذي جعله ابن الأثير في صميم القول البياني حين أكد أن: "علم النحو هو أول ما ينبغي إتقان معرفته لكل من ينطق باللسان العربي، ليأمن مَعرّة اللحن"، فهو عندهم في مقام العار والفضيحة التي تجعل المرء سُبة بين الناس.
وقد مثلت كأس العرب، بوصفها حدثاً رياضياً عربياً جامعاً، مناسبة كاشفة لهذا الواقع، إذْ أتاحت الوقوف على سبل اشتغال اللغة في التعليق الرياضي وما يعتريها من تذبذب بين الالتزام بالفصحى والانزلاق إلى العامية، وبين السعي إلى الدقة اللغوية والخضوع لإكراهات السرعة والانفعال؛ وبهذا، يصبح التعليق الرياضي مدخلاً مناسباً لتحليل أوسع لوضع اللغة العربية في الإعلام، وفهم الشروط التي تتحكم في حضورها أو تراجعها داخل المجال العمومي.
المحور الثاني:
اللحن وفساد اللسان؛ خلل فردي أم اختلال بنيوي؟
يقصد باللحن الخروج عن سنن العربية في مستويات النطق أو التركيب أو الدلالة، أما فساد اللسان فهو تحول هذا المعطى من حالة استثنائية إلى ممارسة شائعة، تفقد معها الجماعة اللغوية حس الاستنكار، فيغدو الخطأ مألوفاً، بل مقبولا في التداول اليومي؛ وبهذا المعنى، لا يكون اللحن مجرد زلة لسان فردية؛ وإنما يصبح علامة على اختلال أعمق في علاقة المجتمع بلغته، وهو اختلال لا يقف عند حدود الأداء، بل يمس الذوق والمعيار معاً، ومما يستشهد به أهل البيان أن: «معلم الرشيد كان يضرب على الخطإ واحداً، وعلى اللحن سبعاً»، دلالة على أن فساد اللسان أضر عند القوم من فساد المعنى.
ولا يمكن رد هذا الوهن إلى قصور في بنية اللغة العربية أو إلى عجز في نظامها، إذْ أثبتت العربية، تاريخياً، قدرة عالية على الاستيعاب والتوليد والتكيف؛ وإنما ينبغي النظر إليه بوصفه نتيجة مركبة لعوامل تاريخية واجتماعية وثقافية تراكمت عبر الزمن، وأثرت في طرائق اكتساب اللغة وممارستها، خاصة في الفضاء العمومي، وهو ما تنبه إليه اللغويون الأوائل حين قرنوا شيوع اللحن بتحولات الاجتماع، فقالوا: "وإنما فشا اللحن للسبايا التي كثرت في الإسلام من الأعاجم وأولادهن، فإنهم نزعوا في اللكنة إلى الأخوال".
فمن أبرز العوامل اختلال السليقة اللغوية منذ اتساع رقعة الدولة الإسلامية واختلاط العرب بغيرهم، حيث انتقلت العربية من لغة تكتسب بالفطرة داخل محيط لغوي متجانس إلى لغة تتعلم بالقواعد والضوابط؛ وقد أدى هذا التحول، على أهميته في حفظ اللغة، إلى إضعاف الملكة الطبيعية وجعل الأداء اللغوي رهيناً بمعرفة نظرية لا تتحول دائماً إلى كفاية استعمالية، وهو ما يفسر استمرار اللحن حتى لدى المتعلمين، مما حدا بهم إلى تقرير أن: "اللَّحّان إنسان ناقص"، فكمال الإنسان عندهم لا يتحقق إلا بفصاحة اللسان.
كما أسهمت الازدواجية اللغوية بين الفصحى والعاميات في تعميق هذا الاختلال، إذْ يعيش المتكلم العربي وضعاً لغوياً منقسماً بين لغة معيارية تستعمل في التعليم والكتابة ولغة يومية للتخاطب؛ وتفضي هذه الازدواجية إلى حضور الفصحى بوصفها نموذجاً رمزياً أكثر منها أداة تواصل حي، الأمر الذي يحد من ممارستها الفعلية ويبقي اللحن قائماً في الاستعمال الشفهي، خاصة في الخطابات المرتجلة، والعرب ترى أن اللحن يذهب بهيبة المتكلم مهما علا مقامه، إذْ روي أن سعيد بن مسلم قال: "دخلت على الرشيد فبهرني وملأ قلبي، فلما لحن خف علي أمره".
ويزداد هذا الوضع تعقيداً بفعل قصور طرق تعليم العربية، حيث تُقدم اللغة في كثير من الأحيان في صورة قواعد مجردة، منفصلة عن سياقات الاستعمال الحقيقي؛ فيحصل المتعلم على معرفة وصفية بالنحو والصرف، دون أن يكتسب القدرة على توظيف هذه المعرفة في الأداء الشفهي والكتابي السليم، فتتسع الفجوة بين المعرفة اللغوية والممارسة اللغوية، ويغدو اللحن عادة لا عارضا، وهو ما يفسر شيوع التساهل معه، رغم ما فيه من إخلال بالبيان.
وحين ننتقل إلى التعليق الرياضي، تتكثف هذه العوامل جميعاً في خطاب واحد سريع الإيقاع، واسع الانتشار، مرتجل في الغالب؛ فالتعليق يصبح فضاء تتجلى فيه مظاهر اللحن والتدرج بين الفصحى والعامية وتفصيح الدارجة وهيمنة الصوت على المعنى، حتى يغدو فساد اللسان جزءاً من المشهد السمعي اليومي، لا يثير تنبيها ولا استغرابا، وهذا بعيد عن حرص الأوائل الذين كانوا يعدون سماعه أشد وقعا من الخَطَلِ في غيره، حتى أثر عن أحدهم القول: "لأن يلقمني رجل حجراً أحب إلي من أن يُسمعني لحناً".
المحور الثالث:
آفات التعليق الرياضي وآفاق الارتقاء بالأداء اللغوي
تفضي مقاربة التعليق الرياضي، في ضوء ما تقدم، إلى الوقوف على جملة من الاختلالات اللغوية التي لا يمكن اختزالها في أخطاء فردية أو في ضعف كفاءة بعض المعلقين، بل ينبغي فهمها بوصفها تعبيراً عن وضع لغوي عام، تتقاطع فيه إكراهات الإعلام وحدود التكوين وطبيعة الاستعمال اللغوي في المجال العمومي؛ فالآفة هنا لا تكمن في وقوع الخطإ في ذاته، بقدر ما تكمن في تحوله إلى ممارسة مألوفة، والحال أن أهل البيان يجعلون سلامة القول شرطاً أولياً في كل خطاب مؤثر.
ومن أبرز الآفات شيوع اللحن في مستوياته المختلفة، سواء تعلق الأمر بالإعراب أو بالتركيب أو بالدلالة، وهو لحن يتكرس بفعل التكرار والانتشار، فيتحول إلى نمط سمعي مألوف يضعف حس الانتباه؛ وقد نبه الجاحظ إلى حقيقة هذا الانزلاق حين نبه في البيان والتبيين إلى إن: "اللحن في العربية عدول عن الصواب، ويسميه الأعراب نحواً، لأن صاحبه ينحو الصواب"، في إشارة دقيقة إلى أن الخطأ اللغوي ليس فقداناً للمعنى فحسب، بل انحراف عن صواب لسان الأمة.
ويتجلى هذا اللحن في التعليق الرياضي –مناط القول- في صور متكررة، من قبيل الخلل في الإعراب واضطراب المطابقة وسوء توظيف البنية النحوية، كما في قول بعض المعلقين: «لكن الهدف كان ملغي» والصواب الهدف يُلغى، أو «ولا زالت خطيرة» والصواب ما زالت خطيرة، أو «هو نفسِ المرمى» والصواب نفسُ المرمى، مثلما يظهر في تراكيب من قبيل "إني أرى أسودٌ قادمة" بدل أسودًا و"إلياس يبقي السوريون هنا" بدل السوريين، وهي أخطاء لا تمس الزينة اللفظية فحسب، بل تخل ببنية الجملة العربية ومعناها.
ويضاف إلى ذلك ما يمكن وصفه بالتدرج اللغوي داخل الجملة الواحدة، حيث يبدأ الخطاب فصيحاً ثم ينزلق إلى العامية أو يطعم بتراكيب دارجة مفصحة، في غياب وعي بنسق الجملة العربية ومتطلبات انسجامها الداخلي؛ ويقترن بهذا الانزلاق شيوع أنماط من القول المبتذل أو المنفلت، حيث تقدم الإثارة اللفظية على البيان ويستباح أبشع اللحن وهو عند أهل اللسان من باب الرفث وفحش الكلام، ولذلك عدوا تهذيب العبارة جزءاً من تهذيب المتكلم نفسه.
ومن مظاهر هذا الاضطراب أيضاً، أخطاء تتصل بالحركات الإعرابية في السياق الآني للتعليق، كما في قولهم: "مرة أخرى أمامِ الشباك" والصواب أمامَ، أو "سهلة الكرةِ الماضية" والصواب الكرةُ وتركيبا "الكرة الماضية سهلة" إذا ما أجيزت العبارة، أو "فَعل كلُّ شيء" والصواب كلَّ، أو "يعيدها مرةٌ أخرى" والصواب مرةً، أو "أعود حيث هناك ميناءِ الدوحة القديم" والصواب ميناءُ؛ وهي نماذج تدل على غياب التمكن من الإعراب في سياق الأداء الشفهي السريع.
كما تساهم السرعة التي يفرضها الإيقاع الرياضي في تكريس هذا الاضطراب، إذْ يقدم الصوت والانفعال على المعنى والدقة، فتغدو الإثارة هدفا في ذاتها، ويهمش البعد البياني للغة، فيتحول التعليق من فعل إبلاغ إلى مجرد تفريغ انفعالي؛ وفي هذا السياق، تتراجع وظيفة التأديب الذاتي للسان، مع أن من آداب القول عندهم أن "يُؤدب المرء لسانَه، ويُهذب ألفاظَه، ويتجنب خطلَ القولِ وشنيعَ الكلامِ"، لأن اللسان، في الخطاب العمومي، ليس ملكاً لصاحبه وحده، بل هو أمانة تؤدى إلى مسامع الجماعة.
بيد أن تشخيص هذه الآفات لا يكتمل ما لم يُستتبع بأفق عملي للمعالجة؛ فالارتقاء بالتعليق الرياضي يقتضي، في المقام الأول، إعادة الاعتبار للتكوين اللغوي ضمن مسار إعداد المعلقين، بحيث لا يقتصر هذا التكوين على الجوانب الصوتية والتقنية، بل يشمل الكفاية اللغوية والتعبيرية والقدرة على توظيف الفصحى توظيفاً طبيعياً غير متكلف؛ كما يستدعي الأمر ترسيخ وعي مهني ينطلق من أن الفصاحة ليست تكلفاً ولا ترفاً، وأن سلامة اللسان ليست عائقاً أمام التواصل، بل هي شرط من شروط نجاعته وتأثيره.
ويضاف إلى ذلك ضرورة وعي المؤسسات الإعلامية بمسؤوليتها في ضبط الخطاب اللغوي، بوصفه جزءاً من دورها الثقافي، لا مجرد عنصر ثانوي في صناعة الفرجة؛ فالإعلام، حين يتسامح مع اللحن وخطل القول، لا يكتفي بعكس واقع لغوي مختل، بل يسهم في إعادة إنتاجه وتطبيعه؛ وعليه، فإن الرقي بالتعليق الرياضي لا ينفصل عن رهان أوسع، هو رهان الارتقاء بالذوق اللغوي العام، وجعل الفصحى أداة حضور حي في الفضاء العمومي، ولها من المقومات ما هو كفيل بأن تتبوأ مكانتها المثلى في ذلكم المقام.
خاتمة:
يبرز النظر في التعليق الرياضي أن الإشكال اللغوي المطروح لا ينحصر في أخطاء عرضية، أو في تفاوت مستويات الأداء الفردي، بل يرتبط ببنية أعمق تحكم علاقة اللغة العربية بالفضاء الإعلامي المعاصر؛ فالتعليق الرياضي، بما له من حضور جماهيري واسع، يكشف عن حدود انتقال الفصحى من مجالها المعياري إلى مجال التداول الحي، ويعكس في الآن نفسه اختلالات متراكمة في سبل الاكتساب والاستعمال.
ويبدي هذا القول أن اللحن وفساد اللسان، ليسا نتاج ضعف في اللغة ذاتها؛ وإنما لغياب شروط الممارسة السليمة لها داخل المجال العمومي؛ فحين تُهمش الفصحى في الاستعمال اليومي، وتختزل في وظيفة رمزية أو مدرسية، يصبح حضورها في الخطاب الإعلامي هشاً ومتذبذباً، لتغدو عرضة للانزلاق والخلط والتفكك.
غير أن الرهان الأساس لا يكمن في الدفاع المجرد عن الفصحى، ولا في الدعوة الخطابية إلى الالتزام بها، بقدر ما يكمن في توفير الشروط الثقافية والمؤسساتية التي تمكنها من أداء وظيفتها التواصلية بصورة طبيعية وفعالة؛ ويطفو الإعلام الرياضي، في هذا السياق، بوصفه مجالا قابلا للتطوير لا لأنه سبب الأزمة، بل لأنه من بين أكثر تجلياتها وضوحاً وأبلغها تأثيراً في الذوق العام.
ومن هذا المنظور، تغدو الفصاحة وسلامة اللغة ضرباً من ضروب إكرام المخاطب، فالمعلق وهو يخاطب جمهوراً واسعاً من المستمعين والمشاهدين، إنما يستقبل ضيوفاً في فضاء السمع والوجدان، ومن حق الضيف حسن الوفادة والرفادة، وقديماً قيل: "أكرمْ نَجيكَ هذا فإنه كريمٌ يستوجب غاية الإكرام" كما ورد في مقامات الزمخشري، فمن أبسط حقوق المستمع على المعلق، والحال هذه، أن يُستقبل بحسن المنطق وسلامة اللسان وما يقتضيه من فصاحة وبيان.
وفي أفق المواعيد الرياضية الكبرى المقبلة، تبرز الحاجة إلى مقاربة واعية للتعليق الرياضي، تنظر إليه بوصفه ممارسة لغوية مسؤولة وجزءاً من السياسات الثقافية التي تصوغ الذوق العام؛ فالرقي بالتعليق ليس مسألة تقنية فحسب، بل هو خيار ثقافي، يعبر عن موقع اللغة العربية في المجال العمومي، ومدى قدرتها على مواكبة التحولات دون أن تفقد تماسكها أو وظيفتها البيانية.
وعلى سبيل الطرفة، "قصد الحجاجَ رجلٌ فأنشده:
أبا هاشمٍ ببابكْ .. قَدْ شم ريح كبابكْ
فقال ويحك لم نصبت أبا هاشم؟ فقال الكنية كنيتي إن شئت رفعتها وإن شئت نصبتها"؛ فعسى ألا يعترض معلق بالقول: "هذه قناتي إن شئتُ لحنت وإن شئت أَبَنْت".
مصادر ومراجع:
- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين. ت، عبد السلام هارون، مكتبة ابن سينا، ط 1، 2010.
- أبو حيان التوحيدي، البصائر والذخائر. ت، وداد القاضي، دار صادر – بيروت، الطبعة الأولى، 1988.
- ابن حمدون، التذكرة الحمدونية. تحقيق إحسان وبكر عباس، دار صادر، بيروت، ط 1، 1996.
- ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ت، أحمد الحوفي - بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، 1973.
- أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، المقتضب. ت، محمد عبد الخالق عضيمة، منشورات وزارة الأوقاف، مطابع الأهرام، مصر، 1979.
- أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، مقامات الزمخشري. دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1982.
- د. عبد العزيز شرف، العربية لغة الإعلام. دار الرفاعي، الرياض، 1983.
- محمد الأمين بن محمد المختار، الخط الأحمر: مقدمات في التدقيق اللغوي. ضمن سلسلة كتاب الرافد، عدد 022، الشارقة، أكتوبر 2011.
- د. محمد حمزة الجابري، اللغة الإعلامية: المفهوم والخصائص- الواقع والتحديات. دار كنوز المعرفة، عمان، 2013.
- د، هيام فهمي إبراهيم، أبحاث في لغة الإعلام. دار الفراهيدي، بغداد، 2012.