
كثُر من ينعون البلاغة، ويقيمون لها سرادقات العزاء. فلا يكاد ينقضي عام حتى نقرأ أو نسمع سرديات "موت البلاغة"، و"اندثارها". تتكون كتيبة نائحي البلاغة من خليط من المنذِرين، والوائدين. يخشى المنذرون على البلاغة من علامات قرب الأجل، وحتم المصير. أما الوائدون، فيحفرون -لأسباب شتى- قبرها، على أمل أن يواروها حيّة في قبر التاريخ. فريق يبكي البلاغة بوصفها علماً؛ بأن ينفي عنها مبرر وجودها وضرورتها. وفريق ينعى البلاغة بوصفها نصوصاً وكلاماً؛ متحسراً على انتهاء زمن الكلام البليغ.
بهذه الافتتاحية المُتذرِّعة بمُعطيات البلاغة السردية -التي لا مكان فيها للتكلّس العاطفي أو الاستطراد الشعوري- يستهل عماد عبد اللطيف كتابه "البلاغة العربية الجديدة.. مسارات ومُقاربات"، ويبدو عبد اللطيف معنيًا منذ عتبة كتابه بتوريط المتلقي في الفهم، من خلال استثمار قابلية البنية التشفيرية والإيحائية لافتتاحيته لتفجير طاقات المُراجعات في ذهنية المتلقي، وهي خطوة ضرورية لتهيئة أفق المتلقي للتعاطي بانفتاح وحافزية مع مفهوم البلاغة الجديدة كما يتغيّا العمل.
وإذا كان إدراك المُفارقة لا يتم سوى بإدراك التعارضات؛ فإن القيمة الوظيفية لمفارقة الحديث عن التجديد (تجديد البلاغة) عبر هذا المفتتح الجنائزي (عن موت البلاغة)، يحول الافتتاحية إلى تعويذة إقناعية تنفي أسطورة موت البلاغة، وتثبت أن تابوتها فارغ بلا جسد، وتقوّض حجج الداعين إلى موتها عبر مسار زمني طويل يبدأ بأفلاطون ويمر بجين ستون، وبصمويل يسلنج وبول ريكور، وتيري إيجلتون.
تخضع الحجج لعملية بسترة تحليلية لا تكثّف حضورها أمام عين المتلقي فحسب؛ وإنما تيسِّر عملية تفنيدها أيضاً، ليجد المتلقي نفسه في نهاية هذه الممارسة التفنيدية مدفوعًا إلى الهتاف أن البلاغة حيةٌ –وفقًا لتعبير الكاتب- تراها وأنت تسير في الطرقات، في شكل لافتات إعلانية ملتصقة بحائط قديم، أو رموز وأيقونات دعائية مشدودة بين عمودي إنارة الطريق، أو أصوات وعظ تتدفق من مكبرات صوت مسجد صغير. فإن أدركك التعب ووقفتَ لتستريح، ستستمع إليها في شكل جدال بين بائع متجول ومشتر مساوم، أو حوار بين عابر طريق ومتسول لحوح، أو محادثة بين شاب مغوٍ وفتاة بريئة. فإن عُدتَ إلى بيتك ستجد البلاغة تنتظرك في شكل سرديات أفراد الأسرة عن يومهم الطويل، أو تقنيات حجاج معقدة تستعملها أم تقنع طفلها بإنهاء طعامه، أو أنواع استمالة بارعة يستعملها الأبناء لحمل والديهم على تلبية ما يريدون. حتى في نومك، ستتوالى الصور على مخيلتك لتصنع توجهك نحو يومك التالي، ونحو الآخرين. باختصار، حيثما وجد بشر يتواصلون، يمكنك رؤية البلاغة حيّة بينهم، كلامًا، وعلمًا.
البلاغة تتجدد. تلك حقيقة ساطعة. ربما كان الفشل في إدراكها سببًا للحكم على البلاغة بالموت. فالجديد يُخفي القديم، ويوهم بأنه لم يعد حيًّا. لكن نظرةً ثاقبةً تكشف أن القديم حيٌّ في جديده، لا ينفصلان. ينطلق الكتاب من هذه المسلمة، بهدف استكشاف مسارات وآفاق ومقاربات متنوعة لتجديد البلاغة، تُسهم في الوصول إلى بلاغة جديدة.
البلاغة الجديدة.. المألوفية المتوهَّمة.. وإعادة الإدهاش
دُمِغ مصطلح "البلاغة الجديدة" في سياقنا العربي بمألوفية تداولية عبّدت الطريق لإنشاء عراقيل استقبالية متوهمة بينه والمتلقي، وقد يكون السبب وراء ذلك أمرين؛ أولهما السيولة التوظيفية التي حولت المصطلح إلى مطية مجانية لقول كل شيء وأي شيء عن البلاغة وإن تجرّد من الجدة، وثانيهما تضيق أفق الممارسة الإجرائية لهذاالجهاز المفهومي وحصره في دراسات الحجاج بتأثير عمل بيرلمان، الذي يعترف عبد اللطيف بالدور المحوري الذي أداه في إثراء أحد موضوعات البحث البلاغي لكنه يلح –في الآن ذاته- على أن البلاغة الجديدة لا تقتصر على دراسة الحجاج وحده، وهو أمر يبدو تأكيده بالغ الأهمية حتى يزول الوهم الذي يؤدي إلى الخلط بين اسم كتاب بعينه، يهدف إلى تطوير موضوع بعينه من موضوعات البلاغة، وبين تغيرات جذرية شملت كل ما يمكن أن يكون بلاغيًا، سواء أكان مادة بلاغية أم علمًا يدرسها.
لقد أسهمت العقود الأخيرة في إنشاء بلاغات جديدة، تتسم بخصائص مختلفة. فقد أدت وسائل التواصل العمومية الافتراضية إلى ظهور بلاغات هجينة، تجمع علامات متنوعةً في حدث تواصلي واحد مثل اللون والصورة والحركة والكلمة والرمز، وتدشين صيغ جديدة للعلاقة بين أطراف الموقف البلاغي، يحظى الجمهور فيها بقدرات غير تقليدية، وابتكار أنواع بلاغية فرضتها تقنيات جديدة، مثل التغريدات والمنشورات والتعليقات وشرائط الأخبار وغيرها. ومن هذه الزاوية فإن البلاغة الجديدة تعبير يصف أنواعًا، وخطابات، وخصائص، وسياقات بلاغيةً معاصرةً متنوعة.
من ناحية أخرى، يُستعمل تعبير البلاغة الجديدة وصفًا لمنجز معرفي هائل، يمتد عبر عقود طويلة، أسهم في إنجازه مئات الباحثين متنوعي المشارب والثقافات؛ إذ يوصف بالبلاغة الجديدة حشد كبير من التوجهات البلاغية، أصبح يُشكل حقولًا معرفية فرعيّة في إطار علم البلاغة؛ مثل البلاغة المقارنة، والبلاغة الرقمية، والبلاغة الإدراكية، وبلاغة المرئي، والبلاغة الفاحصة، والبلاغة عبر الثقافات، والبلاغة النقدية، وبلاغة الجمهور، وغيرها.
يتكئ هذا الكتاب على أرضية الثراء الدلالي لتعبير البلاغة الجديدة، منطلقًا من هدف محدد هو تقديم إجابة تفصيلية عن سؤال: كيف يمكن الوصول إلى بلاغة عربية جديدة؟ يطوف الكتاب، عبر ثمانية عشر فصلًا، في أرجاء البلاغات القديمة والحديثة والمعاصرة بهدف استكشاف مسارات، وابتكار توجهات، واقتراح رؤى وأفكار تُسهم في تجديد بلاغتنا العربية.
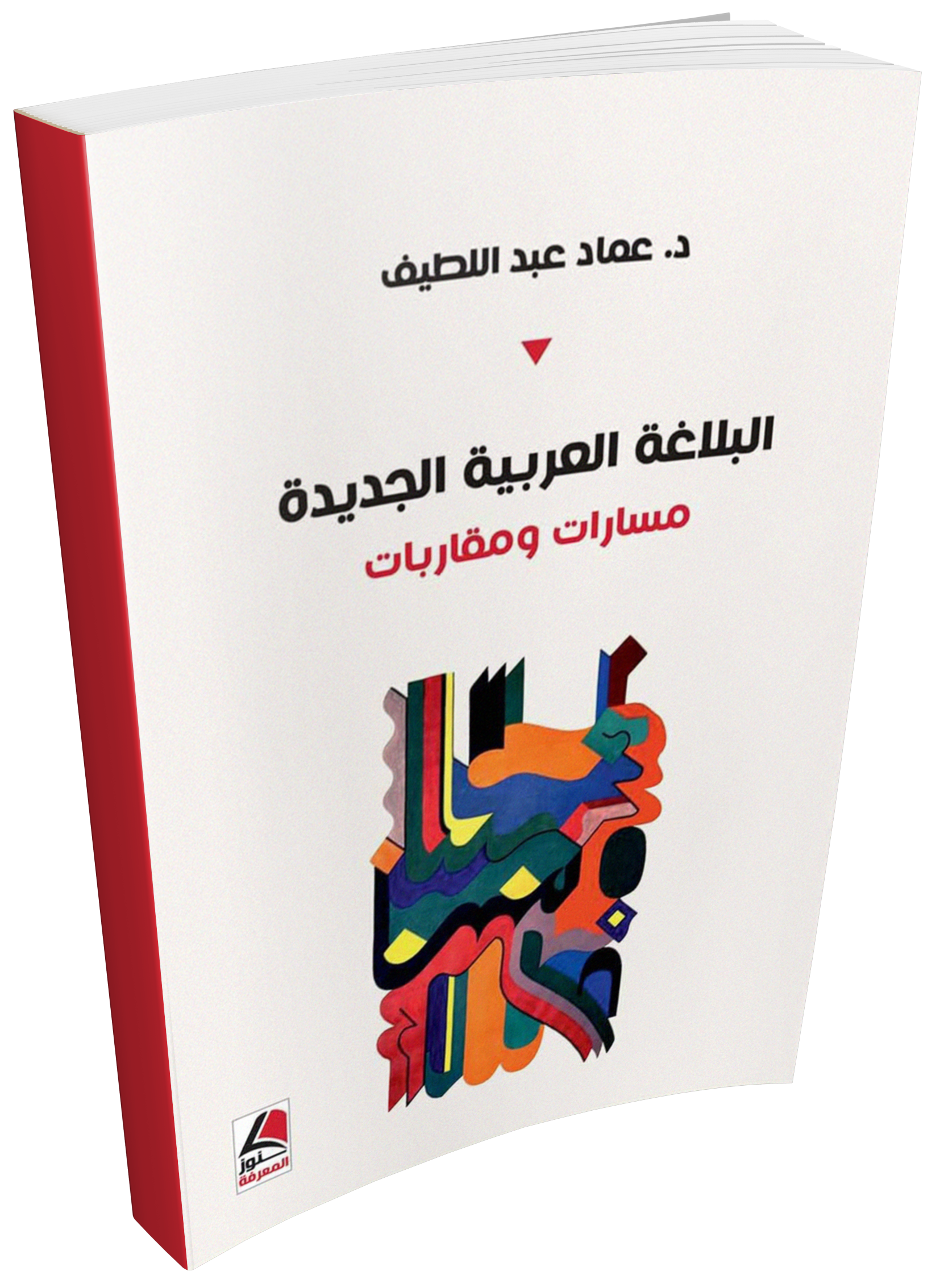
إرث البلاغة الجديدة ومسارات البلاغات المعاصرة
ينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام ترتبط كلها بالسؤال المحوري (كيف يمكن الوصول إلى بلاغة عربية جديدة)؟ تتحرك الأقسام الأربعة زمنيًا من الماضي إلى المستقبل على مستوى الموضوعات المدروسة. فالقسم الأول يستكشف مقاربات غير تقليدية للنظر إلى بلاغات الماضي القديم والقريب؛ بهدف تأسيس مسارات جديدة للدرس البلاغي العربي. ويواصل القسم الثاني المهمة نفسها مقدمًا فحصًا شاملًا للمقاربات والمنهجيات البلاغية الممتدة عبر سبعة عقود منذ النصف الثاني للقرن العشرين؛ بهدف رسم خريطة نقدية لمسارات الدرس البلاغي الراهن، وتقديم مقترحات لتطويره، وتطوير تدريسه. أما القسم الثالث فقد خُصص لتقديم توجه بلاغي، لا يزيد عمره عن عقد ونصف من الزمان، يُمثل أحد مسارات التجديد البلاغي الممكنة.
هذه الحركة الأفقية من الماضي إلى المستقبل على مستوى الموضوعات والتوجهات البلاغية تقابلها حالة امتزاج دائم بين الماضي والحاضر والمستقبل في كل صفحة من صفحات هذا الكتاب. فالكتاب يوفر خارطة طريق لاستكشاف ما يمكن للبلاغة العربية الجديدة أن تكونه. وحين يُعرج على بلاغات الماضي أو الحاضر؛ فإن الوصول إلى بلاغة المستقبل يظل هدفه الرئيس.
يُجيب القسم الأول -المعنون بـتجديد التراث البلاغي وإرث البلاغة الجديدة"- عن سؤالين محددين يتفرعان عن السؤال المحوري؛ هما كيف يمكن للتراث البلاغي أن يكون رافدًا من روافد تجديد البلاغة العربية؟ وما العمليات المعرفيّة التي يجب إجراؤها لتحقيق هذا الهدف؟ يحوي القسم الأول ستة فصول. هي "نقد تاريخ البلاغة: البلاغات الملوَّنة وتفنيد مركزية البلاغة الغربية"، و"نقد مركزية بلاغة أرسطو: أفلاطون عربيًّا"، و"نحو مقاربة نقدية للبلاغة: استثمار إرث العداء الأفلاطوني"، و"كيف نُجدِّد التراث البلاغي؟ مفهوم أركان البلاغة مثالًا"، و"بواكير البلاغة العربيّة الجديدة: إسهامات ما قبل منتصف القرن العشرين"، و"بلاغة (كانت) جديدة: كيف تنبتُ مشاريع تجديد البلاغة"؟
يتكون القسم الثاني من أربعة فصول، تقدم إطلالة على البلاغات المعاصرة بهدف استثمارها في تأسيس بلاغة للمستقبل. يهدف الفصل السابع إلى الإجابة عن سؤالين هما: ما أهم البلاغات المعاصرة عربيًا وغربيًا؟ وكيف نفيد منها، ونطورها؟ ويقدم الفصل الثامن -إطلالة خاصة على البلاغة النقدية- معالجةً تفصيليةً لبلاغةٍ غربيةٍ معاصرة، بوصفها نموذجًا لمشاريع تجديد البلاغة الغربية في وقتنا الراهن، ويحمل الفصل التاسع عنوان "البلاغات العربية المعاصرة: إطلالة عامة"، ويفحص أبرز مقاربات البلاغة العربية المعاصرة ومساراتها، ويهدف إلى رسم خريطة للاهتمامات البلاغية العربية الراهنة، وتحديد المشكلات التي تنطوي عليها، واقتراح سبل لتجاوز بعضٍ منها.
ويحمل الفصل العاشر عنوان "البلاغات العربية: إطلالة خاصة على مشروع البلاغة العامة"، ويقدم معالجةً تفصيلية لمشروع بلاغي عربي معاصر، بوصفه نموذجًا لمشاريع تجديد البلاغة العربية في وقتنا الراهن، هو مشروع البلاغة العامة عند محمد العُمري. أما الفصل الحادي عشر المعنون بـ"كيف نُدرِّس البلاغة الجديدة؟" فيعالج واقع تدريس علم البلاغة في العالم العربي قديمًا وحديثًا، ويسعى إلى اقتراح مقاربة جديدة تسد الفجوة القائمة بين تطور البحث البلاغي من جهة، وجمود طرق تدريسها في المقابل.
بلاغة الجمهور: النظرية والممارسة
بعد وقفة متأنية أمام مقاربَتي البلاغة النقدية والبلاغة العامة، ينتقل الكتاب إلى القسم الثالث المخصّص لارتياد أحد آفاق تجديد البلاغة العربية المعاصرة، هو بلاغة الجمهور الذي يحتل حوالي 40% من مساحة الكتاب، ويتكون هذا القسم من ثمانية فصول تجمع بين النظرية والتطبيق.
يعكس هذا التضخم الكمي القيمة المعرفية والاعتبارية والإنجازية لبلاغة الجمهور لدى مُؤسِّسَها –عماد عبد اللطيف- بكل ما أثارته من جدالات حول أُسسها المعرفية وأجهزتها المفاهيمية، وأدواتها التطبيقية وتداخلها مع حقول معرفية أخرى، وجدارتها بالانتماء المستقل ل/عن البلاغة، ويبدو عبد اللطيف معنيًا بالرد على كل هذه الجدالات، وإعادة موضعة التحديات في دائرة الممكن بتفكيك هياكلها التصورية عبر ممارسات تنظيرية وتطبيقية تطال انتقادات مثل مدى رسوخ الأسس النظرية للمشروع، وحدود هويته وتشكلها حتى الآن، والتنازع المعرفي بينه والدراسات الثقافية والإعلامية وعلم نفس الجماهير...
في الفصل الثاني عشر المعنون بـ"بلاغة المخاطَب: التأسيس"، يقدم عبد اللطيف جذور نشأة بلاغة الجمهور، محتفظًا بالتسمية الأولى لهذا التوجه المعرفي في نشرته الصادرة قبل عام 2005 تحت عنوان "بلاغة المخاطَب". فيعرض الفصل سياق نشأة بلاغة المخاطَب، وأهميتها، ووظيفتها، وأسئلتها البحثية، وعلاقاتها المعرفية.
ويحمل الفصل الثالث عشر عنوان "بلاغة الجمهور: الهوية والإسهام"، ويرصد واقع دراسات بلاغة الجمهور بعد ما يزيد على عقد من تدشينها، وبعد أن انتقلتَ من دعوى فردية إلى مشروع يعمل فيه عدد من الباحثين العرب من خلفيات ثقافية ومعرفية متباينة. يناقش الفصل الهويّة المعرفيّة لبلاغة الجمهور، ويقدم مناقشة تفصيلية للنقد الذي وجِّه أو يمكن أن يوجّه إليها، ويقدم مقترحات لسد بعض الفجوات التي تحتاج إلى تجسير.
يسعى الفصل الرابع عشر -منهجيات دراسة الجمهور: نقاط التلاقي والافتراق- إلى الإجابة عن أسئلة تتصل بحدود العلاقة بين بلاغة الجمهور، والحقول المعرفية وثيقة الصلة بدراسة الجمهور في الخريطة المعرفية المعاصرة؛ بهدف تحديد ملامح التمايز والاستقلال من ناحية، واستكشاف الروابط والعلاقات من ناحية أخرى. فيستكشف الفصل مناطق التقاطع والتمايز بين بلاغة الجمهور وثلاث منهجيات هي نظريات القراءة والتلقي ونقد استجابة القارئ، ودراسات البلاغة الكلاسيكية والمعاصرة، ودراسات التواصل الجماهيري.
يستكشف الفصل الخامس عشر خصوصيات بلاغة الجمهور، مركزًا على هوية النقد الذي تمارسه، مقارنة بحقول معرفية نقدية راسخة مثل التحليل الناقد للخطاب، والعلوم النقدية. يهدف الفصل إلى بلورة تصور للنقد يربطه بفعل الاستجابة البليغة تحديدًا، ويعزز من إدراك النقد بوصفه فضيلة.
أما الفصل السادس عشر فيُقدم مقترحًا لحقل بحثي فرعي يُعنى بدراسة بلاغة الجمهور في الأدب، يُعنى بدراسة الاستجابات التي يُنتجها الجمهور المتخيل في الخطاب الأدبي السردي بأنواعه المختلفة مثل القصة والرواية والمسرحية والملحمة والسيرة الشعبية وغيرها.
يفحص الفصل السابع عشر -بلاغة جمهور الخطاب السياسي: حالة الربيع العربي- خصوصيات بلاغة الربيع العربي، والتحديات التي تواجهها بلاغة الجمهور في دراستها، ويواصل ترسيخ مشروعية بلاغة الجمهور بوصفها توجهًا بلاغيًا، من خلال تفنيد الانتقادات التي توجه إلى جدارة استجابات الجماهير العادية بالدراسة الأكاديمية.
تقدم الفصول الثلاثة التالية ممارسات تحليلية لبلاغة الجمهور. يتناول الفصل الثامن عشر - المعنون ببلاغة جمهور كرة القدم: حالة أناشيد الملاعب- خطابًا شعبيًا واسع الانتشار هو أناشيد الملاعب، ويحلل نشيدًا ذائع الصيت هو "في بلادي ظلموني"، مستكشفًا كيفية إنتاج الجماهير خطابها المقاوم للسلطة عبر استراتيجيات خطابية متنوعة. ولأن هذا الفصل قُصد منه أن يكون مقدمة لدراسة بلاغة جمهور كرة القدم فقد افتُتح بمقدمة نظرية مطولة تُعد مدخلًا لتحليلها.
يدرس الفصل التاسع عشر –المعنون ببلاغة جمهور اليوتيوب: الحجاج والبذاءة- ظاهرة بارزة في التواصل الكتابي في الفضاءات الافتراضية الراهنة هي ظاهرة البذاءة. فيُقدِّم مقاربةً بلاغيةً تداولية للغة البذيئة المتضمَّنة في استجابات الجمهور على اليوتيوب، بهدف دراسة العوامل المؤثرة في إنتاجها، والآثار التي تُحدثها. أما الفصل العشرون -بلاغة جمهور الفيسبوك: من المقايضة إلى الاستجابة البليغة- فيدرس أنشطة الأكاديميين على الفيسبوك، ويضع يده على تجليات "مفارقة باحثي الفيسبوك"، التي تشير إلى احتمال وجود علاقة عكسية بين درجة انخراط الأفراد في وسائل التواصل الاجتماعي، وجودة البحوث العلمية التي يقدمونها، ويقدم مقترحًا لحل هذه المفارقة عن طريق مقاومة قانون تبادل الإعجاب، وإحلال مبدأ الاستجابة البليغة محله.
وفي النهاية؛ يبقى أن نؤكد أن التشابك القرائي مع كتاب "البلاغة العربية الجديدة.. مسارات ومُقاربات"، وما قد يوّلده من اختلافات وتعارضات مع بعض ما ورد فيه لا يمكن أن يقلل من رصانة العمل وأصالته، ولا يمكن أن يتجاهل الجهد الكبير الذي قد بُذل لهيكلته على هذا النحو المُحكم، ولا يمكن أن يغض الطرف عما يعكسه من وعي عميق بأهمية تجديد البلاغة واستشرافها لآفاق مستقبلية تخدم أهدافها النبيلة كما يراها مؤلفه، الذي يعبر عن رؤاه بطريقة ناعمة، وعبر لغة مُهادِنة تضمر تبديدًا لشبه يقينيات، وتقوّض التمركز حول مواضعات طالما اكتسب رسوخها من سلطة الألفة والاعتياد.