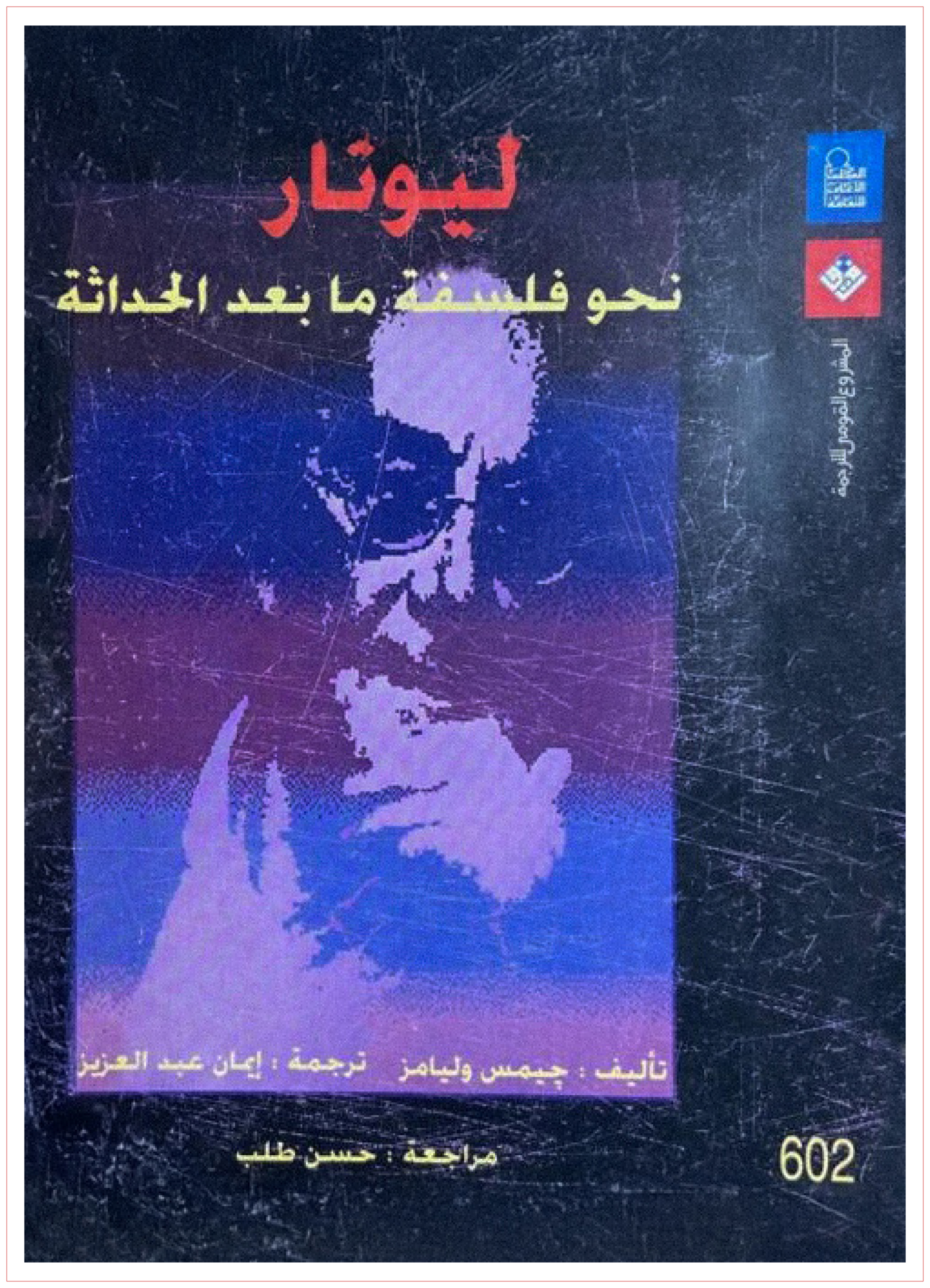
يعتبر كتاب "ليوتار نحو فلسفة ما بعد الحداثة" لصاحبه جيمس ويليامز James Williams من أهم الكتب التي رامت التعريف بأعمال الفيلسوف الفرنسي جان فرنسوا ليوتار Jean-François Lyotard، وقد صدر هذا الكتاب سنة 1998 باللغة الإنجليزية، وترجم سنة 2003 إلى اللغة العربية، موزعاً إلى سبعة فصول تكشف عن معالم فلسفة ليوتار المادية، وعن الوضع ما بعد الحداثي للمجتمع الذي يحكمه ما يسميه بالاقتصاد الليبيدي، كما تكشف عن منهج البحث عند ليوتار وفلسفته السياسية، فضلا عن مناقشته الرفيعة لهيغل وليفيناس وماركس، وأوجه الاتصال بين فلسفته وفلسفة كل من دولوز، جوتاري، هابرماس ودريدا.
يؤكد الكتاب على الأهمية البالغة لفلسفة ليوتار لفهم ودراسة مشكلات النصف الثاني من القرن العشرين وما بعده، فهي فلسفة تعيد التفكير فيما هو سياسي على نحو مغاير، عبر التركيز على علاقة التفتت الاجتماعي Fragmentation social المرتبطة بالتشابك العالمي للأسواق والتطورات التي عرفتها تقنيات الإعلام والاتصال. فقد سعى ليوتار إلى تثبيت الاختلاف عبر مدخل الإبداع والخبرة الجمالية، من حيث كونهما طاقة تطمئن الأفراد وتجعلهم ينسجمون روحياً مع الأشكال الجديدة للمجتمعات، كما حاول تجاوز الحضور المهمين لما هو سياسي في الوضع الما بعد حداثي، متجهاً صوب حضور أدبي وفني قادر على أن يخلق نوعاً من التوازن داخل هذا الإنسان الذي ينظر إليه سياسياً واقتصادياً كمستهلِك أو مستهلَك إذا ما شئنا التدقيق أكثر.
لكي يتسنى لليوتار تحقيق هذا المبتغى وجد نفسه ملزماً بالانتصار للاختلاف ردا على التوفيق أو التلفيق الذي يجد جذوره في قيم الفلسفة الحديثة، وقد سعى ليوتار إلى تحقيق هذا المبتغى من خلال فتحه لجبهات فلسفية ومعرفية متنوعة، يمكن تقريبها من خلال عناوين كتاباته الأكثر شهرة، ومنها: "حرب الجزائريين La guerre Des Algériens" الذي ترجم إلى الإنجليزية تحت عنوان "الكتابات السياسية Political Writings"، وهو كتاب يرصد علاقة ليوتار بالماركسية وتطوراتها؛ ثم كتاب "الخطاب، الصورة Discours, Figure" الذي يشكل نقداً للفينومينولوجيا في ميدان الفن؛ ثم كتاب "الاقتصاد الليبيدي Economic Libidinal" الذي هو بمثابة مراجعة نقدية للفرويدية والماركسية بالانطلاق من مرتكزات "الرأسمالية والفصام" لكل من دولوز وجوتاري Deleuze et Guattari؛ وكذلك كتاب "الوضع ما بعد الحداثي La condition Postmoderne" الذي يجمع بين علم الجمال والنقد الاجتماعي والفلسفة التحليلية للغة؛ وصولا إلى كتاب "الخلاف Différend" الذي يقدم فيه إجابات عن إشكالات متعلقة بالعدالة والعمل السياسي؛ فضلًا عن إسهامات فكرية أخرى.
انتقد ليوتار الادعاء الحداثي الذي كان يرمي إلى نقل مجال الصدق من نطاق العلم إلى النطاق الاجتماعي؛ إذْ لا يوجد توافق بين هذه الميادين، فالاجتماعي ينفتح على شروط أخرى لا يراعيها نطاق العلم، وهو ما ينكشف بشكل جلي من خلال تمعن الاقتصاد والأعراف الاجتماعية والأخلاق.
تجاوز الخطابات الشمولية:
تشكل فلسفة ليوتار دعوة لتجاوز الخطابات الشمولية والسرديات الكبرى التي سيطرت على التفكير في الوضع السياسي، وهو الوضع الذي لا يكشف عن تجلياته المختلفة إلا لمن تورط فيه بالمعنى الفلسفي للكلمة. من ثمة تبرز فلسفة الاختلاف كضرورة لمواجهة التمثيل الذي صار مهيمنا على العالم. وتتوجه فلسفته إلى معالجة المشكلات الأساسية التي يطرحها مجتمع النصف الثاني من القرن العشرين، وليس المجتمع المثالي وليد التصورات الذهنية، وبهذا المعنى تكون فلسفته فلسفة مادية، فهي تنظر فيما هو كائن.
يتميز المجتمع الكائن من منظور ليوتار بكونه مجتمعاً ما بعد حداثي ممزق، تتكاثر فيه الغايات وليس له هدف مشرك واحد، مجتمع رأسمالي تغول فيه الاقتصاد الليبيدي، فصار يشتغل على الإحساس والرغبات، ووجد المنفذ لتحقيق هذه الغايات من خلال قوة البروباغندا التي تؤمنها تقنيات الإعلام والاتصال. ومن هذا المنطلق تسعى مادية ليوتار إلى إعادة التفكير في العمل السياسي الحداثي ومعاييره، وفي هذا الصدد ينتقد النظريات التي تجعل من العقل الفلسفي المجرد منطلقاً في معالجة قضايا المجتمع، فالممارسة هي النظرية الوحيدة الممكنة للقيام بهذا الفعل، فالميدان الفعلي هو محدد الفعل وليس الميدان المثالي. فالممكن وما هو خير والحقيقي مقولات فارغة لا معنى لها خارج حدود ما يسمح به الميدان ويمليه.
على هذا النحو يؤكد ليوتار أن بحث الفلسفة عن أسسها في مكان آخر، ثم عودتها إلى الميدان لكي تضفي المشروعية على استنتاجاتها، يقوم على تأويل خاطئ دوما لحقيقة الميدان، وتلك هي الخيانة العظمى التي تهدد الفلسفة من داخل الفلسفة. لذلك يدعونا ليوتار إلى مقاربة سؤال المنهج والأهداف مقاربة ميدانية، وهو ما يتطلب التسلح بأسئلة عملية شبيهة بتلك التي يطرحها قائد عسكري قبل أن يخوض معركة ما.
لم يكن مدخل ليوتار لمعالجة الوضع السياسي مدخلًا سياسياً صرفاً، بل سلك إلى ذلك عبر مداخل الفكر والثقافة والفن، حيث تميزت فلسفته بترسانة مفاهيمية متميزة، منها:
◅ حدود التمثيل Limits of representation: فقد انشغل بإشكالية وجود ما لا يمكن تمثيله، وكان مدخله إلى ذلك اللغة والفن، فالفكر حسبه محدود القدرة في تمثيل الإحساسات والمشاعر التي تصاحب تقديم الأشياء.
◅ الحدث Event: وهو مفهوم يعبر من خلاله ليوتار عن حدوث الشيء خارج نطاق قوة التمثيل؛ أي على ما لا نستطيع التفكير فيه بواسطة اللغة أو الفن حتى لو كان الفن نفسه حدثاً، فالأحداث هي الطريق إلى تواضع العقل والعقلانية.
◅ الاختلاف المطلق The Absolute Difference: فأن تحصل الأشياء كأحداث معناه عدم قدرة الفكر على المقارنة بينها، وبالتالي تنعدم القدرة على الترتيب والتبويب والتصنيف، وهذا هو التجسد الفعلي للاختلاف المطلق. إن الثقافات والأعمال الفنية وطرق الحياة والأشخاص والرغبات كلها أحداث.
◅ الطليعة The avant- garde : يأتي هذا المفهوم كرد فعل على الاعتراض النقدي الموجه لفلسفة ليوتار، معبراً عنه في سؤال: كيف يمكن أن نناقش ما لا يمكن مناقشته؟ أي ما يقع خارج نطاق التمثيل ويتجلى كحدث؟ ففي هذا السياق يستحضر صاحبنا ما يسميه بفن الطليعة كتعبير عن الفن الذي يسعى إلى تمثيل ما لا يمكن تمثيله، إنه نوع من الإحساس بالجليل Sublime.
تتخذ مهمة الفيلسوف حسب ليوتار بناء على ما سبق صبغة طليعية أو طلائعية قوامها إيجاد التركيبات اللغوية المستحيلة للتعبير عن صراعات مختلفة بشكل مطلق، تتجلى على شكل أحداث متكثرة دوما، علما أنه ليس هنالك معيار واحد للتوفيق بين العلم والأدب والفن، وفي هذا السياق يستعير مفهوم لعبة اللغة من لودفيج فديجنشتين Ludwig Wittgenstein، لكنه رغم ذلك لا يتنازل عن رفضه لوجود سرديات شارحة، إذ لا قواعد ولا معايير ولا قيم مشتركة بين الألعاب.
إن الوضع ما بعد الحداثي أشبه بمدينة مقسمة إلى أحياء لها قوانينها المختلفة التي تمنح لكل حي هويته، يظهر اختلافها في حالة وقوع جريمة على الحدود الفاصلة بين الأحياء؛ إذ الحكم طبقاً لقانون حي ما سيزعج الحي الآخر، فأن تكون المدينة ذات صبغة ما بعد حداثية؛ معناه ألا تجد طريقة لحل تلك الصراعات، وتلك حالة أشبه بحالة الإحساس بالجليل في الفن.
درس ليوتار القواعد التي تحكم تسلسل الأبنية اللغوية لتمرين الفكر على فهم منطق الحدوث الذي يحكم مجتمع ما بعد الحداثة، لذلك تحدث في كتابه "الخلاف" عن ربط العبارات، فعبارة "الباب مغلق" لا تفسر إلا بالتسلسل الحاصل في الأحداث، بحيث يمكن أن يكون الرد عليها "أعرف أنك تحاول حبسي"، أو "نعم، ما صنع الباب إلا لنتمكن من إغلاقه"، علما أن اللغة تتجاوز هذه الحدود إلى ما هو أخطر، فليوتار يقول: "أن تتكلم معناه أن تحارب، بمعنى اللعب، وتقع أفعال الكلام داخل ميدان صراع عام"، فاللغة مجموعة ألعاب، لكل لعبة قواعد استخدامها التي تحدد الاستخدام السليم للجملة، وتنشأ الصراعات عن انطلاق المتصارعين من لعب مختلفة، حيث تتصارع القواعد وتتعارض.
مثال ذلك التعارض الحاصل بين اللعبة الخاصة بالمعرفة العلمية، وتلك الخاصة بالمعرفة السردية أو الحكائية Narrative، فإن كانت قواعد الأولى تقبل بالدليل وصحة البرهان، والثانية تستعمل المبالغة والابتداع، وهذه التفسيرات تدخل في صراع حول مسائل لها اهتمام مشترك. من هذا المنطلق سينتقل ليوتار إلى التساؤل عن نوع التفسيرات التي يمكن اعتبارها عادلة، وهو بذلك يترجم اهتمامه السياسي إلى اهتمام لغوي، في أفق فعل ارتدادي حامل لشروط استيعاب منطق أو لا منطق حدوث الأحداث.
يبدي ليوتار في هذا السياق توجسه من العودة الخفية الممكنة للفعل الشمولي، لذلك نجده يعلن معارضته لما يسميه بالسرديات الشارحة؛ أي إمكانية الجمع بين كل قواعد التبرير في تبرير واحد شامل، مثل سردية تحرر الإنسان التي تعتقد في تبريرها لكل ثورة سياسية. لقد فقدت السرديات الماركسية التي طغت على الساحة السياسية لفترة طويلة قدرتها على تحديد مدى شرعية الأحداث الممكنة، والعلم نفسه صار كذلك، فهو يستحيل اليوم إلى مجرد لعبة لغوية تنضاف إلى قائمة الألعاب الأخرى.
لذلك يدافع ليوتار عن قانون يسميه قانون التسلسل ويعبر عنه بقوله "من المستحيل ألا تكون ثمة عبارة، ومن الضروري أن يكون هنالك عبارة"، فالربط فعل ضرورة وليس فعل إلزام، أما كيفية الربط فليست ضرورة. ليست هنالك طريقة صحيحة لتتابع العبارات، هنالك فقط حلقات متعلقة دوماً بلعبة من ألعاب اللغة قائمة على مبدأ المناسبة، العبارة نفسها حدث خارج نطاق التمثيل.
يقترن فعل الحدوث في صلته بالاقتصاد الليبيدي من حيث هو اقتصاد تتدفق فيه الموارد حول نظام ما، آخذة شكل طاقة تدور لتظهر في كثير من النظم الفرعية المختلفة التي تتميز بديمومة التغير. تأخذ الطاقة المتحدث عنها شكل أحاسيس ورغبات ليبيدية، يسميها ليوتار شحنات Intensites. هذه الشحنات المتحدث عنها تحدث في إطار ما يسميه ليوتار بالنطاق الليبيدي أو الغشاء الليبيدي، ويعرفه بكونه المكان الذي تقع فيه الأحاسيس والرغبات، إنه المكان الذي تقابل فيه الطاقة البنيات التي تستغلها.
يتجلى الحدث في السياق الليبيدي مخالفاً لما حدث من قبل، فهو ليس تكراراً، فالحدث يقع للجسد ويتغير الجسد بسبب هذا الحدوث، وما أن يحدث الحدث على الجسد أو يسجل في كلمات حتى يفقد بعض جوانبه، فالحدوث يخلق نطاقاً ثم أشكالًا Forms وتركيبات يمكن تمييزها، وهو ما يوضحه ليوتار في كتابه "الخطاب والشكل". ومن ثمة يصير الاقتصاد ليبيديا عندما ينشد ترويض الشعور، بحيث يقحم الجسد في منظومة تقع في شراكها الرغبات والأحاسيس، فتقود إلى ظهور رغبة ما على سطح الغشاء أو النطاق الليبيدي.
ليست فلسفة ليوتار فلسفة منغلقة على ذاتها، بل هي حوار مفتوح مع فلاسفة مختلفين، وقد قامت على أساس تأويلي جمع فيه بين كارل ماركس، سيغموند فرويد، إيمانويل كانط وفيدجنشتين. أما عن الخيط الناظم لفلسفته فهو إعادة التفكير في السياسي، من حيث كونه يتجاوز الأحزاب والمؤسسات إلى أشكال الفعل المرتبطة بالتغيير أو المقاومة له، فالفعل العادل ليس هو الفعل المصادق عليه عالمياً، بل هو الفعل المعترف بالفروق الجذرية بين الأفراد والثقافات والنظم، من ثمة يشكل الأدب والفن واللغة مدخلا جديداً للتفكير في الفعل السياسي.