رواية الحرّيق للقاص والروائي المصري إبراهيم المطولي، هي الرواية الفائزة بالمركز الأول في جائزة الشارقة للإبداع العربي الدورة 25، وهي من فئة الروايات القصيرة (النوفيلا)، وتتكون الرواية من خمسة عشر فصلاً.
تنطلق رواية الحرّيق من حدث مركزي تدور حوله الرواية، هو حدث البداية والنهاية في آن واحد، حدث متواتر يوجد في فصول الرواية جميعها، وهو حدث سقوط الحرّيق أي الرجل الذي يعمل في حرق الطوب في بئر النار، إن شخصية هذا الحدث الرئيسة هي أهم شخصية في الرواية، ومع ذلك هي أقل الشخصيات حضورًا، لا نعرف عنها غير اسمها (العم نور)، وتعمل في مصنع السنهوري للطوب، وتقوم بحل مشاكل العاملين معها وتدافع عن العمال المظلومين وتحميهم، إن نوراً كان شخصية تتحلى بالحكمة، تستطيع حل مشاكل الآخرين؛ إنه مثل الشمعة التي تضيء للآخرين سبيلهم، لكن تلك الشمعة احترقت في النهاية، وذاب نور في النار، وقد اقتبس كاتب الرواية نصاً فرعونية قديماً في افتتاحية الرواية، يتحدث عن شخصية تشبه شخصية الحرّيق نور:
"إنه يطفئ لهيب الحريق الذي بين الخلائق، ويقال عنه إنه راعي كل الناس ولا يحمل في قلبه شرًا، وحينما تكون قطعانه قليلة العدد فإنه يصرف يومه في جمع بعضها إلى بعض، فأين هو اليوم؟ هل هو بطريق الصدفة ينام"؟ [القصيدة الخامسة أقوال إيبّور الأسرة السادسة، حوالي 2500ق م].
إن نوراً الذي يسعى لحماية أبناء المصنع وحل مشاكلهم، ويحرص عليهم أكثر من صاحب المصنع نفسه يسقط صدفة، أو هكذا يبدو وهو يمارس عمله الذي اعتاد عليه ويتقنه.
إن كل فصل من فصول الرواية يمثل قصة متكاملة الأركان، هذه القصة تحكي عن أحد العاملين بالمصنع، وينطلق كل فصل، أو كل قصة في استرجاع زمني متعلق بالشخصية بطل الفصل، وينتهي الاسترجاع مع سقوط نور في النار غالباً، لقد استطاع الكاتب إبراهيم المطولي أن يستثمر البناء القصصي القصير، وأن يوظفه في البناء الروائي ببراعة؛ ما يجعل من رواية الحرّيق نصًا أدبيًا عابرًا للأنواع متعددًا في الأشكال الفنية، فكل قصة تأخذ مسارها الخاص طوال الفصل المخصص لها، ثم تصب جميعها في رواية واحدة تجمع كل هذه الفصول في أماكن وأزمنة وشخصيات واحدة وأحداث متشابهة.
اعتمد الكاتب على تقنية الوثائق التسجيلية؛ فقد ذكر نصًا تاريخيًا يشرح شيئاً من طبيعة المكان الذي تدور فيه أحداث الرواية:
"بني صالح: من القرى القديمة، اسمها الأصلي (بني مجنون) وهم جماعة من عرب بني مجنون، فخذ من كلاب استوطنوها فعرفت بهم، كما ورد في تاريخ الفيوم وبلاه، ثم وردت في قوانين ابن مماتي من أعمال الفيومية. ولاستهجان اسم بني مجنون في نظر أهلها الحاليين، طلب علي بك صالح الذي كان عمدة لها تغييره، وتسميتها بني صالح، نسبة إليه وقد وافقت نظارة الداخلية على هذا التغيير بقرار أصدرته في 21 مايو سنة 1897م، وبذلك اختفى اسم بني مجنون من بين النواحي". [القاموس الجغرافي للبلاد المصرية، محمد بك رمزي].
إن توظيف هذه الوثيقة التسجيلية لها أولًا أغراض فنية وهي إقناع القارئ بواقعية ما يُروى، فهذه القرية موجودة وهناك نص تاريخي يثبت ذلك، وسكان هذه القرية تعود أصولهم لقبائل عربية عريقة، حيث يفتخر الناس بالأصل العربي، حتى وإن لم يرتضوا الاسم الذي أصبح غريباً لبعد الزمن وتغير المفاهيم، وثاني الأغراض هو الاعتراض، حيث يعد ذلك رفضاً ضمنياً، فبأي حق تسمى قرية بأكملها على اسم عمدتها، لقد سلب هذا العمدة –كما يظهر- حق أبناء قريته في تقرير اسم قريتهم، لترتبط القرية باسمه ويظل حاضراً في التاريخ، لكن كان يمكن للكاتب أن يزيد من فعل هذه الوثيقة التسجيلية؛ كأن يوثقها بتاريخ الطبعة ورقم الصفحة، أو أن يضع صورة من الكتاب، فكل هذه الوسائل تزيد من إقناع القارئ.
تتخذ رواية الحرّيق من الراوي العليم ساردًا للحكايات، ولم يترك الراوي حرية الشخصيات في أن تصبح راوية حتى في أبسط المقاطع الحوارية، وكان يخضع الشخصيات لمنظوره لا لمنظورهم، ولم يحضر الراوي الذاتي إلا قرب انتهاء الرواية على نحو موجز في الفصل قبل الأخير:
"عرف اهتمامي وسؤالي عما حدث بالمصنع منذ سنين، فانتهز فرصة مروري من أمام المقهى ونادى عليّ:
- أستاذ.. يا أستاذ! ترك شعره للبياض فكبر عدة سنوات دفعة واحدة.
- تعال اشرب شاياً. تنحيت إلى جانب الطريق حتى لا تضرب كفي الحمير المسر، ولا أرجل الأطفال اللاعبين".
لقد ظل ضمير الغائب الضمير المسيطر طوال الحكي إلا في نهاية الرواية، مثلما ظهر من النص المستشهد به، حتى الحديث بضمير المتكلم كان على استحياء، وتسيطر عليه بنية ضمير الغائب، ولعل الراوي أراد أن يظهر موضوعيته وأمانته في نقل الأحداث وأنها لا تعنيه في شيء، لكن كان بإمكانه أن يترك في كل فصل الحديث لإحدى الشخصيات للتحدث عن نفسها قليلًا، وأن تروي واقعة سقوط نور في النار من منظورها.
إن رواية الحرّيق قد تطرقت للعديد من القضايا التي تهم الإنسان، أولى هذه القضايا البيئة وما تتعرض له من تلوث جراء مداخن مصانع الطوب، وتجريف الأراضي الزراعية، وإلقاء المخلفات في المجاري المائية وقطع الأشجار، ما أثر بالسلب على الثروة الحيوانية والسمكية والنباتية، وكل ذلك يصب في النهاية في غير صالح الإنسانية، إن الرواية تطلق صرخة بيئية، رغم أن الرواية لا تعنى بقضايا المناخ الكبرى، لكنها أشارت إلى قرية صغيرة تختنق في صمت جراء أفعال بعض أبنائها في حق الطبيعة، لقد استطاعت الرواية أن تدين كل أشكال الاعتداء على البيئة والصحة العامة دون أن تصرح بذلك.
من القضايا التي تناولتها رواية الحرّيق قضية المهمشين والكادحين والمرأة العاملة وعمالة الأطفال، الذين يعملون في ظروف قاسية غير إنسانية وبالكاد يجدون قوت يومهم، تعرض الرواية لاستغلال رأس المال للعمال، والبطالة والهجرة الداخلية والخارجية في سبيل لقمة العيش، وأيضًا التحرش بالمرأة، وكذلك البحث عن الثراء السريع بالوسائل غير المشروعة ما يعرض الإنسان لأضرار جسيمة.
إن رواية الحرّيق كانت معنية بالتحولات الاجتماعية التي مرت على القرية من العصر الملكي، ثم الحقبة الناصرية، ثم الحقب التي تلتها متناولًا وضعية كافة الطبقات وأثر هذه الحقب عليها، لكن ومع تغير الحقب ظلت شخصيات الرواية كما هي، تتماهى مع ظروفها ولا تتخذ رد فعل مضاد، قد يتغير حال الشخصية من الغنى إلى الفقر والعكس، لكن الشخصيات من الناحية الفكرية تبقى كما هي، ساكنة، لا تتغير أفكارها بتغير الحقب عليها، ومع ذلك فقد ظلت شخصيات الرواية تحمل بذرة الخير داخلها حتى أكثر الشخصيات شرًا.
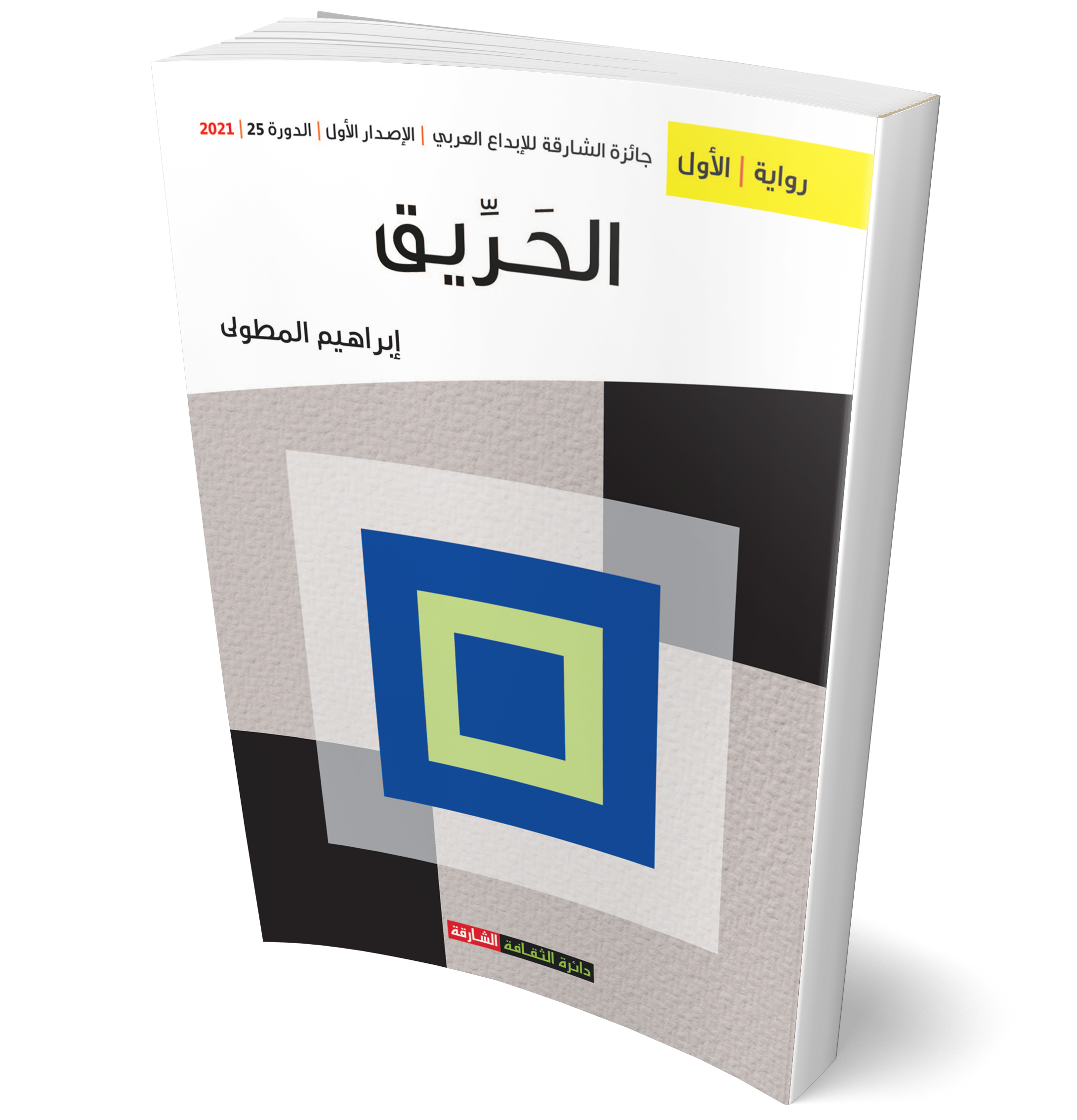
[الحرّيق، إبراهيم المطولي، دائرة الثقافة، جائزة الشارقة للإبداع العربي، الإصدار الأول، الدورة 25، 2021م.]
لقد أثبتت رواية الحرّيق أنها من الروايات المفعمة بالأحداث رغم أنها تدور حول حدث واحد، متعددة الشخصيات، كل شخصية من شخصيات الرواية هي بطل من زاوية ما.
وبعد فإن الكاتب إبراهيم المطولي قد استطاع أن يقدم عالمه الروائي الأول على نحو متميز، وأن يقدم نفسه كروائي ولد كبيرًا وقد استطاع أن يفيد من خبرته الطويلة في عالم القصة القصيرة وأن يستثمر ذلك في بناء المتن الروائي، أما عن رواية الحرّيق وحكايتها ولماذا وقع الحرّيق في النار وكيف وما حدث للشخصيات؛ فيترك للقارئ متعة اكتشاف ذلك.