◄ العتَبة النّصيّة بوصفها مفتاحاً قرائيّاً
يرشح "الإهداء"، الذي جعله القاصّ الإماراتيّ ناصر البكر الزّعابي عتبةً نصيّة أولى في مجموعته "رصيف البرتقال" (دائرة الثّقافة، الشّارقة، ط1، 2025)، بالهاجس الذي يُملِي عليه الاشتغال بالكتابة عموماً، والانحياز إلى فنّ "القصّة القصيرة" خصوصاً بوصفهما شكلاً من أشكال الدِّفاع عن الهُويَّة الشّخصيّة والوطنيّة، ومُناهَضة التّغيُّرات الدّراماتيكيّة التي أصابت وطنه الصّغير والعالم العربيّ الكبير، وغيّرت من بنيتهما وقيمهما ومثلهما العليا، فـ"حمد عبدالله صغران"، الذي يُهديه الكاتبُ مجموعتَه القصصيّة، مخرجٌ سينمائيّ إماراتيٌّ مهمومٌ، هو الآخر، بوطنه الإمارات، ويهجس بالتّغيُّرات التي أصابتْه، وقد اتّخذ من السّينما نافذةً جماليّةً لتسجيل موقفه من هذه التّغيُّرات، وجعلها وسيلته للدِّفاع عن القيم والمثل العليا التي يتبنّاها، ويدافع عنها، وعُنِي هو الآخر بالمُهمَّشين وسكّان القاع، ودافع عنهم، واختار إحدى قصص الإماراتيّ جمعة الفيروز (الذي كان هو الآخر معنيّاً بالمُهمَّشين)، وجعلها متناً حكائيّاً لفيلمه الأوَّل "البحر يطمي" الذي جعله شهادةً بصريّةً تحمل همومه وأحلامه في الدّفاع عن حاضره المأزوم، ومستقبله الرّجراج الذي تتقاذفه الأنواء والأعاصير، وهذا ما جعل من إهداء المجموعة له إجراءً سرديّاً، ومفتاحاً قرائيّاً، وعتبةً نصيّةً تصلح للتّواصُل مع المجموعة، وتأويل قصصها، واستِكْناه دلالتها.
أمّا العتبة النّصيّة الثّانية (التي سمّاها الكاتبُ إهداءً جانبيّاً) فترشح هي الأخرى بالحاجة إلى "اللّمّــة" الحلوة، واللِّقاء بالأصحاب، والحاجة إلى الآخَر، والرّغبة في إقامة علاقة حميمة معه، وتشي بمعاناة وقلق يعيشهما الكاتبُ، ويطمح إلى التّخلُّص منهما في سياق وطنيّ وعالميّ مأزوم أصابه نظامُ التّفاهة والاستهلاك بالكثير من الأذى والعطب، وغيّر من بنيته السُّوسيولوجيّة والمعرفيّة والأخلاقيّة إلى الأبد.
أمّا العتبة النّصيّة الثالثة (وهي جملة مقتطعة من قصّة للإماراتيّة مريم جمعة فرج، وكانت هي الأخرى ساردةً للمهمَّشين)، فتؤكِّد أنَّ ما يحتاج إليه الوطنُ ليغدو أفضل ليس كتلةً اجتماعيّةً مصمتةً، أو قطيعاً سهلَ الانقياد للسلطة والشّريحة التّابعة لها، بل نوعيّة واعية وسامية من البشر تصلح لمواجهة التّحدِّيات، وبناء وطن معافى قادر على تجاوُز أزماته، وبناء كينونته المستقلّة بمنأى عن هيمنة الآخر عليه.
◄ غربة المُهمَّشين واستلابُهم
وحين يلج المتلقّي فضاء المجموعة سيجد بأنّ الكاتب جعل من المُهمَّش شخصيّةً رئيسةً في أغلب قصصه، ومن الملاحَظ أنّ قصّته الأولى "موزِّع الصُّحف"، تكشف عن مدى اغتراب هذه الشّخصيّة في الحيِّز الذي تتحرّك فيه، وترصد انفصالها عن القطيع الذي تتواصل معه، وافتقارها إلى لغة مشتركة تربطها مع الآخرين، وقد شكَّل الكاتبُ من خلال القصّة متناً عجائبيّاً يحتفي بالغريب والعجيب في الحيّز الذي يُحِيل عليه، وأتاح للمتلقِّي أن يتعرّف إلى الشّخصيّة من خلال أفعال تجترحها في المتن الحكائيّ لا من خلال أوصاف خارجيّة تُغدَق عليها من الخارج وحسب. ومع أنّ شخصيّات القصّة تبدو عاجزةً عن تغيير واقعها مستسلمةً له إلا أنّها لا تزال مستميتةً في تغييره، وقد استعان الكاتبُ لتشخيص ذلك بالفعل المضارع، ليؤكِّد أنَّ شخصيّاته، وإنْ بدَتْ مغتربةً عن واقعها، إلا أنّها تبذل جهوداً كبيرة لتغيير حاضرها الذي يبدو جداراً كتيماً يصعب اختراقُه، وصخرةً صمّاء يصعب دحرجتُها، أو نقلُها من مكان إلى آخر. وقد استثمر الكاتبُ المكانَ ليرشح بتهميش شخصيّته المحوريّة، وجعل شخصيَّته تُمضِي أغلب وقتها على الرّصيف، وهو حيّزٌ طرفيٌّ عامٌّ يفتقر إلى الخصوصيّة القادرة على جعل الشّخصيّة تحظى بحياة حميمة موشَّحة بالأمان والطّمأنينة والاستقرار.
ونلقى حالة الاغتراب التي تعانيها الشّخصيّةُ المُهمَّشةُ نفسُها في قصّة "صديق علم الأخلاق"؛ إذْ تقطع إحدى الشّخصيّات الثّانويّة علاقتَها مع الشّخصيّة المحوريّة في القصّة، وتُدِير ظهرها إليها، كما تخفق الشّخصيّةُ المحوريّةُ نفسُها في معرفة الأسباب التي أدّتْ إلى ذلك، ويُفضِي هذا إلى إقامة حاجز بين الشّخصيّتين اللّتين تحاولان التّواصُل مع بعضهما باستماتة، ولكنّهما تخفقان في ذلك، وتبقى كلٌّ منهما مُقصاةً عن الأخرى، وعاجزةً عن التّواصُل معها.
◄ استراتجيّة التّسمية
ولكي يؤكِّد الكاتبُ غربة شخصيّاته في الحيّز الذي تتحرّك فيه فقد حرمها من القدرة على امتلاك أسماء خاصّة بها لمساعدتها في تشكيل هُويّتها، وإظهار تميُّزها من الآخرين، كما جعلها أحياناً أخرى تُعرَف بمهن تمارسها، أو تكتنز صفاتٍ تدلّ على جوهر شخصيّتها، وما تحمله من صفات سلبيّة أو إيجابيّة؛ إذ حملت الشّخصيّةُ المحوريّةُ في القصّة الأولى اسماً دالًّا على مهنتها هو "موزِّع الصُّحف"، كما حملت الشّخصيّةُ الثّانويّةُ في القصّة نفسها اسماً آخر دالًّا على العمل الذي تمارسه هو "السّائق"، وأطلق الكاتبُ أحياناً على بعض شخصيّاته ألقاباً ترشح باستلابها ودونيّة مكانتها الاجتماعيّة، كما في قصّة "مستر زيرو" الذي يرشح عنوانُها بتهميش الشّخصيّة الرّئيسة، وتبوُّئها مكانةً وضيعةً في الهرم الاجتماعيّ الذي تندرج ضمنه، وكما في قصّة "خردوات" التي أطلق الكاتبُ على شخصيّتها المحوريّة اسماً دالًّا على السُّخرية والاستصغار هو "مطّــاط"، أو كما في قصّتي "سارق التّفّاح" و"البدين والمهندس" اللّتين يدلُّ عنوانهما على ما تحمله شخصيّتاهما المحوريّتان من صفات مُستقبَحة في نظر القطيع، في حين وسم بعضَ شخصيّاته الأخرى بصفات ترشح بما تحمله من قيم أخلاقيّة عليا، كـ"المدرِّب النّبيل" في القصّة التي تحمل العنوان نفسه، وقد أبقى الكاتبُ شخصيّتة المحوريّة في القصّة نفسها متّشحةً بالقيم والمثل العليا لكي تستطيع مواجهة القطيع نفسه، وتفلح في تجذير قيمها ومثلها في الحيّز الذي تتحرّك فيه، كما قام، أحياناً، بإطلاق اسم يرشح بصفة حميدة على بعض شخصيّاته المحوريّة، كما في قصّة "دغدغة"؛ إذْ سمّى شخصيّته المحوريّة "أميرة"، في حين جعل الأفعال التي قامت بها في المتن الحكائيّ دالّةً على الخسّة والنّذالة، والوضاعة الأخلاقيّة والاجتماعيّة؛ ما يجعل الاسم دالا على الموارَبة والمفارقة، ووسيلة للهجاء والسُّخرية من النّموذج الذي تمثِّله الشّخصيّة لا غير.
◄ بنية الزّمن السّرديّ
ومن الملاحَظ أنّ الكاتب أقام قصص "موزِّع الصُّحف" و"ذئب وذئاب" و"صديق علم الأخلاق" على بنية التّوازي بين زمن الحكاية وزمن السّرد، واستعان بتقنيّة الحذف المعلن غير المحدَّد للقفز على الفجوات الميتة في زمن السّرد، كما في "مرّت ستُّ سنوات على غيابه"، و"مرّت الأيام ومرّت الأسابيع ومرّت الشّهور"، و"امتدّ قلقي عليه لأشهر عدّة "، الواردة في قصّة "صديق علم الأخلاق"، وهو إجراء سرديٌّ جعل بنية القصّة عنده تقترب من بنية الرّواية، وحرم القصّة من السّلاسة والعفويّة، وأتاح للكاتب أن يطلّ برأسه من بين السّطور، فيخترق سياق السّرد العفويّ، ويقطع مجراه بعبارة زمنيّة تشي بهيمنته على فعل الكتابة وتنامي الحدث، وقد ساوى الكاتبُ بذلك بين زمن القصّة وزمن الرّواية، مع أنّ زمن السّرد في القصّة ينبغي ألا يتجاوز لحظةً أو ومضةً، لكي يتوازى مع شريطها اللّغويّ القصير الذي ينفر من الإطناب والتّرهُّل والحشو، ويميل إلى الاقتصاد والتّكثيف.
◄ آليّاتُ تشكيل السّرد
وقد عمد الكاتب، في تشكيل خطابه القصصيّ، إلى تعمية المكان، وجعَل وقائعَ متنه الحكائيّ تدور في حيّز قصصيّ مُغفَل من الاسم، إلّا أنّه منح المتلقِّي مجموعةً من المفاتيح والمؤشِّرات التي تتيح له التّكهُّن بأنّ زمن وقائع القصص يشمل الرّبع الأخير من القرن الماضي، والرّبع الأوّل من القرن الحالي، وهي الفترة التي هيمن فيها نظامُ التّفاهة والاستهلاك على الفضاء الاجتماعيّ في العالم العربيّ عموماً، وترك آثاراً فادحة في البنيتين السُّوسيولوجيّة والمعرفيّة، مع ملاحظة أنّ الكاتب كان حريصاً على تعويم الزّمان وعدم تحديده للهرب من مغبّة المطابَقة بين نصّه والمرجع الذي يُوهِم به، ويُحِيلُ عليه.
ومن الملاحَظ أنّ الكاتب قام أحياناً بمصادرة فعل القراءة والتّلقّي حين أتاح لنفسه الكشف عن المستوى الدّلاليّ في بعض قصصه، كما في قصّة "موظَّفة البريد" التي يرشح متنُها الحكائيّ بهيمنة الفنّ الاستهلاكيّ على الحيّز القصصيّ، وغياب الاهتمام بالكتاب والقراءة الجادّة عموماً، ولذلك يغدو التّصريح، الذي جاء على لسان السّارد في الخاتمة، حشواً وفضلة لا تحتملهما بنيةُ القصّة القصيرة التي تنهض على التّخييل والانزياح، وتنفر من أيّ تدخُّل مباشر يقوم به الكاتب عند تشكيل نصّه بما يؤّثّر في حركة السّرد العفويّة وسلاستها وانسيابها.
وقد استخدم الكاتبُ التّناصَّ في قصّة "الأشباح" لتشكيل المستوى الدّلاليّ في القصّة، وتحقيق صفتي الادّخار والتّكثيف اللّغويّ، اللّتين يحتاج إليهما الشّريطُ اللّغويّ لبناء قصّة قصيرة، كما قام في قصّتي "سارق التّفّاح" و"مستودع الزّجاج" بحذف عبارة نابية تلفظّت بها الشّخصيّة المحوريّة في حوارها مع شخصيّة أخرى؛ فحرمنا بذلك من التّعرُّف إلى السّويّة المعرفيّة والأخلاقيّة لهذه الشّخصيّة، ومارس نوعاً من القمع على القارِئ مانعاً إيّاه من التّعرُّف إلى الملفوظ الحيّ للشّخصيّة في موقف اجتماعيّ محدَّد.
ومن الملاحَظ أنّ بعض القصص تقع في مطبّ الاستطراد الذي لا تحتمله بنية القصّة القصيرة الهشّة؛ ففي قصّة "استفــزاز" يقول سارد القصّة: "خرجتُ في المساء لزيارة أحد الأصدقاء ثمّ قررت الذّهاب إلى صالون الحلاقة (أزوره مرّتين في الأسبوع)، ثمّ مررتُ بالمصبغة حيث أنتظر ملابسي منذ أسبوع كامل" (ص: 31)، وواضح أنّ عبارة "أزوره مرّتين في الأسبوع" حشْوٌ لا تستدعيه بنيةُ القصّة أو آليّةُ تشكيل مستواها الدّلاليّ، ويمكن إسقاطها من المتن من دون أن تتأثّر بنية القصّة أو صياغتها الفنيّة، وقد حصل الأمر نفسه في موضع آخر من القصّة نفسها حيث يقول السّارد المشارك: "رنّ الهاتف، على رقمي المهمَل، أمتلك ثلاثة أرقام، أستخدم رقماً واحداً لمكالماتي، الرّقم الذي ورثته عن أبي رحمه الله، بينما هناك بطاقة مدفوعة مسبقاً لا أستطيع الاستغناء عنها لأنّها الرّقم المسجَّل في البنك وبعض الدّوائر المحليّة، والرّقم الثّالث الذي لا يرنّ إلا نادراً فهو رقم (الواتس آب) أساساً"، وواضح أيضاً أنّ كلّ الجمل الواردة بعد عبارة "رنّ الهاتف على رقمي المهمَل" حشوٌ لا يتطلّبه المبنى الحكائيّ في القصّة، ولا يستدعيه السّياق، وتمجُّه آليّة تشكيل المبنى الحكائيّ في القصّة القصيرة عموماً.
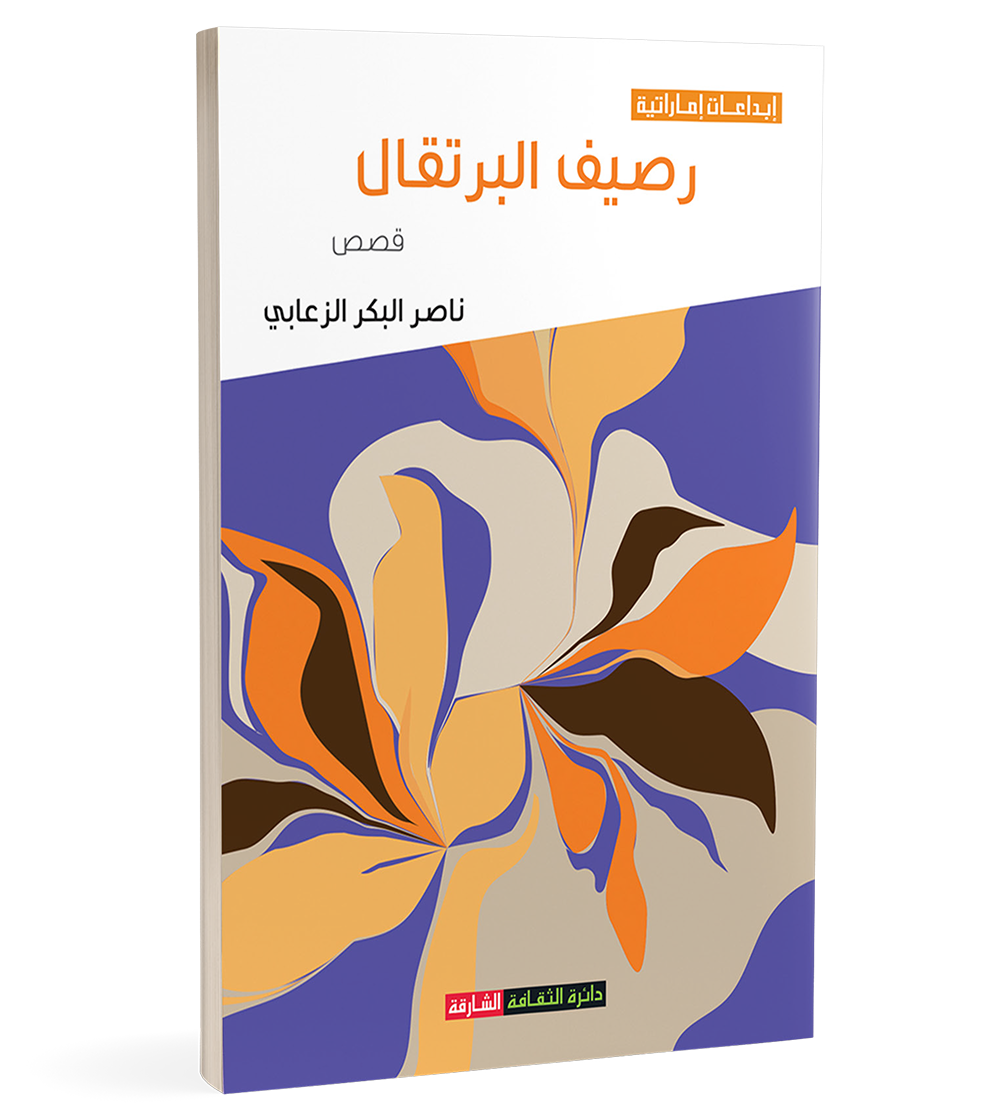
تركيب:
هكذا يتبيّن لنا أنّ قصص المجموعة ترشح بغربة شخصيّاتها واستلابها، وتهجو زمنها الذي حرم شخصيّاتها من وعي ما يجري من تغيُّرات في قلب الحياة الاجتماعيّة، فبقيت في القاع، كما حرمها من نعمة التّواصل، وأفقدها القواسم المُشترَكة التي تسمح لها بتشكيل شريحة اجتماعيّة قادرة على اكتساب حياة رخيّة ومعافاة.
ومن الملاحظ أنّ الكاتب استطاع في مجموعته القبض على لحظات مفصليّة مهمّة في تاريخ المجتمع الإماراتيّ والعربيّ، ونفذ من خلالها إلى جوهر ما يواجه هذا المجتمعَ من تحدّيات وأزمات، وقد سلّط الضّوء، من خلال العالم التّخيُّلي الذي شكّله، على الشّريحة الاجتماعيّة الأكثر تضرُّراً من التّغيُّرات العاصفة التي أصابت المجتمع المذكور، وهي شريحة المُهمَّشين وسكّان القاع، وتقصّى ما واجهَتْه من أزمات وتحدّيّات، وعكس دفاعَها المستميت عن هُويّتها وكينونتها، إلا أنّه انتهج في مجمل قصصه آليّة فنيّة تتبنّى الأعراف السّرديّة التّقليديّة، وتدير ظهرها للاجتراحات الفنّيّة التي حقّقتها القصّةُ الحداثيّة العربيّة على أيدي معلّمين كبار كزكريا تامر، ومحمد خضيّر، وإدوار الخرّاط، ومحمّد شكري، ورباب هلال، ويونس محمود يونس، وغيرهم، ولذلك يمكن الزّعم بأنّ المجموعة لم تبلغ الشّأو الفنّيّ الذي حقّقه كتّاب إماراتيّون سابقون للزّعابي في حقل القصّة الإماراتيّة، لكنّ صوته الحارّ المفعم بالشّجن والقلق يكشف عن صوت شابٍّ موهوب يهجس بما هو قادم، ويحذّر منه، ويملك القدرة على استيعابه جماليّاً في قصص جديدة تشكِّل إضافة دلاليّة إلى لوحة القصّة الإماراتيّة من حيث وعيُها الجماليّ للواقع، وهي لوحة رسمها قاصُّون مبدعون كعبدالله صقر المرّي، وصالح كرامة العامريّ، ومريم جمعة فرج، وإبراهيم مبارك، وغيرهم.