يرى علماء الأدب أنّ السيرة الذاتية كجنس أدبيّ مستقلّ بدأت في اليونان بالقرنين الرابع والخامس قبل الميلاد، في حين يرى البعض أنّ فن السيرة يعود إلى أوروبا. وأن اعترافات "أوغسطين" تستحقّ لقب أقدم سيرة ذاتية، وأن أقدم رواية إنجليزية للسيرة هي "مارغري كيمب".
لكنها على أية حالٍ سارت نحو التطور في بداية القرن السابع عشر، بزيادة الأعمال الأدبيّة التي تدخل في نطاقها؛ لذا تراوحت إلى أشكال مختلفة منها: اليوميات والذكريات. مثال على ذلك في الأدب الغربيّ القصة التي كتبتها "لوسي هتشنسون"، وتُعدّ صورة واضحة للعهد الذي كُتبت فيه، قدّمت فيها أوصاف الشخصيات المهمّة آنذاك. تطور بعدها ظهور السير الذاتية؛ فصارت أعمالًا كلاسيكيّة في الأدب العالمي، مثل مذكرات "إدوارد جيبون"، وغيرها.
أمّا عن تاريخ السيرة الذاتية في الأدب العربي؛ فقد ظهرت منذ العصر الجاهلي؛ فالشعر الغنائي هو أول فنٍ مَهْد للسيرة الذاتية. وعندما جاء الإسلام أصبحت الحاجة أكبر إلى تدوين الوقائع والشخصيات التاريخية؛ فبرزت السيرة الذاتية واشتُهرت حينذاك لكثير من الشخصيات. بيْدَ أنّ تطوّر السيرة الذاتية في الأدب اكتسب موضوعيّة أكبر وأدقّ في العرض والتحقيق؛ فظهرت كتب "الطبقات" و"التراجم"، وهي الكتب التي تلت عصر الرواية والتدوين.
في القرن الخامس الهجري وصف ابن سينا حياته في كتابه "ترجمة ابن سينا" إذ فصّل أخباره وقدّم سيرته للقارئ. وفي أوائل القرن السادس الهجري ظهر الغزالي أحد مُترجمي الصوفيّة. وفي نهاية هذا القرن ظهر كتاب "التبيان" لعبد الله بن بلقين، ونشر هذا الكتاب كاملاً في أواسط القرن العشرين، ولا تقتصر السيرة الذاتية وكُتبها على هذه الأمثلة، بل هناك الكثير من المؤلفين والكُتب التي تعمّقت في فن السيرة وعرض الكثير من الأخبار.
في بداية العصر الحديث أيْ ما يُقارب نهاية القرن التاسع عشر الميلاديّ، جاء المحدثون وسلكوا طريقة الأدباء القدماء في السيرة الذاتية، بيد أنّ بداية هذا العصر اشتُهر بظهور حركات التحرّر في الساحات العربية، ومن أهمها "الحركة الفكرية" التي دعا إليها رفاعة الطهطاوي، فألَّف كتابه "تخليص الإبريز في تلخيص باريز"، وكان هذا الكتاب بِمثابة البداية التي شجّعت إلى كتابة فن السيرة الذاتيّة في الأدب المعاصر، واستطاع هذا الفن أن ينقل بمصداقيةٍ وثقةٍ حقيقة الصدام بين الغرب والشرق، غير أن أدباء الأدب العربي المعاصر لم يكتفوا بسلك طريقة الأدباء القدماء العرب في السيرة الذاتية، بل إن بعضهم تأثروا بالنهضة الأوروبية الحديثة. وفي بداية القرن العشرين تبلْور هذا الفن وساعد على إظهار ملامح الشخصيات القومية في الأدب العربي، وتمثيل الشعور القومي في روح الشعوب النامية والمثقفة، وتبعًا لذلك دعا أدباء المدرسة الحديثة إلى البحث عن أدب صادق ينبع من آلام الشعوب وآمالها، والابتعاد عن التقليد وتبعية الموروثات والاقتباسات؛ فبرزت كتب التراجم الذاتية؛ وهي الكتب التي عكست الفكر العربي المُعاصر ونقلت أزمة الإنسان العربي، من خلال أحاديث الأدباء والكُتّاب وأقوالهم عن حياتهم النفسية والأدبيّة والثقافية وعن إنتاجهم الفكري، ممّا جعل فن السيرة الذاتية والترجمة الذاتية في الأدب العربي يبلغ قمّة تطوره عبر العصور.
***
والفضول كثيراً مّا يغدو حصاناً رابحاً حين يدفعنا لتتبع أثر كاتب بعينه محبةً منا، أو محاولة لاكتشاف، رغبتي المُلحة للتعرف على عالم فنان أثارتني لوحاته الفنية وأنا المتيمة بالألوان والكلمات؛ ولم أكن محظوظة بقراءته من قبل هي التي دفعتني لقراءة "الحمودي" قصة المهاجر على درب الحنين والأنين، في محاولة للتنصت على عالم كاتبٍ قديرٍ جمع كلمته وريشته وألوانه؛ ليقيم عالماً إبداعياً خاصاً به يشبهه وحده هو الدكتور "عمر عبد العزيز".
ليكن أول كتبه بين يدي هو سيرته الذاتية الغيرية في نفس الوقت والتي اختار عنوانها "الحمودي" مؤكداً نسب البطل إلى قبيلته التي يعتز بانتمائه لها، ولمَ لا وهي صاحبة تراث عريض من التصوف والتعبد والألم كلها اجتمعت في الطفل النابه صاحب السيرة "عبد العزيز الحمودي".
"الحمودية" من القبائل الأقرب للمدنية بعيدة عن التطرف القبلي، ويبدو هذا في وصف الكاتب لها، تتواجد في عدة محافظات يمنية أبرزها تعز وإبْ وعمران وحضرموت. لكنها توجد أيضاً في المملكة العربية السعودية، وفي دولة الإمارات وفي المملكة المغربية. منبع تلك القبيلة كما يقول المؤرخون يعود إلى المغرب العربي حيث كانت الدولة الحمودية، بينما يؤكد آخرون بأنها إحدى قبائل بلي السعودية التي يعود أصلها إلى الجد قحطان حسب سلسلتهم للجدود، ويرى الكثير من المؤرخين بأنها ترجع إلى القبائل اليمنية التي كانت تسكن مأرب، ورحلت من هناك وتوزعت بين المحافظات اليمنية قبل انفجار السد ومنها رحلوا إلى السعودية والإمارات والمغرب العربي.
***
ليس هينا على الكاتب مهما توهجت رحلته الإبداعية أن يشرع في كتابة سيرته الذاتية والتي أصفها بالغيرية لأنه يستدعي رحلة والده منذ طفولته مجنبا ذاته عن الحكاية، بينما المدقق في التفاصيل يعي جيداً أنها سيرة مكانية للكاتب الذي لم يستطع إخفاء مشاعر الحنين والشجن والأنين بين أحرف الرحلة التي بدأها منذ جده "الطيار" ليستدعي نشأة الأب وتفاصيل تكوينه وارتباطه بأرض ترابها من دم ولحم نبت عليها صنوف من البشر والكائنات كل منها يحمل ملامحاً تخصه رغم اشتراكهم في وحدة المكان. كان منطقياً للكاتب أن يقوم بدور الراوي العليم بالمجريات، وهو ابن أبيه بطل الحكاية. "عمر عبد العزيز" الذي راح ينبش في ذاكرته عما تراءى على أرضه - مسرح الأحداث- التي شهدت تكوينه والسابقين، ولا زالت بكل تفاصيلها نقشاً على روحه وعقله ينبئ عن ألم يبدو ممزوجاً بملامحه وإن كان يحاول الإخفاء.
عن "حارة العرب" ستقرأ؛ فتجد نفسك في باطن أسطورة قديمة محيرة وشائقة لا تود الخروج منها. يزداد نهمك لمطالعة شخصيات رصدتها ذاكرة الكاتب بمحبة العارف، من "دمدم" بهلول الحارة هذا الغريب الذي يحار الجميع في شؤونه في الحارة البسيطة التي كان أهلها يشربون الماء من الآبار مباشرة لا يعرفون القوارير الصناعية. حارة سلطان النوم هو السيد فيها حارة المساء والماء والنوارس. فيها الناس في بحث دؤوب عن المستحيل حتى إن الأحاجي المتوارثة فيهم تلخصت في كيفية الإمساك بالماء وشرب الهواء وتحويل التراب إلى تبر... هؤلاء القادرون على صنع المستحيلات...
كانت تلك الحارة بحريا قديماً انحسر عنه البحر في لحظة جزرٍ عظيم؛ ولأني نشأت في حجر البحر وفي عالم قد يكون شبيهاً جذبتني علاقتهم بالبحر والقوارب والأصداف وقدرة الأطفال على الأحلام، كما جذبني وصف السارد للتفاصيل الصغيرة، هذا السارد نفسه الذي رغم كل السنوات واللحظات العصيبة والأحزان التي مرت به لا زال يحمل نفس قلب الطفل ذاته لم يتبدل.
ستجدك مشدوهاً بشخوصٍ تتبع ظلها داخل الحكاية تود لو تلمسها وتعرف أسرارها، عن وصفه لـ"دمدم" ومبخرته والخرافات التي يحكيها الناس عن قدراته وأبخرته التي تصنع المعجزات. عن "سيدة الصمت" وحكايات الناس عن الجن، "باموزا " بائع الكاسات الزجاجية، العاشق للسير بقدمين حافيتين والذي صار بفحولته مصدر إلهام للنساء المتعطشات. عن المصور الوحيد في تلك الحارة الملقب بذي العين الواحدة. شخوص تشعرك بأنها كائنات في منطقة ما بين الحقيقة والخيال متخمة بالتفاصيل الشعبية المتوارثة.
وحين يحكي عن جده "الطيار" المتصوف سقراطي الهوى، واصل الليل بالنهار، الذي يعيش مع الضواري والحشرات في البراري، ويقتات ما تجود به الطبيعية من ثمار.
وعن الجدة (بلو على دقوود) وصفاتها الجسدية التي ورثتها عن أبيها حجم الأذنين الكبيرتين والعينين اللماحتين وجمال الصوماليات، وعن بصيرتها المتقدة التي كانت تجعلها تسألهم كل صباح عن أخبار موتاهم. يصف تفاصيل العلاقة بين أصابع الجدة وحبات المسبحة ووصفه الدقيق لتمتماتها وقت الذكر والتسبيح الشفاهي وقدرتها على التكرار بأريحية وعقلٍ رصين. تلك الجدة غير الملمة بالقراءة والكتابة والتي منحها الله نُبُوّة لم يرها غيرها حين كانت تشير إلى أن الحي الماثل أمامها سيكون في عداد الموتى. كانت على يقين إيماني بالغيب وحضور أفقي في الزمان ببرازخ المجهول حتى لحقت بالموتى الذين كانت تسأل عنهم دوماً.
***
ينقلنا إلى المدرسة الإيطالية القابعة في ركن قصي بالحارة مدرسة الفلاح العربية.. ويخبرنا بأنها عربية الاسم فقط، بينما مناهجها وبيئتها الأدائية وحدائقها كانت إيطالية منسوخة من المدارس الكلاسيكية الرومانية القديمة، في مقابلها السينما العالمية المدبلجة بالإيطالية تتقاطع مع الكنائس الكاثوليكية ومشاهد الفنون الرومانية.
حارة العرب ابتكرها الإيطاليون لتشييد سكن للمهاجريين اليمنيين ثم بدت حاضناً لجموع المهاجرين الذين جاؤوا مع الحملة الإيطالية في جنوب الصومال وآخرون وصلوا هروباً من جور الإمامة في شمال اليمن وحروب السلطنات في جنوبها وتبلورت ملامح الحارة لتكتسي طابعاً حضرياً وأصبحت نموذجاً للخلاسية الحقيقية.
وينشغل الطفل البطل بالبحر فيخبره والده الذي يجيد الإيطالية ولا يعرف العربية إن وراء البحر "بر العرب" لينشغل خياله بما وراء البحر.
عبد العزيز الحمودي هو الابن الوحيد لجده الطيار، وهو الطبيب الملقب بـ"المجاريح" أحد المتفردين في ممارسة الطب في تلك الأصقاع النائية. ولد في منطقة جبيلة جنوب اليمن كان كثير الأسفار للبحث عن بعض الأدوات الجراحية. نما "عبد العزيز" في قمة جبل حبشي بمدينة تعز في بيئة رفيعة الجمال والجلال. مخطوفاً كان بتلك البيئة ومفرداتها الأولى.
ثم يأخذنا إلى حال الطفل بعد موت الأب. ذات غروب حل بالبيت جند الحاكم لجمع الإتاوات، ولما عجز آل الحموي على الدفع قرر الجند نقل الغلام كرهينة في الحبس. ووصفه لمرارة الحبس.. عن هذا الخبز العسكري الثقيل المسمى "كُدمة" الذي ينتظرونه لسد رمق الجوع. وعن الإحساس بالقهر والظلم المحيط بهذا الطفل البريء ليبدله إلى حائر يائسٍ ينتظر ساعة للفرج. حتى استطاع الفتى الهرب في ليلة مظلمة هو ورفاقه بعد نوم طويل للحارس. يصفه الكاتب بأنه هروب ملحمي تحت ستار المطر والظلام. وبعد متاهات ورعب من طريق طويل نحو الجنوب وصل إلى عدن وعند جبال الملح يحمل الملح فوق ظهره مع العمال ليبدأ رحلة أخرى.
لكنه لا يزال طفلاً مفتوناً بآلة غريبة تخرج صوتاً كالطيور في خيمة الضابط الإيطالي؛ لأنها أرجعته إلى صوت الطيور في قريته بالأكمة الحمراء. يستمع إلى الآلة ويستمتع بها ليكتشف الضابط أنه أمام شاب فتيٍّ فطلب منه وضع إصبعه على الآلة بل وطلب منه أن يسجل كجندي في الجيش الإيطالي، تلك المدينة الصادحة بالمسرات.
في ذات اليوم أصبح عبد العزيز الحمودي رقماً في العسكرية الإيطالية التواقة للوصول إلى الصومال الجنوبي.
انطلقت باخرة الإيطاليين صوب هدفها في مدينة مقديشيو والحمودي ورفاقه اليمانيون يتلهفون لمعانقة مدينة المرايا والضباب. ويواصل حكيه عن الشخصيات المدهشة ليخبرنا عن البحار اليماني (كشَّار) الذي كان قادراً على تحديد مكان سير الباخرة من تذوق طعم مياه البحر لم يكن مجرد بحار. كان عارفاً بعلوم المواد والأفلاك والرياضات. ووصل الحمودي مقديشيو ليبدأ حياة أخرى.
يقول الكاتب ذلك الراوي العليم:
-كان بوسع الحمودي سرد قصة بكاملها أمام كل علامة رافقته منذ الإصابات.. ويروي لنا تلك القصص الواقعية حد الخرافة المقرونة بالحروب والمتاهات.. كحكايته مع الأسير الأثيوبي حين أمره قائده الإيطالي اصطحاب الأسير لتصفيته، فخرج الحمودي به بعيداً، ليفك قيد الأسير ويطلقه والأسير غير مصدق للرحمة التي نالته في حين أطلق الحمودي رصاصة الرحمة تلك في الهواء ليوهم قائده بإنجاز المهمة ويفر الأسير. وحكايته مع الناقة والثعبان وأسد البراري.. حكايات ذكرتني بقصص الأطفال حين أكتبها مثيرة قصص الواقع الذي نحياه.
حكايات الحمودي التي توازت مع عوالم طفولية شيقة لمجاميع الأطفال المتدافعين من قمة التلال الرملية الفاصلة بين البحر والحارة، تلك التلال هي الملعب والخيار والابتكار.
الطبيعة البكر التي كانت مصدراً لحكايات صادحة لطفولة مشتعلة بأحلامه والصغار حوله، والأمنيات تلهبها رمال التلال والشواطئ، والقوارب أيضاً الركن الركين في حياتهم، فالصياد يسافر باحثاً عن اللآلئ وجواهر البحر ويعود ممتلئاً بالأحلام والحكايات.
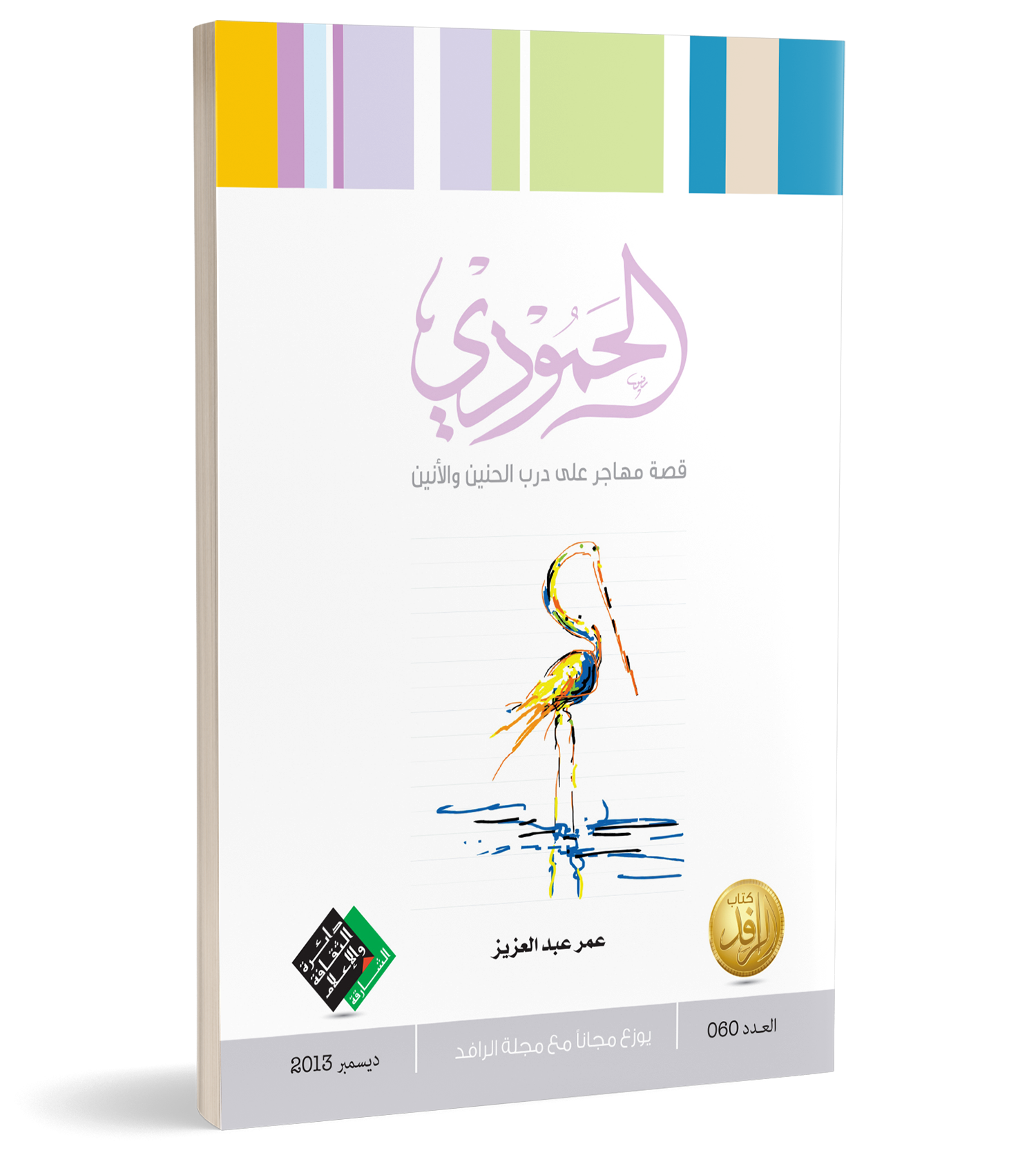
سيرة الحمودي هي سيرة المكان الذي ساهم في تشكيل وعيه ووجدانه، المكان الذي أحبه واختلط بروحه ولونه وحكايات، لكن الكاتب "عمر عبد العزيز" اختار نهاية سريعة للحكاية حين قال في آخر الكتاب ينهي سيرته:
"فالحمودي الذي جاء مع العسكرية الإيطالية من عدن سيعود إلى عدن بعد ستين عاماً من الحنين والأنين في طريقه البحري عبر خليج عدن ستعود ذاكرته إلى ذات المشاهد الأولى التي تعلم منها معنى دوران الأرض. بعد تجربة الصومال البرلمانية الفريدة ومغادرة الإيطاليين.
كان الخيار الجبري للحمودي هو البقاء في مقديشيو مع زوجته وأبنائه وأبناء صديقه المفقود.
لكنه يخبرنا في النهاية بالتميمة السحرية التي ورثها الحمودي عن جده الطيار وانتقلت بقوة العادة إلى أسلافه المتابعين لرحلة الحنين والأنين. هكذا يختم سيرته ليتركنا في حيرة عن الذي لم يقله، وعما سيأتي وما لم يبح به الحمودي الابن؛ لنظل في انتظار اكتمال المسيرة.