قد يُثير التوظيف الخطابي لمصطلحٍ لغويٍّ مَا فضولًا إن لم نقلْ جدلًا حول المناسبة والاختيار، وكذلك حول المقاصد الميتا-لغوية الكامنة وراء اختيار ذاك اللَّفظ بدل آخر في حالة وجود ملامحِ التَّرادف بينهما. فهل هناك أُلفةٌ طبيعيَّةٌ بين القواعد النَّظرية المعيارية ِللُّغة وبين الممارسة الفعليَّة لهذه اللُّغة؟ أمْ وراء ذلك سلطةُ تدبيرٍ وتدويرٍ؟ وبتعبيرٍ آخر، هل أن اللُّغة نظامٌ معياريٌّ يفرض نفسه في التَّعامل على أنه قيمةٌ معياريَّة مجرَّدة ملزِمةٌ، أم إن الاشتغال مكبَّلٌ بسلطةِ المؤسَّسات الاجتماعية والسياسية وببِناها القويَّة لتتلخَّص في أنها حدثٌ يخضع لديناميكية العلاقات والممارسات؟
ممَّا لا شكَّ فيه أن الإنسان منذ أن اكتشف نفسه بأنه كائنٌ ناطقٌ -حتى نَتحاشى ذكْر الحيوان الذي روَّضه ذات يومٍ الفيلسوف الإغريقي الشهير أرسطوطاليس ووضعه في التَّشكيل الإنساني- اكتشف أن اللُّغةَ هي وسيلته اليوميّة التي لا يقْوى على التخلّي عنها، وهي منفذُه الأمثل إلى خارج ذاته يمدُّه التواصل مع بني جِنسه ويمنَحه المتنفَّس في التعبير عن أفكاره وانفعالاته النفسيَّة. لذا فلا غرابة أن يهتمَّ أصحاب الفكر باللُّغة، فمن أفلاطون وأرسطو في عصر الفلسفة إلى الجاحظ وابن جنّي من جهة البَيان والبحث اللغوي، أو أبي حامد الغزالي وابن تيمية من جهة تقرير العقائد في عصور حَضارتنا إلى ديكارت وسبينوزا وهيوم وغيرهم من الغربيّين، كانت الأفكارُ مختلفةً ومتباينة حول الفهمِ العام لمعنى اللُّغة حسب المذاهب الفلسفية أو المعتقدات الفكرية. لكن، جميعُهم يجمعون على أهمية اللُّغة وارتباط الإنسان بها ارتباطًا وجوديًّا حتى ترسَّخَ الاعتقاد في الفلسفة المعاصرة بأنَّ اللُّغة كفيلةٌ بحلِّ المشاكل في مختلف فروع المعرفة عامة.
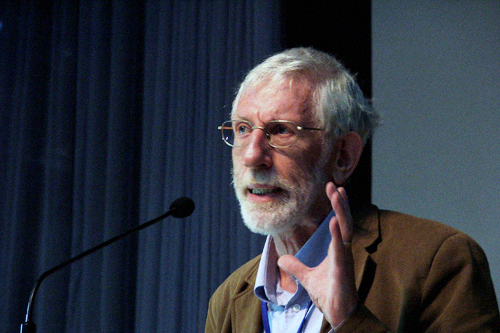
نورمان فاركلوف Norman Fairclough
عَكف نورمان فاركلوف (Norman Fairclough) في كتابه اللُّغة والسُّلطة على إجلاء العمل الذي تؤدّيه اللُّغة للحفاظ على علاقات السُّلطة وتغييرها في المجتمع المعاصر، فراح يبرز أساليب تحليل اللُّغة وضرورة التَّحليل النَّقدي للخطاب الذي يعدُّ من الوسائل المعتمدة في الصراعات الاجتماعية، ويعدُّ مجالًا لهَمْهمَة إنجاز المصطلح الذي من بابه نَلِج موضوعنا المتَّصلة قسماته بحدث الساعة وما دار من جدلٍ على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى الوسائط الإلكترونية الأخرى حول إشكالية اللُّغة والتوظيف السياسي في استعمال لفظ الكَمامَة في الخطاب الصحّي، وما إذا كانت اللُّغة تُبيحه في مثل هذا الخطاب أم هو انتهاكٌ للتعبير؟ ثم ما إذا كان هناك إيحاءٌ يُومئُ إلى علاقة السُّلطة بالفرد من وراء قواعد الضَّبط التي تحكم حركيَّة اللُّغة وتفاعلها مع البِنى الاجتماعية، لنتفقَّد أخيرًا مخصصَّات اختيار المصطلح في خطابٍ صحيٍّ أصبح معولمًا بعدما هَوَت الحدود أمام سطْوة فيروس كورونا؟ ونستَبيِن أهو اختيارٌ يتأتَّى بالاعتماد على أصول التُّراث أم لا بُد من مقارنةٍ بالمُكافئات الغربيَّة؟ فإذا تملَّصْنا قليلًا من رفقة نورمان فيركلوف، وتغافلْنا حينًا عن القوى الكامنة وراء الاستعمال أو توجيه الاستعمال بفعل التدخُّلات في حركة اللُّغة سواء كانت على أسسٍ نظريَّة معرفيَّة أو بحوثٍ تطبيقيَّة تدرس علاقة اللُّغة بالمجتمع، أمْ كانت مجرَّد قراراتٍ سياسيَّة في توجيه المصطلح على ما يصيب هذه القرارات من تضخُّمٍ في مساحة الذَّاتية، حتى حَدا الأمر بأنطوان مِيّي (Antoine Meillet) إلى دراسة اللُّغة انطلاقًا من الواقع الاجتماعي لاستكشاف القوانين التي تَضبطها في إطار البِنية الاجتماعيَّة، واكتفينا بالاعتقاد بأن اللُّغة مستودعٌ ضخمٌ من الأصناف اللَّفظية والمفاهيم الصانعة لأَحداث تَواصلنا في معظمها وأحداث تفكيرنا جملةً وتفصيلًا، أيْ اكتفيْنا بالجهد الذي لا يُحمِّل المصطلح تضميناتٍ للمعنَى تَنوءُ بِكَلْكَـلِ أثقل من ليْل امرئ القيس، ثمَّ خُضنا سفرًا معرفيّاً محضًا في الدلالة من طريق المعاجم لا تُرهقه ميكيافيليَّة السَّاسة ولا تُجهده تأويليَّة المتعسِّفين؛ لنَستبين استخدام المفردات انطلاقًا من المَفازَة النَّسقيَّة العاريَة من الحاجات السّياقية بمنظارٍ فيه شيءٌ من ألوان البينيويَّة دون صرامة الرؤية النسقية، وفيه أثرٌ من استضافةٍ تشومسكيَّة تكرم بالكفاءة والأداء واستلقاءة اللُّغة الوارفةِ ظلالُها في بهوِ التوليديَّة، وفيه كذلك ترانيحٌ من تأثير النماذج المختلفة التي لا يتملَّص منها إنسانٌ عصرنتيك في سر اللحظات الرقطاء مع الأداء وهواجس التَّداوليَّة -وجدنا أن مناط المسألة إذا بسَّطناها يرجع إلى المعنى واللَّفظ – حتى وإن كان ما يُطرح اليوم لا يتوقَّف عند هذه الجدليَّة ومن هو أسبقُ أو أشرفُ بتعبير القدامى، بل يتعدَّاها إلى الجانب المعياري بإصدار حكم الصواب أو الخطأ وفتح باب السُّخرية لفئةٍ من فئة أو باب التَّسْفيه من جماعةٍ لأخرى، أو تجريم طائفةٍ لطائفةٍ ولنقف هنا، فما عاد الاختلاف أعنفَ من ذلك؛ مع أن اللغة ما هي إلا مساحةٌ للتَّباري في اختلافٍ لا توقِفه حتى الكلمة الواحدة.
حَكى السّيوطي عن الأصمعي أن رَجُليْن اختلفا في الصَّقْر؛ فقال أحدهما بالصَّاد وقال الآخر بالسين، فتَراضَيا بأول واردٍ عليهما، فَحكِيا له ما هما فيه، فقال: لا أقول ما قلتما؛ إنما هو الزَّقْر [المُزهر في اللُّغة ج1]. تتكوَّن الكلمة أو أيَّة وحدةٍ لغويةٍ تكبرها من جانبيْن أساسيين مهمَّين لا ينفصل أحدهما عن الآخر هما: اللَّفظ والمعنى. ودراسة اللغة في حدِّ ذاتها تعدُّ في جانب كبير منها دراسةٌ للعلاقة بين هذين الجانبين، ولا مُشاحَّة في أن قضيَّةَ اللَّفظ والمعنى تبقى على رأسِ الاهتمام في مسألة اللُّغة برمَّتها. فما المقصود باللَّفظ والمعنى: أهيَ الكلمة من الجسد والروح؟ أم هي الثنائيَّة التي لها من التحيُّز ومُشاكلة المتلفّظ وَوهْم المتلقّي نصيبٌ؟ ومن تعريف الكلمة اصطلاحًا نَختار قول الزًّمخشري (ت 538هـ): "الكلمة هي اللَّفظة الدَّالة على معنًى مفردٍ بالوضع". أما عند ابن مالك (ت 672 هـ)، فالكلمة هي: "لفظٌ مستقلٌّ دالٌّ بالوضع تحقيقًا أو تقديرًا أو منْوي معه كذلك". لكن من وراء هذا التعريف المبسَّط كانت المشاكل أو القضايا التي شغلت النُقَّاد العرب عديدةٌ لا تلمُّها صفحةٌ أو صفحاتٌ معدوداتٌ، بل تعدَّدت بقدر ما نشِب حولها مِن اختلافٍ لوجهات النَّظر بين مَن يتعصَّب لِلفظٍ ويحتجُّ له، وبين مَن لا يرى سوى المعنى شيئًا يدعو للاهتمام، وبين ثالثٍ على مذهب الوسط محاولًا التوفيق بين الرأيين.
والقضية ليست موقوفة على العربية، فهي قضيَّة إنسانيةٌ لها غورٌ في التاريخ؛ فهذا "أفلاطون" يجعل الأصل والصورة في مقابل المعنى واللَّفظ، فاللَّفظ لا يُمثِّل سوى صورةٍ للمعنى الأصل الذي له إقامةٌ فخمةٌ في جزيرة الأحلام أو المُثل. وعليه فإن الألفاظ هي التَّشويه الأرضي للمعاني لا يُمكنها أن تصل إلى مرتبة المعاني الأصول ونقائها؛ أما التلميذ المتمرّد المطيع أرسطو، فقد ذهب إلى التوفيق بين اللَّفظ والمعنى فنقد المعادلة التي تجعل الأصل والصورة في مقابل المعنى ورأى أن اللَّفظ لا يمثِّل صورة الأصل (المعنى)، بل هو أصلٌ كذلك، لأن الطبيعة في ذاتها ناقصةٌ، فاللَّفظ صورةٌ للمعنى في عالم النَّقص والشعر عنده أو الفن الذي يتسامى بالذَّاتِ عمومًا هو ما يُجبر النَّقص ذلك.
أمَّا عند العرب، فنجد الجاحظَ أمام الفصاحة المشغول بالمسائل حتى أردَتْه أوعيَتها (أيْ الكتب) قتيلًا، كان مِن أصحاب المُشاكلة والمُطابقة بين اللَّفظ والمعنى إذ جَعل اللَّفظ والمعنى في مقابل الجسد والروح؛ إذ إن "الأسماء في معنى الأبدان، والمعاني في معنى الأرواح، اللَّفظ للمعنى بدنٌ، والمعنى للفظ روح واعلم أنَّ النسبَ الفائقة إذا وقعتْ بَينَ هذه المعاني المتطالبة بأنفسِها على الصورةِ المختارةِ... كان ذلك من أحسن ما يقع فبين الهذر والخصر يطلُّ البيان". أما ابنُ رشيق القيرواني (ت 463هـ) فيُعَدُّ كتابُه "العمدة في محاسن الشعر وآدابه" ملخِّصًا لأهم الآراء النَّقدية السَّابقة التي أثارت هذه القضية؛ حيث يقول: "ثُمَّ للناس فيما بعد آراء ومذاهب منهم مَن يُؤثِر اللفظ على المعنى ويستشهد في ذلك ببشار بن برد في قوله:
إذا ما غَضِبْنَا غضبةً مُضريَّةً ... هَتَكْنَا حجابَ الشمسِ أَوْ قَطَرَتْ دَما
ومنهم مَن ذهب إلى سهولة اللفظ فعُنِي بها، واغتَفر له فيها الركاكة واللين المفرط كأبي العتاهية وعباس بن الأحنف ومَن تابعهما. وهم يَروْن الغايةَ في قول أبي العتاهية:
يا إخوتِي إنَّ الهوى قاتِلي ... فيسِّروا الأكفانَ مِن عاجلِ
ولا تَلوموا في أتباع الهوى ... فإنّي في شغلِ شاغلٍ
ومنهم مَن ظلَّ يُؤثر المعنى على اللفظ، فيطلب صحته، ولا يبالي حيث وقع من هجنةِ اللفظ وقبحِهِ وخشونتِهِ؛ كابنِ الرومي وأبي الطيب ومن شاكلهما، فهؤلاء مطبوعون؛ فشعر ابن الرومي يلذّ السمع به كقوله:
وغدا يُسَوِّي النبت بالقمَمِ ... من بين أخضرَ لابس كمَماً
ففي هذا المثال نجد الكمامة قد نالت بعدًا جماليًّا من شأنه أن يهدّئ من روع كارِهِي استعمالها. أما شعر المتنبي فيظلُّ ساريًا في الآفاق تتلذَّذه الخيل والبيداء وحتى أخو الجهالة في كمامته به ينعم.
وفي ظلِّ جدلِ اليوم بخصوص استعمال لفظ الكمامة، يُطرح السؤال: هل هناك مناسبةٌ بين اللَّفظ والمعنى تتحدَّد معياريًا لمعرفة الخطأ من الصواب أو تتحدَّد بإرادةٍ سلطويَّة لتحقيق المآرب؟ يذهب ابن جنّي إلى وجود مناسبةٍ طبيعيَّة بين اللَّفظ والمعنى أو الدَّال والمدلول بلغة دو سوسير فتجده يخصّص في كتابه القيّم الخصائص، الذي يعدُّ فاتحة الدراسات اللُّغوية، فصليْن للمبحث وهما: بابٌ في تصاقُب الألفاظ لتصاقِب المعاني، وبابٌ في إمساس أشباه الألفاظ أشباه المعاني. وكانت من استنتاجاته تَلاقي المعاني بأصوات الألفاظ أو المباني. أفنعثر في هذا الكشف عن قرابةٍ تجمع كمم وكتم أو كمّه في عرصات المعنى لكلمة "غَطَّى" تهدّئ المخطئ والمخطَّأ؟ هي رحلةٌ في المسألة للتنقيب على دلالاتٍ للكمامة عساها تسكت من يقول بأن هناك خطأ في الاستعمال وعدم مناسبة الكلمة للسياق، فتنسينا الجدل الدائر الذي يثير الصراع بين الحاكم بالمحكوم، أو عساها تحمل أسباب أُلفةٍ بين الفرقاء في ظلال لغة تنعم بمدٍّ لا نهاية له ولا تلقى منها عذرًا في إيجاد كلمة لأيّ شيءٍ.
أنا البحرُ في أحشائه الدرُّ كامنٌ ... فهل سألوا الغوَّاص عن صَدفاتي
وتستهوي إليها أفئدةً من الناس حتى من غير العرب، فهذه زيجريد هونكه تشيد بجمال العربية وسحرها قائلةً: "كيف يستطيع الإنسان أن يقاوم جمال هذه اللُّغة ومنطقها السليم وسحرها الفريد؟ فجيران العرب أنفسهم في البلدان التي فتحوها سقطوا صرعى تحت سحر تلك اللغة". فماذا في ذلك عن مطابقة الكمامة لمقتضى الحال في الإطلالة المعجمية:
1. الاستعمال العام للفظ الكمامة جاء في لسان العرب في مادة كمم كمَمْت الشيء: غَطَّيته، والكمة كل ظرف غطيت به الشيء فصار كالغلاف، ومن ذلك إكمام الزرع، وقال أبو حنيفة كَمَّ الكَبائس يَكُمُّها كَمّاً وكَمَّمَها جَعَلَهَا فِي أَغْطِية تُكِنُّها. كما أورد معجم اللغة العربية المعاصرة في مادة كمم تكمم الرجل وضع الكمامة على فمه وأنفه لتقيه الغازات ونحوها. من خلال هذه المعاجم نلفي أن في الاصطلاح العام فسحة لاستعمال كلمة الكمامة يضبطها السياق ولا يحتكرها الحيوان، بل يتَّسع مداه ليشمل هموم الإنسان المعنوية كما في قول العجاج:
بَل لَو شَهِدتَ الناسَ إِذ تكُمّوا ... بِقَدَرٍ حُمَّ لَهُم وَحُمّوا
2. الاستعمال الاصطلاحي: لقد كان للفظ الكمامة بوصفها من الألفاظ الاصطلاحية مساحة استعمالية خاصة أخرجتها من المعنى اللّغوي العام إلى معنى خاص، فالكمامة في لغة المصطلح المتداول في الأوساط العلمية والمهنية هي ظرف غطيت به الشيء وألبست إيَّاه فصار كالغلاف. وفي الاصطلاح الطبي الكمامة هي قطعة من قماش أو نحوه معدَّة أصلًا لأن يرتديها الممارسون الصّحيون في العمليات الجراحية أو خلال العناية بالمرضى لمنع انتقال العدوى والبكتيريا من المرضى. كما أن الفقهاء وجدوا ضرورة في توظيف لفظ الكمامة لأنها أوسع تغطية من اللثام، فأدخلوها في مصطلحاتهم لضبط فتاوى خاصة كحكم ارتداء الكمامة في الإحرام. فقبل زمن الكورونا بسنين هناك نصُّ فتوى لابن العثيمين يقول فيه: "الكمامة للمحرم للحاجة لا بأس بها، مثل أن يكون في الإنسان حساسية في أنفه فيحتاج للكمامة، أو يمر بدخان كثيف فيحتاج للكمامة، أو يمر برائحة فيحتاج للكمامة، فلا بأس" [مجموع فتاوى ابن عثيمين]؛ فهذا التخصيص الدلالي لا يعدُّ لحنًا بالرغم مما يقوله المناوئون الذين غالباً ما لا نحتاج إلى الحضرمي لتخطئتهم، فترى الذين يجيزون تخصيصاً فيه لحن بضرب من التخريج المتعسف مثل الأخصائي، ويصرفون الفعل الجامد كحبذا هم الذين يجدون غضاضة في توظيف الألفاظ التي لا يستسيغونها.
ولَنا من وراء هذه الشَّفاعة اللُّغوية أن نسأل: هل هناك تضمينٌ في الكمامة للسلطة يدٌ فيه؟ ترى بعض الطروحات أن مصطلح الكمامة في الخطاب الصحي المنجز لمواجهة الكورونا يحمل معانٍ سُلطويَّة، وأن تغييره لمصطلح اللّثام أفضل لارتباطه بالتاريخ والقيم لأن الكمامة في كتب اللغة هي ما يُجعَلُ على أَنف الحمار أَو البعير لئلاَّ يؤذيَه الذُّبابُ أو ما يكمّ به فم الحيوان منعًا له من العضّ أو الأكل". فهل السلطة في هذا التوصيف متَّهمة بفعلٍ مخلٍّ باللغة في تحديدها معنًى للَّفظ خارج جدلية التصاقب انبرت منه قوة/ إرادة لتصنع المعنى كما يرى نيتشه، أم ليس للسلطة يدٌ في ذلك سوى الانتقاء الضروري، فكانت الكمامة التي أخذ يعوّضها مصطلح القناع الواقي ذو التركيب الهجين الذي مالت إلى استعماله مؤخراً طائفة من الأنظمة اتّقاء الفتنة، ويمكن أن نضيف لهما كلمة اللثام أو اللفام هكذا بالإبدال التي نتحرَّى معناها من طريق حجة اللغة الأصمعي الذي ما يدّعي شيئاً من العلم، فيكون أحداً أعلم منه. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: "إذَا كَانَ النِّقَابُ عَلَى الْفَمِ، فَهُوَ اللِّفَامُ وَاللِّثَام". بخلاف الفراء الذي ميّز: "إِذا كان على الفم فهو اللِّثام، وإِذا كان على الأَنف فهو اللِّفام". ولا يخلو كذلك أن في اللثم أو اللفم إيحاءٌ، ثم إن الكلمة لم تتوافر لها ظروف التخصيص الدلالي المتداول في حين أن الكمامة قد بسَطت لغتها على ساحة الاستعمال الاصطلاحي.
وبعد كل ذلك، يبقى مصطلح الكمامة يتضمن دائماً دلالة الحيوان الجاثم الذي يُفسِد الصورة/ اللفظ والمعنى معًا، أو يتضمَّن داخل الماديَّة التاريخية ترسيخاً للعبودية؟ أم إن الشكَّ يفسّر للبراءة؟ يرى المُناوئون لاستعمال مصطلح الكمامة أن الكلمة غير مناسبةٍ لثقافة الأمة، فهي تثير اشمئزازًا يتناقض مع السياق الصِّحي الدَّاعي للنَّظافة والنَّقاء، وقالوا بأن الكمامة تقابل الكلمة الفرنسية muselière أو أختها الإنجليزية Muzzle، ومعناهما ما يُوضع على فم الحيوان لمنعه من العضّ أو الأكل. فالكمامة من هذه الزاوية لا تليق أن تكون من مؤثثات الإنسان حتى في زمن الوباء. وبالمقابل، فإنهم يجدون في كلمة اللثام/ اللفام أو الكلمة المركَّبة القناع الواقي ما فيه حُسن اللَّفظ ومناسبة المعنى، وما فيه إذن من الفصاحة. في الكلمة الفرنسية bavette )وأصلها ما يوضع عل صدر الطفل لئلَّا يلطّخ ثيابه (المستعلة حاليًا في الخطاب الصّحي أو bâillon التي هي قطعة خشب أو حديد توضع بين الأسنان لمنع الكلام أو الصراخ، أو حتى كلمة masque التي أصبحت لها حيّزاً من الاستعمال وهي ترادف الكلمة الإنجليزية Mask، وفي كلتيْهما يتردَّد إيحاءٌ بالتصنُّع والنّفاق وتراهم مقتنعين بفضل استقراء الفصاحة العربية بالمقارنة بغيرها للعثور في المصطلحات الفرنسية أو الأنجلو-أمريكية على تضميناتٍ تُثري مصطلحاتنا، ومعتقدين بأن الخطاب الصحي اليوم ينبغي أن يستفيد من تأثير المفاهيم الغربية، خاصَّةَ في تكييف النظرة إلى هذه الجائحة العالمية مثلما استفاد الخطاب العلمي والفلسفي بأدواتٍ معرفيَّة مكَّنته من تجسيد مقاربة لظاهرة الاصطلاح ومفاهيمها.
لكن هل في النظرة إلى المصطلحات الأجنبية ما يشفي الغليل ويوسع فصاحة التَّحسين ونحن نجد في معانيها شيئاً من القبح والإقذاع؟ ونجد أزمة الإيحاء والتعريض؟ فمنها ممَّا سلف ذكره ما فيه شبَهٌ بأطفالٍ صغار يلطّخون ملابسهم باللعاب أو بقايا طعام وأوساخٍ مختلفة؛ ومنها ما يوضع لتكميم الفم ومنعه من الكلام؛ ومنها ما يُبدي سلوك التَّظاهر والنفاق، وفي كل ذلك تجد الناس متقبِّلين فصاحة ما تمليه اللُّغة. إن في اختيار اللَّفظ عند العرب عادة، فقد تعرَّض ابن فارس (ت 385هـ) إلى مسألة تحسين اللَّفظ في كتابه الصَّاحبي فقال في معرض حديثه عن الكتابة: "إنه يُكنَى عن الشيء فيذكر بغير اسمه تحسينًا للفظٍ، وإكرامًا للمذكور. كما استعمل القدماء أيضاً مصطلحاتٍ أخرى، مثل: التَّعريض والتلطُّف والكِناية تجعلنا نسأل عن ظاهرة المعنى وحُسن اللَّفظ، فنقول هل كانت كلمة الكَمامة تحمل باستمرارٍ إيحاءات مَشوبة بنظرةِ الاحتقار أو كانت تتضمَّن في صوتها من التنافر ما يجعل استعمالها كريهاً كالهُعْخُع؛ وهو شجرٌ كريهٌ مرٌّ لا يُطاق طعمه، ليُعدل عنها إلى غيرها. والحقيقة أن للكمامة حضورًا في الاصطلاح، ولها أيضاً جانبٌ من السِّحر قد يفكّك الأغلال ويَحملنا نحو عبقاتٍ قد عثَر عليها شعراءٌ كابن سهل الأندلسي (ت 649ه) في قوله:
ما لَاحَ سرُّ الدَّهر قبلك إنَّما ... كان الزمانُ كمامةً لم تُفتقِ
وفوق كل ذلك؛ فإنَّا نقرأ قوله تعالى {إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ}، [فصلت، الآية: 47]. فنجد في الأكمام جمع كمامة جمالًا من الطَّبيعة يملأ النفس بهاءً وشَدوًا لُغويًّا يُصاحب العِباد في الخلواتِ.