العلاقة بين اللغة والطبيعة:
اكتشف العلماء واللغويون ارتباطًا مذهلاً بين التنوّع البيولوجي في العالم ولغاته. فالمناطق الغنية بالتنوع البيولوجي تميل أيضًا إلى أن تكون غنية بالتنوع اللغوي (تركيز عالٍ من اللغات). وفي حين لم يتم فهم هذا التزامن بشكل كامل بعد؛ فإن الارتباط الجغرافي القوي يشير إلى أن عوامل متعددة (بيئية واجتماعية وثقافية) تؤثّر على كلا الشكلين من التنوع، اللذين يتراجعان أيضًا بمعدلات مثيرة للقلق. وغالبًا ما تكون هذه المناطق ذات التنوع العالي في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ. وفي الأماكن التي تختفي فيها الأنواع النباتية والحيوانية، غالبًا ما تتبع اللغات واللهجات والتعبيرات الفريدة نمطًا مماثلًا من الانحدار.
إن المجتمعات الأصلية تربطها علاقات عميقة بالأرض التي سكنتها لأجيال، وتنعكس هذه العلاقة الوثيقة في اللغات التي تتحدثها -كيف تتحدث عن المناظر الطبيعية، وكيف تعبّر عن المعتقدات والعادات التي تطورت بها تلك اللغات. وعندما تعاني علاقاتها بالأرض؛ فإن لغاتها يمكن أن تعاني أيضاً.
وعندما لا يعود بوسع المجتمعات الاعتماد على الأرض، فقد تضطر إلى الهجرة إلى مناطق أخرى حيث لا يتحدث سكانها لغاتهم، فتترك وراءها ليس فقط لغتها الأم، بل وكل الحكمة التي تحتويها. وهناك أيضاً أدلة تشير إلى أنه في الحالات التي تبدأ فيها لغة ما في الانحدار -بسبب عوامل اقتصادية أو اجتماعية، على سبيل المثال- قد يتوقف الناس تدريجياً عن الاهتمام بالأرض. وعندما يتم التخلي عن اللغات، فإن المعرفة البيئية التقليدية التي تحملها تُترَك أيضاً وراءها.
وتشير المجتمعات الأصلية بشكل متزايد إلى الارتباط الوثيق بين اللغة والتنوع البيولوجي كدليل على أن البشر ليسوا منفصلين عن الطبيعة، بل هم جزء كبير منها.
رسم خريطة التنوع في العالم:
في أوائل تسعينيات القرن العشرين، وبينما كان دعاة الحفاظ على البيئة يحذرون من الانحدار المثير للقلق في التنوع البيولوجي، كانت عالمة اللغويات لويزا مافي تدرس فقدان لغات العالم، وخطر ببالها أن هذين الاتجاهين قد يكونان مترابطين: "هذه كلها أشكال من تنوع الحياة على الأرض. التنوع في الطبيعة، ولكن أيضًا تنوع الثقافات واللغات البشرية. إنها مترابطة. لذا فإن ما يحدث لأحدهما يؤثّر أيضًا على ما يحدث للآخر".
سرعان ما أدركت أنها لم تكن وحدها في التوصل إلى هذا الاستنتاج. في عام 1988، أعلن المؤتمر الدولي الأول لعلم الأحياء العرقي في بيليم بالبرازيل أن "هناك رابطًا لا ينفصم بين التنوع الثقافي والبيولوجي". ولكن بعد مؤتمر آخر في عام 1995 - حيث التقت مافي بديفيد هارمون، وهو أحد دعاة الحفاظ على البيئة الذي جمع بيانات حول "أزمة الانقراض المتقاربة" هذه- أسّس الاثنان منظمة Terralingua (تيرالينجوا). وفقًا لموقعها على الإنترنت، تركّز على" التنوع البيولوجي الثقافي"، وهو مصطلح روّجت له، والذي يعبّر عن كيفية "ارتباط التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي والتنوع اللغوي معًا".
كان من الصعب العثور على بيانات حول لغات العالم في ذلك الوقت. كانت إحدى قواعد البيانات الشاملة الوحيدة هي مجلة "إثنولوج" The Ethnologue، التي بدأت في تصنيف اللغات في عام 1951. تتغيّر اللغات بسرعة، ولا يتفق الجميع على أين تنتهي إحداها وتبدأ الأخرى. لذلك أنشأت تيرالينجوا مؤشّر التنوع اللغوي، والذي تعرفه بأنه "أول مقياس كمي على الإطلاق لاتجاهات التنوع اللغوي في العالم". وقد أظهر أنه بين عامي 1970 و2005، انخفض التنوع اللغوي العالمي بنحو 20٪، وكانت اللغات الأصلية هي الأكثر تضررًا. تكشف هذه البيانات المأخوذة جنبًا إلى جنب مع بيانات التنوع البيولوجي عن ملاحظة مذهلة. تعكس اتجاهات فقدان اللغة عن كثب الانخفاض في التنوع البيولوجي العالمي. وجد مؤشر الكوكب الحي التابع لصندوق الحياة البرية العالمي أنه في نفس الفترة الزمنية، تقلصت أنواع النباتات والحيوانات بمعدل 27٪.
استند مؤشر تيرالينجوا للتنوع اللغوي إلى عمل سابق أجراه هارمون وجوناثان لوه، وهو عالم متخصّص في التنوع البيولوجي والثقافي العالمي، والذي اقترح وجود صلات بين حالة التنوع اللغوي في العالم وحالة التنوع البيولوجي. في عام 2012، كشفت دراسة نُشرت في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)، أن المناطق الساخنة للتنوع البيولوجي والمناطق البرية ذات التنوع البيولوجي العالي هي موطن لـ 70٪ من لغات العالم. كما سلطت الضوء على أن العديد من هذه اللغات متوطنة في مناطقها ومعرضة للانقراض، وأشارت إلى الانحدار الموازي في التنوع اللغوي والبيولوجي العالمي.
يقول جورينفلو إن التنوع اللغوي يمكن اعتباره مؤشراً على التنوع الثقافي على نطاق أوسع، وهو التنوع الذي كان من الصعب تعريفه تقليدياً. ويضيف: "لفترة طويلة، كان يُنظر إلى الأنثروبولوجيا باعتبارها العلم الاجتماعي الذي يدرس الثقافة. ولكن لم يتمكن أحد من التوصل إلى اتفاق حول ماهية الثقافة. إن التنوع اللغوي هو في الواقع ما نستخدمه كوكيل للتنوع الثقافي".
إن الأسباب الدقيقة وراء الارتباط بين اللغات والطبيعة ليست واضحة تمامًا. فقد أشارت دراسات سابقة إلى أن المناطق ذات العدد الكبير من الموارد تخلق تنوعًا لغويًا لأن الناس يجب أن يتكيفوا مع بيئات أكثر تعقيدًا. لكن آخرين زعموا أن السبب في ذلك هو أن الموارد الأكثر وفرة تقلل من احتمالية الاضطرار إلى مشاركتها والتواصل مع المجموعات المجاورة في أوقات الحاجة. وفي الوقت نفسه، اقترحت بعض الأبحاث أن الأسباب وراء هذا التزامن أكثر تعقيدًا وتختلف من منطقة إلى أخرى.
اللغات والحكمة البيئية:
يقدّر علماء اللغويات أن هناك حوالي 8324 لغة في العالم، منها 7164 لغة لا تزال تُتحدث حتى اليوم وفقًا لمجلة "إثنولوج". ومع ذلك، فإن توزيع سكان العالم عبر هذه اللغات غير متساوٍ. يتحدث أكثر من نصف سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة واحدة من 25 لغة فقط. معظم اللغات المتبقية البالغ عددها 7139 لغة لا يتحدث بها سوى عدد قليل. حوالي نصف جميع اللغات تستخدمها مجتمعات يبلغ عدد سكانها 10000 شخص أو أقل، في حين أن مئات اللغات لا يتحدث بها سوى 10 أو أقل.
وفقًا لرئيس تحرير مجلة إثنولوج، جاري سيمونز، تموت لغة كل 40 يومًا تقريبًا. ووصف عالم اللغويات كينيث هيل فقدان لغة واحدة فقط بأنه يعادل "إلقاء قنبلة على متحف اللوفر" بسبب الثقافة، و"الثروة الفكرية" الموجودة في كل منها. ومن المتوقع أن يزداد معدل موت اللغات مع توقف الأطفال عن تعلمها وموت المتحدثين الأكبر سنًا. اختفت معظم اللغات دون أن تترك أثراً لأنها كانت شفهية حصريًا طوال معظم تاريخ البشرية. ومع ذلك، فإن هذه اللغات المهددة بالانقراض هي التي تكشف عن جمال التنوع البشري ومرونة العقل البشري. بعضها يتخصص في الحديث عن الطب العشبي أو علم الفلك أو الأعشاب البحرية.
اللغة كأداة استعمارية:
إن التركيز الملحوظ للغات في أكثر مناطق العالم تنوعاً بيولوجياً -وخاصة المناطق الاستوائية والمناطق القريبة من خط الاستواء- ربما يفسر جزئياً بالدور الوقائي الذي تلعبه هذه المناطق البرية ضد الاستعمار. تاريخياً، كان موت اللغة مدفوعاً في كثير من الأحيان بالاستعمار، وكما يزعم ألفريد كروسبي في كتابه "الإمبريالية البيئية"؛ فإن المستعمرين الأوروبيين كانوا يفضلون عموماً المناطق المعتدلة ذات الأراضي المسطحة الصالحة للزراعة، والتي كان من الأسهل استيطانها وزراعتها.
وعلى النقيض من ذلك، فرضت المناطق الاستوائية المزيد من التحديات، بما في ذلك الأمراض التي كان الأوروبيون أكثر عرضة لها لأنهم يفتقرون إلى المناعة. كما تميل المناطق المعزولة التي يصعب الوصول إليها إلى أن تكون أكثر تنوعًا. ويضيف جورينفلو: "الجبال والجزر هو المكان الذي تجد فيه الكثير من التنوع البيولوجي. وإذا كانت أماكن يصعب التحرك فيها، فستجد قدرًا لا بأس به من التنوع الثقافي أيضًا".
ولكن في المناطق التي استعمروها، أدرك الأوروبيون بسرعة أن اللغة كانت حاسمة لمهمتهم. وللهيمنة سياسياً واقتصادياً، حددت القوى الاستعمارية الحاجة إلى الهيمنة لغوياً أيضاً. وقد جادل الباحث الإسباني أنطونيو دي نيبريجا في قيمة كتابة القواعد والقواميس بالإسبانية القشتالية، وكتب في عام 1492: "كانت اللغة دائماً رفيقة الإمبراطورية".
من خلال القضاء على لغاتهم الأم، فصل المستعمرون السكان المحليين عن ثقافتهم وذاكرتهم وشعورهم بالهوية المجتمعية وعلاقتهم بالأرض، والتي انتُزِعَت منهم الآن أيضًا. كتب الروائي الكيني نغوجي وا ثيونغو: "اللغة، أي لغة، لها طابع مزدوج: فهي وسيلة للتواصل وناقلة للثقافة". كما منعوهم من نقل معرفتهم إلى الجيل التالي. "استعمار [للعقل]"، كما قال نغوجي في عبارته الشهيرة.
اليوم، غالباً ما يكون فقدان اللغة نتيجة لما قد يصفه العديد من الناس الذين يعيشون في المجتمعات الصناعية بـ"التقدم: الزواج المختلط، وتعليم اللغات الأكثر "شعبية" في المدارس والهجرة بحثاً عن فرص أفضل. قد يكون من الصعب الحفاظ على اللغات الأصلية بمجرد انغماس المتحدثين بها في حياة جديدة وعدم استخدام لغاتهم في السياقات المقصودة".
أهمية التعدد اللغوي:
وبدون جهود التنشيط، يقدر الأكاديميون أن فقدان اللغة قد يتضاعف ثلاث مرات خلال 40 عاماً، حيث يتوقع علماء اللغويات اختفاء 50 إلى 90% من لغات العالم بحلول نهاية هذا القرن، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على مجتمعات المتحدثين، والمجتمع العلمي، والتراث الإنساني.
إن اللغات، كما قال رالف والدو إيمرسون في كتابه "الشاعر"، هي "أرشيفات للتاريخ". وكتب عالم اللغويات نيكولاس إيفانز أن "اللغات لا تخبرنا فقط عن الإدراك البشري، بل وأيضاً عن النسيج الغني للتجارب الإنسانية على مدى آلاف السنين". وفي فقدانها فإننا نخاطر بفقدان ليس فقط جزءاً كبيراً من التاريخ البشري، بل وأيضاً القدرة على فهم طرق مختلفة لرؤية العالم والعيش فيه.
بالنسبة لجورينفلو، فإن العوامل التي تحرك التزامن بين التنوع اللغوي والبيولوجي، والتي كانت محيرة في البداية، أصبحت الآن أكثر وضوحًا: "أرى اللغات باعتبارها امتدادًا للنظام الثقافي، الذي يشكل في حد ذاته جزءًا من النظام البيئي الأوسع للعالم. لذا، فإن الأمر أصبح أقل غموضًا بالنسبة لي، وأكثر من مجرد استكشاف شكل هذا النظام البيئي".
إن الحفاظ على اللغات المهددة بالانقراض لا يقتصر على إنقاذ الكلمات فحسب، بل قد يكون أمراً حيوياً لحماية قرون من المعرفة الإنسانية وفهم الأنظمة التي تدعمنا.
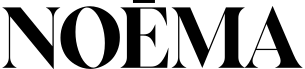
المصدر: مجلة Noema، يناير 2025.