بعد أن استعاد الشعر العربي عنفوانه ورواءه على يد الإحيائيين، استمرَّ في التطوُّر ليثمر حركةَ تكسيرِ البنية التي ثارت على بنية الشِّعر التقليدي، وتبنَّتْ فلسفة الرفض والتجاوز، منطلقةً من قناعة مفادها أن المضمون الجديد يحتاج شكلاً جديداً، وهكذا كسَّرت نظام الشَّطرين وعوَّضته بالأسطر والجمل الشعرية التي تطُول وتقصُر تبعاً لحجم الدّفقة الشُّعوريّة ودرجة امتدادها، وقد أسهمت عدة أسباب في بروزِ هذه الحركة منها: نكبةُ فلسطين التي نزعت من نفس العربيِّ كلّ تقديس للماضي، وزرعت فيها شكّاً تُجاهَ كل الثَّوابت، والتَّلاقُحُ الثَّقافيِّ مع الحضارة الغَرْبيَّة الذي جعل الشعراء ينفتحون على تجارب جديدة، وحمل عدَّة شعراءَ مِشْعَل هذه الحركةِ أبرزهم بدر شاكر السياب، وعبد الوهاب البيّاتي، وصلاح عبد الصبور، وكذا نازك الملائكة التي تعدُّ رائدةً هذا التيَّار الشِّعريِّ، وهي شاعرة عراقيَّة لها عدَّة دواوين أهمُّها "شظايا ورماد" الذي اقْتُطِفَت منه القصيدة موضوع التّحليل. فما موقفُ الشاعرة من الوجود؟ وإلى أيّ حدٍّ مثَّلت الخطابَ الشِّعريَّ الذي تنتمي إليه؟
جاءَ عنوان النَّصِّ جملةً فعليَّةً مصبوبة في قالب إنشائي أمريّ مفيد للالتماس "لنكن أصدقاء"، يظهر منه أن الخطاب موجه إلى جماعة، تلتمس منها المتكلمة الصداقة، ما يعني ضرورة أنّ واقع الحال تسوده العداوة.
انطلاقاً من دلالة العنوان وشكل النص القائم على نظام الأسطر المتفاوتة الطُّولِ، واتكاءً على بعض المشيرات النصية، من قبِيل "لنكن أصدقاء، في زوايا اللّيالي البِطاء، يمشي الدَّمار ويحيا الفناء، ستحس الحياة..."، نفترض أن القصيدة تنتمي إلى شعر التفعيلة، تدعُو من خلالها الشَّاعرة إلى نبذِ الحروب ونشر السلام من خلال الانخراط في عقد صداقة يشمل البشرية دون استثناء. فما الوسائل الفنيَّة التي استعانت بها الشاعرة لتمرير دعوتها؟
تشكّل القصيدة دعوة ملحَّة لعقد الصَّداقة بين مختلف أطياف البشريَّة التي تشترك في المصير الواحد، وقد بدأت الشاعرة دعوتها بتحديد أمكنة الصَّداقة التي تتلون بلون السواد ويشيع فيها الخراب، لتتنقل إلى وضْعِ اليد على أسباب عقد الصداقة ودواعيها المتمثلة أساساً في قساوة البشر، وتشير بعدَ ذلكَ إلى عاقبة المتسبِّبِين في مآسي البشرية، وتنْهي قصيدتها بتعداد المعنيين بالصداقة بنوع من التفصيل والاستقصاء لتبيّن أن الدعوة شاملة لا استثناء فيها.

حرصت الشاعرة على جِدَّة المضمون المطروق الذي استقته من الحياة، ما يعني أنها قلبت ظهر المِجَنِّ للأغراض الشِّعرية القديمة التي لم تعد تعبر عن نبض الواقع.
يؤثث عالمَ النَّصِّ حقلان دلاليَّان يتفاوتان طولاً وقصراً، وإفراداً وتركيباً، وانتشاراً وانحساراً، هما:
◆ الحقلُ الدَّال على الفوضى، وينضوي تحته من الألفاظ والعبارات ما يلي: "الوجود الكئيب، يمشي الدَّمار، صوت الزمان الكئيب، الأشقياء، المُتعبون...".
◆ الحقلُ الدَّال على السلام والصداقة، ومما ويندرج تحته نذكر: "لنكن أصدقاء، ستحسُّ الحياة، ستحس اختلاج الشعور...".
نلاحظ من جرْدنا لألفاظ وعبارات الحقلين هيمنةً مُطلقةً لحقل الفوضى، وذلك عائدٌ إلى أنّ عناية الشاعرة انصرفت إلى وصف ما يعرفه العالم من دَمار حتّى تُقنع البشرية بضرورة نبْذِ العنف وعقد الصداقة، والعلاقة بين الحقلين قائمة في الظاهر على التضاد وفي العمق على السببية؛ لأن حجم الخراب المنتشر كفيل بدفع البشرية إلى التفكير في إنهاء الحروب واختيار حل السلام.
اتَّسمت لغة القصيدة باللّين والبساطة مع تميزها بقدر من العمق والإيحائية، وبهذا استطاعت الشاعرة أن تخلص لطبيعة التجديد اللغوي الذي قطع الصلة بالألفاظ التقليدية الضخمة.
انزاحت القصيدة عن نظام الشطرين، وبنيت على الأسطر المتفاوتة التي تمتد وتنحسر تبعاً للدفقة الشعورية والنسق الفكري، ونُظمت على تفعيلة المتدارك "فاعِلُنْ" التي وُزّعت بشكل متفاوتٍ، وتجنباً لرتابة الإيقاع أحدثت الشاعرة بعض التغييرات في التفعيلة لتتناسب المعاني والألفاظ، وتحدث بعض التنويع الإيقاعي الموهم بتعدد التفعيلات.
أما القافية فقد جاءت تارة مركَّبة صوتياً وموحدة عضوياً، خاصة في المقاطع الثلاثة الأولى "قاء، ئيب، ناء= -00" وتارة متراوِحةً كما في المقطع الرابع "خاء، ماء، ياء- مأوى، جدوى- أسرى، أخرى"، وأثر هذا التنوع في الروي الذي جاء متعدداً "ء، ق، ي، ن"، ليفيد تغيّراً في المشاعر وتقلّباً في الأفكار، ونلاحظ من خلال رصْد مظاهر الإيقاع الخارجيِّ أن الشَّاعرة ثارت على نظام القصيدة القديمة وعوَّضته بنظام جديد، حيث استعانت بالتّفعيلة وعدّدت في القوافي والرَّويِّ، محاولةً الانفكاك من رِبْقَة الإيقاع القديم الذي يُعيق انطلاق المشاعر وانهْمارَ الأفكار وهي فكرة آمن بها دعاة الحداثة الشعرية.
وفيما يخص الإيقاع الداخلي، وظفت الشاعرة التَّكرار بأنواعه المختلفة، حيث نجد تَكرار الصوائت "السكون، الفتحة، الكسرة"، وتكرار الصوامت "الهمزة، النون، الكاف، السين، الراء"، إضافة إلى تكرار اللاّزمة "لنكن أصدقاء" التي عكست الإصرار والتأكيد والإلحاح على عقد الصداقة، ولا يخفى ما كان للتكرار من دور فاعل في إغناء الموسيقى الدَّاخلية من خلال خلق فسيفسائية صوتية ناطقة نابضة، أسهمت في إكساب القصيدة بعداً إيقاعياً سيماه التنوع والغنى.
وإلى جانب التَّكرار، نجد التوازي بشكل لافِتٍ، في قولها:
• في\ بلادِ\ الثُّلوج.
• في\ بحار\ الزُّنوج.
وكذلك في قولها:
• و\يصيحون\ في\ نبرةٍ\ ذابِلة.
• و\يموتون\في\ وحدة\ قاتِلة.
وهو توازٍ عموديّ\ مقطعيٌّ، نحويٌّ، عروضيّ، صرفيٌّ، تامٌّ أعطى للقصيدة جرْساً موسيقياً بديعاً أنقذها من رتابة السّرد، وانتشلها من جو الدّمار الملقي بظلاله القاتمة، وذلكَ من خلال ما منحها من حيويَّة إيقاعيّةٍ وحركيَّة نغميّةٍ داخليّة.
هكذا استطاعت الشّاعرة الانفكاك من رِبْقة النِّظام الموسيقي العتيدِ العنِيدِ، وأبدلتْه بنظام يتماشى مع الدّفقة الشّعورية والتجربة النفسية، ما يعْني أنها جَدّدت في الإيقاع ولم تسِر على طريقة الأقدمين، اللهمَّ حفاظها على التّفعيلة.
ونظراً للأهميّة التي تضْطلعُ بها الصُّورُ الشِّعريَّة في الارتقاء بالنَّصِّ في مدارج الشِّعريَّة وسلّم الجمال الفنّي، فقد حرصتِ الشاعرة على توظيفها بكثرة حتى تعبّر عن الواقع بشكل إيحائيٍّ تصويريٍّ جماليٍّ.
من هذه الصور قولها "يمشي الدمار" حيث أسندت فعل المشْيِ إلى الدّمار، مشبِّهة إياه بالكائن الحيِّ، ويُظهر هذا الانزياح مدى انتشار الدّمار وشموله لِكلّ مكان دون استثناء، ونجد صوراً أخرى من قبيل "هذا الوجود الكئيب، يحيا الفناء" إذ أسندت للوجود صفة الكآبة، وللفناءِ الحياةَ، وهو انزياح دلاليٌّ الغاية منه التشخيص وتبيان مقدار الخراب الذي عمّ العالم وشمِل الوجود، إلى درجة أن الموت حل مكان الحياة، والوجود شملته الكآبة وانقطعت فيه أسباب الفرح، وبنيت الانزياحات على التنافر المولد للدلالات والمعاني والأبعاد.
ومن الصور الدالة الناطقة بالأبعاد (يصيحون في نبرة ذابلة)، ففي ظل المعاناة والتعذيب فقد المطحونون طاقتهم الجسدية والنفسية، وصاروا مجرد أشباح أو ظلال بشر، ووصفُ النبرة بالذبول له رمزيته الموحية المحيلة على فقدان القدرة على النطق، فما بالك بالقدرة على الاحتجاج والثورة والمقاومة، وقد أحسنت الشاعرة عندما استدعت صفة الذبول من حقل النبات لتسندها للصوت، وفي ذلك ما فيه من ذكاء شعري وقّاد.
ومن الصور الدالة "ستحسُّ الحياة"؛ إذ أسندت صفة الإحساسِ إلى الحياة وهي للإنسان، ولعل غايتها تمني انقشاع سحابة الموت والحلم بسيادة السِّلم، واستتباب الأمن، وانتشار المحبّة بين البشرِ، الذين يجمعهم المصير المشترك.
وقد أضافت الشاعرة إلى هذه الانزياحات بعض الكنايات التي منحت المعاني بعداً رمزياً فتح إشعاعاتها الجمالية على عوالم التخييل اللامتناهية، وتتواشج هذه الصور لتصنع عالماً من الدهشة والتغريب، ولترسم مشهداً يشي بالكثير من الدلالات السياقية الثّرّة، كما في قولها:
فعيونُ القضاءْ
جامداتُ الحدقَ
ترمُق البشرَ المتعينْ
في دروبِ الأسى والأنينْ
تحتَ سوط الزَّمان النزقْ
لقد جعلت الشاعرة للقضاء عيوناً جامدة الحدق، تحيل كنائياً على القسوة وعدم الرحمة، ترمق البشر السائرين في دروب تأثثت بالأسى والأنين، ويمنحنا هذا التصوير فرصة تخيل المشهد الذي يتلون بالسواد، ويشع بالحزن وينطق بالألم، ويزداد المشهد رعباً وتأثيراً بوقوع البشر تحت بطش الزمان الطائش الذي يجد لذته في معاناتهم، ويحمل سوطه ليسومهم صنوف العذاب، والشاعرة إنما تقصد إلى تصوير عمق معاناة البشرية مع الحروب التي يفقد فيها الإنسان إنسانيته ويعمد إلى تعذيب أخيه والتلذّذ بمعاناته.
ولا يخفى ما أدّتهُ هذه الصُّور مجتمعة من وظيفة تعبيريَّة، إذ عبَّرت عن معاناة الشاعرة النَّفسية، ووظيفة إيحائيَّة تمثلت في تشخيص الدَّمار الذي تعيشه الإنسانية بغاية النفور منه، أما الوظيفة التزيينيَّة فتكمن أساساً في إضفاء الرَّونق والجمالية والرُّواء على النَّص الشعري والارتقاء به من التقريريَّة الباردة إلى الدرجات العُلى منَ النبض الشعري.
لم تعتمد الشاعرة على صور مستقاةٍ من الذاكرة الشعرية كما فعل الإحيائيون، أو على صورٍ نابعة من الذات كما هو عند الرومانسيِّين، بل انطلقت من الواقع والتجربة وصاغت عوالمها التخييلية معتمدة على الخرق والانزياح، وهنا مَكْمَن التَّجديدِ.
هيمن على القصيدة الخبر وانزوى الإنشاء إلى الظل، وهو ما يتماشى مع غاية القصيدة التي تمثلت في وصف ما ألمَّ بالبشريَّة من خراب، وتبيان حجم الدمار الذي خلَّفته الحروب، ومن نماذج الخبر "فعيون القضاء جامدات الحدق، ترمق البشر المتعبين..."، أمَّا الأسلوب الإنشائي فقد جاء محتَشماً متمثِّلاً في صِيغة الأمر المفيد للالتماس (لنكن أصدقاء) ويأتي تحديداً عند بداية كل مقطع، ويفيد انفعال الشَّاعرة وامتلاءَ نفسها، ورغبتَها الملحَّة في أن تَنْعَمَ البشريَّة بعيشٍ مُونِقٍ رغْدٍ، واستثمرت الشاعرة الأفعال على اختلاف زمنها لتبعث في أوصال القصيدة النبض والحيوية والدينامية، وكان تكرارها لضمير الجماعة (نا) إشارة إلى اشتراك البشرية في المصير الواحد، وهو أمر يحتم عليها الاتحاد.
تجاوزت الشاعرة المضامين الموروثة التي أخلص لها الإحيائيون، والمعاني الذاتية التي دار في فلكها الرومانسيون، وصارت تبحث عما يرتبط بالواقع وهمومه ونبضه، حيث دعت الجميع إلى الدُّخول في صداقة تتحقق معها أحلام البشريَّة في السَّلام، ساعيةً إلى إيصال رسالةٍ نبيلةٍ تتمثل في ضرورة نبْذِ الكراهية، ونسيان الحروب وتحقيق السَّلام أملاً في غدٍ أفضلَ ومستقبل وضِيٍء مشرقٍ، وللتَّعبير عن ذلك رصَدت جملةً من الأساليب الفنيَّة، حيث استخدمت لغة تتسم باللين والبساطة، وتمتاح من واقع التجربة الحياتيّة، وتخَّلت في المقابل عن الألفاظ الضَّخمة ذات الجرس العالي، ووظفت إيقاعاً شعرياً قائماً على نظام التفعيلة والأسطر، وصوراً شعريَّة تعبِّر عن الواقع وتنقلُه بشكل جماليٍّ موحٍ، كما اختارت الخبر الذي هيمن على الإنشاء لأن غايتها انصرفت إلى السرد والوصف.
✧ القصيدة المدروسة ✧
لنكُن أصدقاء
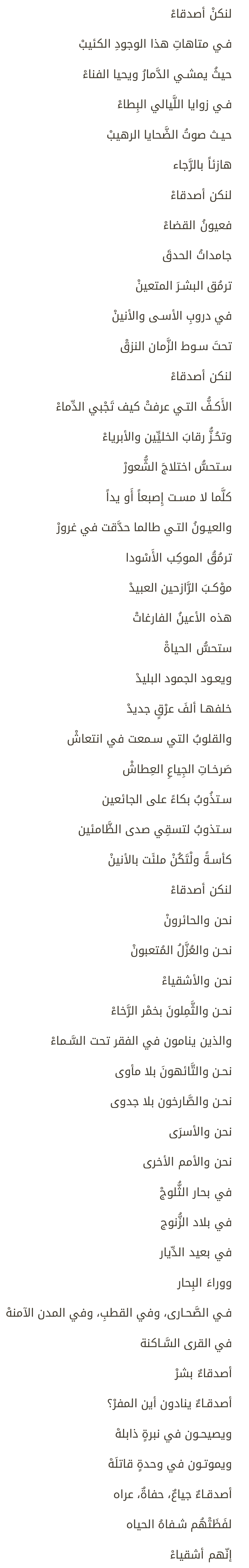
نازك الملائكة: شظايا ورماد. المجلد الثاني. دار العودة، بيروت. 1986. 143 وما بعدها بتصرف.