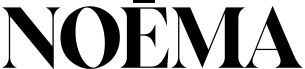عند قراءة أي عمل مكتوب، مثل الذي تقرأه الآن، من المنطقي أن تسأل من ألّفه، وبالتالي من له صلاحية التصديق على محتواه. ولحل هذه المشكلة، قد تحاول معرفة المزيد عن المؤلف؛ إذْ إنّ هويته قد تساعد في تحديد مدى صحة ما ورد في العمل. على سبيل المثال، بما أن سيرتي الذاتية تُشير إلى أنني أستاذ في دراسات الاتصال بجامعة أمريكية، فقد تفترض أنني مؤهل للكتابة عن الاضطراب الذي تُسببه نماذج اللغة الكبيرة (كما أقصد هنا) - بل وربما، أن ما أقوله جدير بالثقة إلى حد ما. ففي النهاية، لقد حددتَ هويّة المؤلّف وعرفتَ أنه يتمتع بمعرفة إلى حد ما في هذا الموضوع.
ولكن عند كتابة نص أو توليده باستخدام نموذج لغوي ضخم مثل ChatGPT أو Claude أو DeepSeek، تُصبح رؤية المؤلف صعبة. من الناحية التقنية، هناك خوارزمية كتبت النص، ولكن كان هناك إنسان قام بتحفيزها. فمن هو المؤلف إذن؟ هل هي الخوارزمية، أم الإنسان، أم مشروع مشترك بينهما؟ وما أهمية هذا الأمر أصلًا؟
منذ إطلاق ChatGPT عام 2022، كُرِّست الكثير من التعليقات للتحسّر على نهاية الكاتب البشري. فإما أن تتفوق النماذج اللغوية الكبيرة في الكتابة كليًا، أو أن البشر سيتنازلون لها عن الكثير من قدراتهم الإبداعية. وقد عبّر أحد الصحفيين عن أسفه العام الماضي قائلاً: "التقدم في هذه التقنية سيجعلنا بلا كلمات، بلا تفكير، بلا ذات". لكنه أكد أن الكتّاب ليسوا وحدهم المتأثرين. "إذا حلّ الذكاء الاصطناعي محل الكتابة البشرية، فماذا سيخسر البشر - القرّاء والكُتّاب على حد سواء-؟ تبدو المخاطر هائلة، وتقزّم أي موجة سابقة من الأتمتة".
لديّ رأي مختلف. قد تُشير النماذج اللغوية الكبيرة إلى نهاية عهد الكاتب، لكن هذه ليست خسارةً تُرثى لها. في الواقع، يُمكن لهذه الآلات أن تُحرّر: فهي تُحرّر الكُتّاب والقُرّاء على حدٍّ سواء من السيطرة والتأثير الاستبداديّين لما نُسمّيه "الكاتب".
إذا سألتَ أحدهم عن ماهية المؤلف، فسيجيب على الأرجح بأنه شخصٌ يكتب كتابًا أو نصًا آخر، وبالتالي فهو مسؤولٌ عمّا يقوله. قد يسرد أسماء أشخاصٍ نُعرّفهم على أنهم كذلك: ويليام شكسبير، جان جاك روسو، فرجينيا وولف، وربما حتى ديفيد غونكل. لكن هذا الفهم للمؤلف ليس حقيقةً عالميةً قائمةً منذ فجر التاريخ، بل هو مفهومٌ حديث. فـ"المؤلف" كما نعرفه الآن يعود إلى ماضٍ غير بعيد؛ له تاريخ.
في مقاله "موت المؤلف" الصادر عام 1967، عزا الناقد الأدبي الفرنسي رولان بارت جذور هذه الفكرة الشائعة إلى العصر الحديث في أوروبا، بدْءًا من منتصف القرن السادس عشر تقريبًا. قبل ذلك، كان الناس يكتبون النصوص، لكن فكرة إسناد المسؤولية والسلطة لشخص واحد لم تكن شائعة. في الواقع، انتشرت العديد من الأعمال الأدبية العظيمة والمؤثرة - الفولكلور والأساطير والكتب الدينية التي لا نزال نقرأها حتى اليوم - في الثقافة الإنسانية دون الحاجة إلى مؤلف أو إسنادها إليه.
مع ذلك، شهدت أوروبا في العصر الحديث تطورات فكرية وثقافية مترابطة، تمحورت حول ما أسماه ميشيل فوكو لاحقًا "لحظة مميزة من التفرد في تاريخ الأفكار". برفضه الخضوع للبابوية، ولّد الإصلاح البروتستانتي في القرن السادس عشر إيمانًا فرديًا. ثم في القرن التالي، بنى الفيلسوف رينيه ديكارت فلسفته العقلانية على مقولة "أنا أفكر، إذًا أنا موجود"، جاعلًا المعرفة كلها رهنًا بيقين الفكر الواعي. ورافق هذه الابتكارات مفهوم الملكية الشخصية كحق فردي، تضمنه الدولة وتحميه.
ينبثق مفهوم المؤلف، كما يوضح كلٌّ من بارت وفوكو، من تضافر هذه الابتكارات التاريخية المهمة. لكن هذا لا يعني أن المؤلف، بصفته مصدر السلطة الأدبية، ليس مجرد موضوع نظري، بل تطور أيضًا ليصبح مسألة قانونية عملية. في إنجلترا في القرن الثامن عشر ومستعمراتها المنفصلة في أمريكا الشمالية، أصبح المؤلف الطرف المسؤول في نوع جديد من قوانين الملكية: حقوق الطبع والنشر. وقد طُرحت فكرة كون المؤلف المالك الشرعي للعمل الأدبي لأول مرة في لندن، ليس انطلاقًا من تفانٍ مثالي لمفهوم النزاهة الفنية، بل استجابةً لثورة تكنولوجية سابقة سمحت بحرية تداول وانتشار الوثائق النصية: المطبعة.
كما يوضح سفين بيركيرتس في كتابه "مرثيات غوتنبرغ": "لم تترسّخ فكرة التأليف الفردي - أي أن يُنتج شخص واحد عملاً أصلياً ويحتفظ بملكيته التاريخية- في أذهان العامة إلا بعد أن حلّت الطباعة محل الشفهية كأساس للتواصل الثقافي". وبمجرد أن أصبحت النسخ الآلية من النصوص متاحة بسهولة، وأصبح من الممكن جني المال منها، أصبح من المهم تحديد هوية المؤلف- أو بالأحرى، تحديد هويته كمؤلف. وبالتالي، فإن الاسم الصحيح للمؤلف ليس بالغ الأهمية من حيث أصل النص وأهميته ونسبته فحسب، بل هو ضروري أيضاً للمعاملات التجارية وتحرير الشيكات.
كان لظهور ما نسميه الآن "المؤلف" عواقب مهمة عديدة على النظرية الأدبية الحديثة. وكما كتب بارت: "عندما يُكتشف المؤلف، يُفسَّر النص". لم تعد السلطة تُرى في مادة الكتابة - أي في الكلمات نفسها - بل في الأفكار الأصلية ونوايا وشخصية الشخص الذي كتبها.
لهذا السبب، أصبحت المهمة الأساسية للقارئ هي سبر أغوار النص، واكتشاف صوت المؤلف الكامن فيه، ثم فهم ما قصده منه أصلًا. وبناءً على هذه الصيغة، اتفق النّقاد والفلاسفة المعاصرون مع ديكارت على أن "قراءة الكتب الجيدة" تعني "التواصل مع أبرز رجال العصور الغابرة". (استخدام مصطلح "الرجال" الحصري في هذا السياق ليس أمرًا هينًا - فالمؤلّف، كغيره من الشخصيات البارزة في تلك الفترة، كان عادةً رجلًا أبيض البشرة).
هذا التصوّر للكتابة كوسيلة للتعبير أو التواصل له بُعد فكري عميق وقاعدة تاريخية راسخة. في نظرية أرسطو للعلامات ومعانيها، وُصفت الكلمة المكتوبة بأنها رمز للتجارب العقلية - بمعنى آخر، ما تكتبه يُمثل أو يُعبّر عما يدور في ذهنك. وقد توسّع نطاق هذا التصور في علم التواصل، الذي صاغه كلود شانون ووارن ويفر في منتصف القرن العشرين، حيث قدما لنا نموذجًا أحادي الاتجاه يُدرّس في كل دورة تمهيدية حول هذا الموضوع: المصدر، المُرسِل، القناة، المُستقبِل، الرسالة، الوجهة.
وهكذا، أو هكذا يُقال؛ فإن أفضل الكتابات هي تلك التي تتحدث بوضوح ومباشرة، بحيث يتمكن القارئ من الوصول إلى ما يدور في ذهن الكاتب وفهمه واستيعابه. ينبغي أن تكون الكتابة شفافةً تقريبًا، وتسمح بتدفق المعلومات دون عوائق من عقل الكاتب إلى عقل القارئ.
إذا كان المؤلف باعتباره الشخصية الرئيسية للسلطة الأدبية والمساءلة قد ظهر في وقت ومكان معينين، فمن الممكن أيضًا أن تكون هناك نقطة يتوقف عندها عن أداء هذا الدور. هذا ما أشار إليه بارت في مقالته الشهيرة الآن. "موت المؤلف" لا يعني نهاية حياة أي فرد معين أو حتى نهاية الكتابة البشرية، بل إنهاء وإغلاق المؤلف باعتباره الوكيل المفوّض لما يُقال في الكتابة ومن خلالها. وعلى الرغم من أن بارت لم يختبر النماذج اللغوية الكبيرة، إلا أن مقالته توقعت بدقة وضعنا الحالي. ينتج الحاصلون على النماذج اللغوية الكبيرة محتوى مكتوبًا مجرّداً من أي صوت حي لإحياء كلماتهم وتفويضها. النص الذي تنتجه النماذج اللغوية غير مرخص له حرفيًا - وهي نقطة أكدتها محكمة الاستئناف الأمريكية، التي أيدت مؤخرًا قرارًا ينكر تأليف الذكاء الاصطناعي.
غالبًا ما ينبع انتقاد أدوات مثل. ChatGPT من هذا. فقد وُصفت هذه الأدوات بـ"الببغاوات العشوائية" لطريقة تقليدها للكلام البشري أو تكرارها أنماط الكلمات دون فهم معناها. ومن الواضح أن الطرق التي تُزعزع بها الفهم السائد للتأليف والسلطة ووسيلة الكتابة ومعناها قد أزعجت الكثيرين. لكن قصة نشأة "المؤلف" تُظهر لنا أن النقاد يغفلون عن نقطة أساسية: لطالما كانت سلطة الكتابة حيلة اجتماعية. المؤلف ليس ظاهرة طبيعية، بل فكرة ابتكرناها لمساعدتنا على فهم الكتابة.
بعد "موت المؤلف"، ينقلب كل شيء رأسًا على عقب. تحديدًا، لا يُمكن ضمان معنى أي نصٍّ مكتوب مسبقًا من خلال الشخصية أو الصوت الحقيقي للشخص الذي يُقال إنه كاتبه. بل يتجلّى المعنى في تجربة القراءة ومنها. ومن خلال هذه العملية، يكتشف القرّاء (أو بالأحرى، "يختلقون") ما يفترضون أن المؤلف أراد قوله.
هذا الانقلاب في نظرية الأدب يُغيّر موقع صناعة المعنى بطرقٍ تقلب افتراضاتنا التشغيلية المعيارية. ففي السابق، كانت تقع على عاتق المؤلف الذي كان يُفترض أن لديه "شيئًا ليقوله"؛ أما الآن، فهي تقع على عاتق القارئ. عندما نقرأ "هاملت"، لا نستطيع الوصول إلى نوايا شكسبير الحقيقية من كتابته، لذا نجد المعنى من خلال تفسيرها (ثم نُسقط تفسيراتنا مرة أخرى على شكسبير). وفي سياق قيامنا بذلك، لا تخضع السلطة التي كانت مُمنوحة للمؤلف للتشكيك فحسب، بل تُقلب. كتب بارت: "يتكوّن النص من كتابات متعددة، مستمدة من ثقافات عديدة وتدخل في علاقات متبادلة من الحوار والمحاكاة الساخرة والتنازع، ولكن هناك مكان واحد، حيث تتركز هذه التعددية وهذا المكان هو القارئ... وحدة النص لا تكمن في أصله بل في غايته". بمعنى آخر، موت المؤلف هو ميلاد القارئ النقدي.
هذا التحوّل الجذري في موقع صياغة المعنى يُفسر أيضًا كيف يصبح محتوى النماذج اللغوية الكبيرة ذا معنى. يُصيب النقاد عندما يُشيرون، على سبيل المثال، إلى أن النماذج اللغوية تُنتج تسلسلات من الكلمات تبدو مفهومة، لكنها لا "تستوعب المعنى الكامن وراءها حقًا"؛ لأنها "لا تستطيع الوصول إلى مراجع واقعية مُجسّدة". لكن من المُتهوّر الاستنتاج بأن النماذج اللغوية تُنتج هراءً فحسب.
كتاباتها ذات معنى، ويمكن أن تكون كذلك. ما تعنيه هو شيء ينشأ من خلال عملية قراءتنا لها، ثم تفسيرها وتقييمها. لكن هذا ليس خاصًا بالنماذج اللغوية الكبيرة؛ بل كما أوضح بارت سابقًا، إنها سمة مميزة لجميع الكتابة - بما في ذلك هذه المقالة، لأنك أنت، القارئ، من كان عليه تحديد معناها. ببساطة، النماذج اللغوية الكبيرة تجعل كل هذا واضحًا ومفهومًا.
لكن هناك جانبٌ أكبر هنا. إن ظهور البرامج اللغوية الكبيرة في الذكاء الاصطناعي يُثير تساؤلاتٍ حول مفهوم المعنى نفسه. فعندما أكتب عبارة "نموذج اللغة الكبير"، يُفترض أن هذه الكلمات تُشير إلى شيءٍ حقيقيٍّ موجودٍ في العالم، مثل تطبيق ChatGPT. الكلمات لها معنى لأن شخصًا ما، مثل المؤلف، الذي نفترض أنه شخصٌ بشريٌّ مُتجسدٌ قادرٌ على الوصول إلى العالم الحقيقي، يستخدم الكلمات للإشارة إلى الأشياء والتعبير عنها. هذا، في النهاية، ما كان يقصده أرسطو عندما قال إن اللغة تتكوّن من علاماتٍ تُشير إلى الأشياء وتُحيل إليها. والمشكلة الكبرى في نماذج اللغة الكبيرة هي افتقارها إلى هذه القدرة: فهي تتلاعب بالكلمات دون معرفة (أو اكتراث) بما تُشير إليه.
لكن هذه النظرة البديهية لكيفية عمل اللغة قد واجهت تحديات مباشرة بسبب ابتكارات القرن العشرين في اللغويات البنيوية، التي تعتبر اللغة وتكوين المعنى مسألة اختلاف داخل اللغة نفسها. ولعلّ القاموس يُقدّم أفضل مثال على هذا المبدأ السيميائي الأساسي. ففي القاموس، تكتسب الكلمات معنىً من خلال علاقتها بكلمات أخرى. فعندما تبحث عن كلمة "شجرة"، لا تجد شجرة؛ بل كلمات أخرى - "نبات معمّر خشبي، عادةً ما يكون له ساق أو جذع واحد"، وهكذا.
لذا، لا تكتسب الكلمات معناها بمجرد الإشارة المباشرة إلى الأشياء؛ بل تشير إلى كلمات أخرى. هذا هو معنى (أو على الأقل أحد معاني) تلك المقولة الشهيرة المرتبطة بالمنظّر الفرنسي جاك دريدا، المعروف بصعوبة فهمه: "لا يوجد شيء خارج النص". وتنطبق هذه الحقيقة بشكل خاص على نماذج اللغة؛ إذْ لا يوجد، حرفيًا، شيء خارج النصوص التي تدربوا عليها والتي طُلب منهم إنتاجها. أما بالنسبة لنماذج اللغة، فالأمر يتعلّق بالكلمات من البداية إلى النهاية.
وبالتالي؛ فإن ما عُرض كنقد لتقنية نماذج اللغة -بأن هذه الخوارزميات تُوزّع كلمات مختلفة فقط دون الوصول إلى المُحيلات المُجسّدة في العالم الحقيقي- قد لا يكون الاتهام الذي يظنّه النقاد. فتقنيات النماذج اللغوية هي آلات بنيوية - إنها تحقيقات عملية للنظرية اللغوية البنيوية، حيث تكتسب الكلمات معنىً لا بالإشارة إلى الأشياء، بل بالإشارة إلى كلمات أخرى والرجوع إليها - وبالتالي تُعطّل الافتراضات التشغيلية المعيارية لعلم السيميائيات الكلاسيكي (الأرسطي).
يجب أن ننتقد ما تحمله البرامج اللغوية من وعود وما تحمله من مخاطر. ففي نهاية المطاف، تُعدّ هذه البرامج، وغيرها من أشكال الذكاء الاصطناعي المُولّد، تقنياتٍ فعّالة سيكون تأثيرها على العالم هائلاً. لم يتجاوز عمر منصة ChatGPT ثلاث سنوات، وتفخر بالفعل بنصف مليار مستخدم أسبوعيًا؛ بينما تُعدّ منصة DeepSeek من أسرع المنصات نموًا حول العالم. وسيتبعها المزيد بالتأكيد.
لكن في ردهم على الطرق التي تتحدى بها هذه الأنظمة كيفية وصول البشر إلى المعرفة وتفسيرها ونقلها، يميل اللغويون والفلاسفة وخبراء الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تأكيد مفاهيم التأليف والسلطة التي قُوِّضت منذ زمن طويل. والمشكلة ليست في أن هذه الطرق التقليدية للتفكير في الكتابة قد فشلت بطريقة ما في مواجهة الابتكارات الحديثة في مجال النماذج اللغوية. بل على العكس تمامًا. المشكلة هي أنها تعمل بكفاءة عالية، وتمارس تأثيرها وسلطتها على تفكيرنا كما لو كانت عادية وطبيعية لا تقبل الشك.
جزء كبير من سبب سوء فهمنا لأهمية هذه الآلات هو الطريقة التي يُفهم بها "الذكاء الاصطناعي". نظرًا لتركيزه الاسمي على "الذكاء"، تُفهم مخرجات الذكاء الاصطناعي إما على أنها تدل على الوجود الفعلي للفكر الذّكي، أو -في الحالات التي يبصق فيها الجهاز هراءً أو يهلوس- على عدم وجوده. لقد كان اعتبار توليد المحتوى المكتوب علامة أو عرضًا للذكاء هو تعريف الذكاء الاصطناعي منذ زمن لعبة التقليد لآلان تورينغ. ومع ذلك؛ فإن البرامج اللغوية تنتج محتوى نصيًا مفهومًا بدون ذكاء (أو دون أن نعرف على وجه اليقين ما إذا كان هناك ذكاء داخل الصندوق الأسود أم لا، وهو في الواقع أسوأ). وبذلك، فإنهم يزعزعون استقرار قواعد اللعبة.
كل هذا يُبرز أمرًا غُفِل في خضمّ الهياج المُثار حول الأهمية التكنولوجية للنماذج اللغوية الكبيرة: إنها ذات أهمية فلسفية. ما لدينا الآن هو أشياء تُكتب دون أن تُنطق، وتكاثر النصوص التي لا تملك، ولا تخضع، لسلطة مؤلفها، وتصريحات لا يُمكن ترسيخ صدقها أو ضمانها من خلال نية مُسبقة لقول شيء ما.
من منظورٍ ما -منظورٌ يبقى مُقيّدًا بأساليب التفكير المُعتادة- لا يُمكن اعتبار هذا إلا تهديدًا وأزمةً، إذ يُشكِّل تحديًا لفهمنا الحقيقي للكتابة، ولحالة الأدب، ولمعنى الحقيقة أو وسيلة قولها. ولكن من منظورٍ آخر، يُمثّل فرصةً للتفكير فيما يتجاوز حدود الميتافيزيقيا الغربية وهيمنتها.
لا تُهدّد النماذج اللغوية الكتابة، ولا شخصية الكاتب، ولا مفهوم الحقيقة. إنها تُهدد فقط فهمًا محدّدًا ومحدودًا لما تُمثله هذه الأفكار - فهمٌ ليس ظاهرةً طبيعيةً، بل نتاج ثقافةٍ وتراثٍ فلسفيٍّ مُحدّد. بدلًا من أن تُفهم (أو يُساء فهمها) على أنها علاماتٌ على نهاية العالم أو نهاية الكتابة، تكشف هذه النماذج عن الحدود النهائية لوظيفة الكاتب، وتُساهم في تفكيك مبادئها المُنظمة، وتُتيح فرصةً للتفكير والكتابة بشكلٍ مُختلف.
لكن لا تصدق كلامي. من أنا؟ ما الذي يُخولني فرض هذا النوع من السلطة على نص؟ كيف يمكنك التأكد من أن كل ما قرأته للتو هو نتاج مؤلف بشري، وليس نتاج نماذج أو هجين بين الإنسان والآلة؟
ليس لديك وسيلة للتأكد. وكل ما يمكن فعله لتبديد هذا الشك، كالإشارة إلى اسمي، أو سرد تفاصيل سيرتي الذاتية، أو حتى مطالبتي بإضافة بيان يؤكد أن كل ما قرأته للتو "محتوى بشري أصلي 100%"، سيكون في النهاية بلا جدوى. وسيكون ذلك أساسًا لأن النماذج اللغوية قادرة على إنتاج الشيء نفسه تمامًا. مهما كانت الضمانات، سيظل هناك دائمًا مجال للشك المعقول.
وهذه هي النقطة المهمّة. إن الصعوبة التي كان يُفترض أنها حكر على المحتوى المُنتج من خلال النماذج اللغوية -بأننا نكتب كلمات دون أن نعرف على وجه اليقين من أو ما الذي يُراد قوله من خلالها- هي بالفعل حالة مُحدّدة لجميع أشكال الكتابة، بما في ذلك هذه المقالة. إن شكل النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي يُعدّ أمراً مُقلقًا ومُزعزعًا، ولكن ليس لأنه انحراف أو استثناء عن هذه الحالة؛ بل إنه يكشف كيف كان دائمًا ضربًا من الخيال.
***
الكاتب ديفيد ج. غونكل: أستاذ رئيسي للأبحاث والمنح الدراسية والفنون في قسم الاتصالات بجامعة شمال إلينوي، وأستاذ مشارك في الأخلاقيات التطبيقية بجامعة لازارسكي في وارسو، بولندا. أحدث كتبه هو "الذكاء الاصطناعي التواصلي: مقدمة نقدية لنماذج اللغات الكبيرة" (2025).
المصدر ◂ مجلة Noemag عدد يونيو 2025