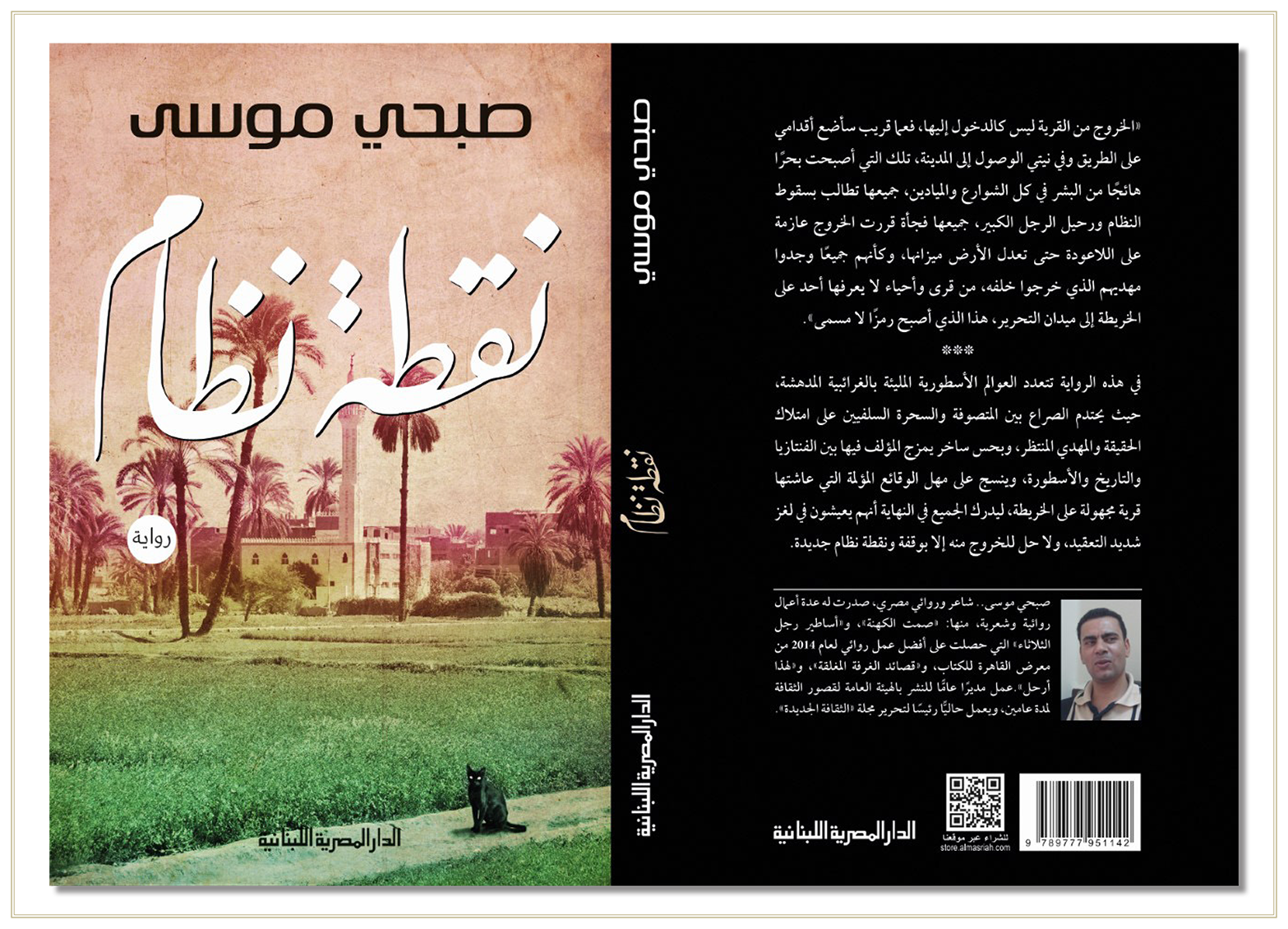
هي باختصار قصة محرر صحفي يعمل في القاهرة ـ تراوده فكرة كتابة رواية عن قريته وأهلها، لكنه يصاب بخيبة الأمل لأن ما يكتبه يختلف عما يريد كتابته، بما يمكن أن تسميه معاناة الكتابة الأولى لمثقف يسعى لإنجاز عمل إبداعي، وهي معاناة واقعية معروفة تشير إلى أن الكتابة مهما كانت شدّة واقعيتها إلاّ أنها تخييل قد يهتدي ببعض مجريات الواقع، فلإنجاز هكذا نصّ يحتاج إلى الدربة وامتلاك ناصية اللغة والموهبة فضلاً عن مهارات أخرى.
أما لماذا يرغب الإعلامي الشاب المسمّى محي الدين الكتابة عن قريته فهو يبرر ذلك في مستهل الرواية كسارد مهيمن يروي الأحداث بضمير المتكلّم: "كثيراً ما تمنيت الكتابة عن أهل قريتي التي لا يعرف أحد مكانها على الخريطة، وإذا ذكرت في أجهزة الإعلام فإن المذيعة تقرأها بشكل خاطئ، حاولت ذلك مرات ومرات، لكنني فوجئت في كل مرة أنني أكتب عن مكان غير الذي عشت فيه، واضطررت أن أساير الأحداث متواطئاً على خيانة الذين عشت بينهم، معتقداً لفترة طويلة أنني تخلصت من رغبتي الحمقاء في تمجيد أهلي، الذين ما زالوا يسكنون بين العشش وحواط الطوب اللبن". وبناء على هذا المجتزأ يدرك القارئ أنها رواية مكان حميم، حيث الأهل والذكريات الملتمسة وصفاً عاماً لها وللوضع الاجتماعي البسيط الذي لم تدخله المدنية بعد، لكن رغبته في تمجيد هؤلاء البسطاء ترتبط آلياً بتمجيد ذاته الكاتبة مستقبلاً، إن تحققت الرغبة، لاسيّما أن حكاية الشاعر جرير عن أبيه التي قرأها ذات مرّة ألهمته وظلّت تراوده، وإذا كان جرير أشعر العرب في حينه فلماذا لا يكون هو بدوره كاتباً مشهوراً من مشاهير الكتّاب العرب العجم! لكن الأمنيات شيء والموهبة وامتلاك المهارات السردية شيء آخر، ومن هنا فإن الروائي سوف يعمل على إقناع متلقّيه بأنه كاتب مبتدئ فعلاً بالركون إلى لغة الحياة اليومية، وبتفاصيلها المرتبطة بالواقع المعيش لشخصية محي الدين ما بين المدينة، حيث يقيم مع أسرته وبين مجتمعه الريفي المطلوب الكتابة عنه، فسافر إلى هناك لمواصلة مشروعه، والسفر في حقيقته إما أن يكون واقعياً، أو ذهنياً متخيّلاً، حيث يسافر القلب والعقل إلى هناك ويقيم، بما يفضي إلى استعادة بعض أحداث الطفولة حيث نشأ، والتطرق إلى جملة من الحكايات الفرعية التي جرت كشاهد عيان على مجرياتها.
وبهذا فإن مدخل الرواية سيكون بمثابة تمهيد لأحداث مقبلة لا علاقة للقرية وأهلها بها، لكنها تنفرض عليهم كشيء قدري، إذ بينما هم في حياتهم المعتادة يحدث انفجار ضخم يودي بقسم منها.
نقدياً يمكننا اعتبار هذه اللحظة كإطار مرجعيّ لجملة الأحداث التي ستحدث لهذه القرية الوادعة الآمنة البعيدة كلّ البعد عن تعقيدات السياسة والاشتباك الحاصل ما بين السلطة والمعارضة، المتمثلة بالإرهاب المسلّح وبأجهزة غامضة وعصابات تهريب الآثار قبيل ثورة يناير 2011، وهي أيضاً بمثابة تمهيد لها سوف يلحظه القارئ بالحضور الكثيف للأجهزة الأمنية، وحصار القرية بإقامة الحواجز والتفتيش ومختلف التفاصيل المعهودة في ممارسات الأجهزة الأمنية التي لم تجد، أو لم تفكّر بحلّ لهذه المشكلة السياسية المزمنة إلاّ بمواجهة العنف بعنف مضاد، يروّع السكّان أكثر مما يجفف منابع الفساد والإرهاب الممثلين رمزياً بأهل الليل، وما يفضي إليه من دلالات قابلة للقراءة على أكثر من وجه، والإسقاط السياسي المباشر، وفي المقابل سيكون هناك أهل النهار، وهم أهل القرية والطيبين، وما بينهما أهل الحي الذي دمر بالانفجار فاختفى واختفوا معه، وهذه الثنائية الجدلية تعكس ضراوة الصراع الخفي والمعلن الذي سيتنامى بالتدريج نظراً لأن سياسة أهل الليل تقوم من حيث الأساس على دفع السلطات لممارسة هذا السلوك العنيف؛ كي يستميلوا السكّان إلى جانبهم من جهة وإثارة الفوضى بمزيد من الظلام، وهذا ما سيتبين للقارئ من خلال الأخبار السريعة التي يوجزها المحرر الصحفي محي الدين، وكأننا أمام شاشة التلفاز":
وصارت نقطة الشرطة الصغيرة مركز ثقل العالم، فقد نزلت على أرضها الدبابات وزئير العسكر من كل صوب حتى شعر الأهالي أن كارثة أكبر من الانفجار ستحدث تحت وقع البيانات التي لا تؤمن إلا يوم الزلزلة، ولولا أن نقطة الشرطة تتوسط القرية بالضبط، لمالت الأرض من المجندين الذين قذفت بهم العربات." وفي هذه اللحظات المفعمة بالخوف والترقّب يعمل الكاتب الناشئ على متابعة هذا الحدث الجلل عبر العديد من المحطات السردية لإنجاز روايته التي بانت مقاصدها واضحة، وليبزغ السؤال المهمّ: كيف تمكّن الروائي من إنجاز الرواية كعمل فنيّ متخيّل؟ وما الأساليب والتقنيات التي لجأ إليها لإقناع قارئه بأدبية الرواية وليس حكايتها.
بنائية النصّ وخطابه
يمكننا الإشارة أوّلاً إلى أنّ بنية النصّ السردي تنهض على تقنية (رواية داخل رواية)، وهو أسلوب شاع مؤخّراً في أوساط الروائيين العرب، نذكر منهم إلياس خوري في روايته (يالو)، وحبيب عبد الرب سروري في روايته (حفيد سندباد)، وعبده وازن في روايته (البيت الأزرق) وسواهم كثير، وهذا يعني أن رواية (نقطة نظام) ذهبت في خطّين متوازيين ومتقابلين، أولهما مقدار معاناة الشخصية الرئيسة ودأبها لإنجاز المشروع، فتابعنا محي الدين يستفيض في إيراد الكثير من الحكايات المرتبطة بوعي أهل النهار البسيط والأقرب إلى السذاجة التي قد لا تشي بالغرض الأساسي للوهلة الأولى.
لكن الروائي الحاذق سوف يوظّفها في إطار بنية الصراع الجدلي الفلسفي، فيما لو أخذنا بعين الاعتبار مقولة صراع المتناقضات الهيغلية وقانونها الأساسي نفي النفي، فالمجتمعات لها منطقها الخاص في مسألة التطوّر أو التقدّم، وليس من السهولة أن تتخلى عما تتوارثه من قيم وثقافات ما لم تلتمس عياناً البديل، وهذه المرويات تتمحور حول رمزية المخلّص وما تفضي إليه من اعتقادات حول ذوي الكرامات وتداخل عالمي الأنس بالجنّ، ومن جانب ثان فإن التفاصيل الحياتية المرتبطة بمعاناة الكتابة جاءت لتعزز هذا النمط الأسلوبي الذي سوف يتكاثف حول العلاقة بينه وبين زوجته الصحافية بدورها، أو مع أصدقاء العمل والمقهى في ما تمت تسميته أو الاصطلاح عليه سابقاً بالواقعية السحرية حيث يتداخل الواقع مع الخيال، فيجتهد الروائي لإيهام قارئه بمدى اقتراب عالمه وشخصياته من عالم الواقع المعتاد والمألوف بمزيد من التناصات المستمدة من المرويات الشعبية المعبّرة عن الجوانب السوسيو ثقافية لمجتمع القرية والريف عموماً كحكاية إبراهيم الدرويش وشيخ الكتّاب، وأخرى مرتبطة بالحياة الأدبية والأدباء وسواهما، مع احتدام الأحداث ودخول شخصيات جديدة لتفعيل الحدث بمزيد من التشويق.
من جانب مغاير قدّم للقارئ إضاءات موسّعة عن نظام تفكير الشخصية المصرية وسيرورة الحياة الاجتماعية بالنسبة لفئة الطبقة الوسطى المثقفة الطامحة لتأكيد حضورها الاجتماعي، لكنّ جملة من العراقيل تقف بوجه طموحاتها كفئة مهمّشة تسعى القوى الغامضة لإقصائها على الدوام من المشهد السوسيوثقافي في الحدّ الأدنى، بالرغم من حضور هذه الفئة الفاعل في الحياة الثقافية والإدارية الحكومية، ولعلّ الوضع المادي أو "الموضعة" على تخوم الفقر تبقي هذه الطبقة تائهة وحائرة إلى أن تتخذ موقفها النهائي المعبّر عن يأسها الكلّي من النظام، وهو ما جرى واقعياً وفق ما اطلعنا عليه من روايات في العديد من البلدان العربية، بعيد انطلاقة شرارة "الربيع العربي" من تونس في العام 2011، إذ ساهمت التكنولوجيا الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي في الكشف عن جملة الممارسات القمعية والفساد المستشري إلى درجة الاستهانة بالشعب، ووصفه بعبارات لا تليق بكينونته الإنسانية.
ليدر سؤال جديد: لماذا في مصر بشكل خاص والبلدان العربية التي حدثت فيها انقلابات عسكرية بعامة جرى لها ما جرى؟ مصر التي كانت على تخوم النموذج الأوربي الراقي تنحدر فيها الحياة إلى هذا المستوى من الصراع الوجودي، ولعلّه سؤال الروائي الأساسي، بل السؤال الأهم بالنسبة لشعب يمتلك من الطاقات المؤهلة لذلك الرقي الذي كان، وهو ملتمس في كتابات الجيل السابق من الروائيين من مثل نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، يوسف القعيد وصنع الله إبراهيم وسواهم فضلاً عن جيل النهضويين الأوائل من مثل محمد حسين هيكل، وطه حسين وأحمد شوقي والعقاد وجماعة أبولو وغيرهم، وهل للشعبوية الجماهيرية دور في هذا الانحدار المتواصل قياساً بنهوض دول آسيوية لم تكن حتّى في حسبان المصريين فكيف بأوروبا؟ وما السبل الكفيلة للدفع بعجلة التطوّر من جديد: أهي الثورة الواعية الناضجة بقيادات تفكّر استراتيجياً بالمستقبل؟ أم أنها ثورة غايتها التغيير من أجل التغيير، إذ تختتم الرواية بمشهد في ساحة الحرية بعبارة "الشعب يريد إسقاط النظام".
ثانياً: التصوير البارع للقرية المحاصرة، تعزز بإجراء حوارات بين جيلي الشباب والشيوخ الذين علمتهم الأيام حكمة التعامل مع السلطات الحكومية، بينما انشغل الأطفال بأداء ألعاب ممسرحة لا تبتعد كثيراً عن رؤية الكبار ليستنتج القارئ حالة القلق العامة التي انتابت القرية باعتبارها باتت مركزاً لصراع أوشك على الانفجار، وهو في المحصلة تعبير عن الإحساس الشعوري الشعبي المرتبط بوجود ذاته، وفي مثل هذه الحال ستغدو القرية نموذجاً يمكن تعميمه فالقلق تعدّاها إلى القاهرة والعالم الذي فوجئ بكلّ هذه المتغيّرات الدراماتيكية في منطقة الشرق الأوسط برمّته وشمالي القارة الإفريقية فكان لا بدّ من التدخّل السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حجارة الدومينو المتهاوية ذاتياً بما يشير إلى الخلل الكبير في سيرورة النظام العالمي نفسه، ولعلّ هذا الخلل ارتبط بماض قريب مع احتدام الصراع ما بين المعسكرين إبّان الحرب الباردة، وبذلك يمكننا الإشارة إلى أن الخلل لا يمكن أن يكون في الشعب المصري المنتج للخيرات والحضارات بمقدار ما يشير إلى مشيئات القوى الكبرى المتصارعة على النفوذ، وإلاّ كيف حققت ثورات دول أوروبا الشرقية غاياتها المنشودة بمجرد انهيار الاتحاد السوفييتي، وهو سؤال مشروع لا بدّ من الإجابة عنه